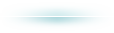رجلٌ يختصر المجتمع
كالسور شامخاً يحتضن الجميع في سماء علياء تلك العظمة التي وهبها الله له، والتي لا تنفك عنه لسعة قلبه النوراني الكبير. ورغم تلك العظمة، إلا أنه لم يكن لينفك بتواضعه الجم أيضاً عن أن يهوي من سماء شموخه العالية تلك، ليكون واحداً منا مندكاً بتواضع في كيان الجميع، فقيراً باكياً متضرعاً أمام رب المساكين. كان واحداً منا لكنه كان أيضاً فوق ذلك كله أمةً، كما (كان إبراهيمُ أمة). هكذا كان شيخنا الجليل العزيز والموقر والمحترم والمبجل الشيخ/ علي بن منصور المرهون (رح) ... أمةٌ في رجلٍ، أو رجلاً يختصر الجميع.
ولن أبالغ هنا، ولن أنافق ولن أجامل ولن أدجل ولن أخدع نفسي أو الآخرين، من أجل مشاعري أو مشاعرهم، بكلماتٍ منمقةٍ تخدع الجميع، تخرج في وقتٍ عاطفيٍ حرجٍ كهذا، الذي تنزف فيه الجراح، ويُزف فيه الرجل جثةً هامدةً إلى مثواه الأخير، وسط فقد ولوعة وحسرة محبيه. فقد كان الرجل حقاً وصدقاً، أب الجميع وملك قلوبهم وجامع الرايات وموحد الأبدان والشعارات ومطهر الأرض من دنس تمزقنا الفئوي المقيت الذي كان يطل برأسه بين الفينة والأخرى علينا، ليعرف عنه ذلك كل من رآه أو حظي بشرف القرب منه ومعاشرته خصوصاً في محيطه الإجتماعي في مدينته مدينة القطيف وفي القرى التي تقبع في ذلك الجوار. لا بشهادةٍ على ذلك من قلبي المغرم وحده الضعيف أمام عظمة ذلك الحب الكبير الذي كان يحمله الشيخ للجميع والذي عرفته به منذ الصبا وريعان الشباب، ولا فقط بسبب عشقي لطلته البهية وأشعة وجهه النورانية الربانية، التي أحرجت أشعت الشمس في ذروة شموخها والقمر أيضاً في أوج بهاء ضيائه في الليالي المقمرة ... فحسب ... بل أيضاً وقبل ذلك كله بشهادة الآلاف من المحبين والمعجبين، ممن عرفوه فاحتفوا به، في أيام حياته بقمة الخشوع والتواضع بين يديه، وحين زف إلى مثواه الأخير (رحمه الله) بتشييعٍ مهيبٍ له بعيد ساعات الوفاة ... تجلت فيه عظمة الالتفاف حوله والنفرة إليه والبكاء بلوعة وحسرة عليه.
هذه الشخصية الجامعة التي عرفتموها ساعات الوفاة على حقيقتها التي ربما لم تكن ظاهرة أو بادية للبعض منكم من قبل، لم تولد هكذا جزافاً، ولم تنبثق من فراغ، وإنما كانت إنجازاً حق لصاحبه - فضيلة الشيخ - أن يفخر به. وإن كان يمكن - من جهة أخرى - من باب الإنصاف والعدل أن يعد للآخرين فضلٌ في إبراز تلك الشخصية الجامعة للآخرين والتعريف بها وترميزها ورفعها شعاراً للوحدة المجتمعية والسماحة الخلقية والسلوكية، في حراكٍ وفعلٍ لا ينبيء إلا عن الفاعلية والذكاء من قبل بعض أبناء هذه المنطقة العزيزة (القطيف الحبيبة) ... فالحق والحقيقة التي يجب أن لا تغيب عنا مهما كانت الأسباب، هي أنه هو حقاً بكل فعاله الخيرة والطيبة والنبيلة، من قد أوقد الشمعة الأولى، فوهب للآخرين تلك الفرصة النيرة الخيرة - التي نقدر للآخرين استثمارها -، لرفع وإعلاء ذلك الشعار، وإحياء تلك الروح وبثها للآخرين لتكون لهم ضياءً في هذه الحياة.
ولقد عشنا في فترات مضت وأزمنة خلت، أجواء فاعلية وروحانية وتواضع وسماحة ذلك الرجل العظيم، فلم نجد له حين تحلقنا حوله عند منبره أو في مسجده، ولا عند أفولنا من حوله إلى أوكار منازلنا المتواضعة، التي كانت تحف بمقار حركته وسكونه، أية كلمة نابية، تنبئ عن ضغينة تسكن في قلبه لأي أحد، أو أحقاد ومناكفات له تجاه أي أحدٍ، يمكن أن نتلمس وجودها، وأن نتوقع أو نتلمس من خلالها له رغبة في أن تفشوا فينا وتتغلغل في أوساطنا كما تفشوا فيه وتتغلغل في بواطنه الغامضة ... ولا تستغرب ذلك عنه أو منه، لأن الرجل وكما عرفناه بصدقٍ لم يكن حقاً يرى من حوله أحداً يستحق التفاتته واهتمامه ليجير سلوكه لخدمته، أو ليتفاعل أو لينفعل أمامه ... إلا الله سبحانه.
ولا أريد أن ألج هنا باباً من أبواب الغلو فيه، بأن أزعم أن كل من سكن القطيف أو جاورها أو دب فوق ترابها أو ارتشف من مائها، قد كان عارفاً به ومغرماً بحبه، غير جاهلٍ له، أو قد عاش ما عشناه أو عرف ما عرفناه أو انطبع في قلبه كل ذلك الإحساس والشعور العرفاني الجميل الذي يعتمل في صدورنا تجاهه حتى الآن في هذه الساعات الخاصة وما أحسسناه ونحسه له ... فحتى الشمس الساطعة في رابعة النهار لا يمكنها مهما فعلت أن تحضر في كل مكان وأن توجد في كل آن أو أن تفعل أكثر من أن تنشر ضياءها في بعض أرجاء هذا الكون المحدودة وأن تصل لبعض حدوده الضيقة ... فكيف يمكن لبشرٍ تحيط به كل حدود جسده الإنساني الصغير ذاك إلا أن يكون واحداً من بني الإنسان تحده حدودهم وحدود الزمان والمكان والإمكان؟؟؟!!!.
لكن الشيخ الجليل رغم ذلك كله، تجاوز حدود الجسد، فكان أمة عظيمة تجسدت في شخص رجلٍ واحدٍ عظيمٍ يختصر المجتمع، أو بصيغة أخرى، في كيانٍ بسيطٍ سلسٍ وسهل لرجلٍ بشريٍ واحدٍ مفردٍ يمكن إدراكه بيسر. كل ذلك لأنه أحب الله وأخلص له وأحب الناس وأخلص لهم ... فأحبوه ... واحتضنوه ... وقدروه ... وأخلصوا له ... حتى حفت به الآلاف من الرجال والنساء وربما الملائكة ... تزفه إلى قبره ... شاهدة له بذلك الإخلاص والحب العظيم لله ولهم ... تودعه وترثيه وتبكيه وتشيعه ... وتشهد له بين يدي الله وبين يدي الناس ... وعلى مسمعٍ ومرأى من الجميع بالفعل العظيم ... وترفع له آيات الثناء.
ولقد شهدت الشيخ حين شهدته، في ريعان شبابي ومقتبل العمر، في وقتٍ كنت فيه في أمس الحاجة حينها كغيري ممن كان في مثل عمري، لنبراسٍ يرفع ليحتدا به، ومصباحٍ يضيء ليستضاء بنوره وهديه، فارساً يقارع الليل المظلم وجنوده، يغلب ساعات الفجر الأولى التي كانت تتغلب بقوة على قوى كثيرٍ من الناس، في صيفهم وفي الشتاء، حين تزدحم صفوف الصلاة خلفه في أوقات الصيف، وحين كان يهجره الكثيرون ممن يأمون مسجده للصلاة في المسجد خلفه ساعات الفجر عندما كان يشتد وقع برد الشتاء على أجسادهم الضعيفة، خصوصاً في مثل تلك الساعات التي تشتد فيها أيضاً وطأة النوم. وعلاوة على ذلك فقد كانت فروسية ذلك الفارس وكان نضاله مستمراً كذلك أيضاً في بقية ساعات اليوم، حين كان يطارد ويطرد الكسل والملل والإهمال والإعياء والاسترخاء من حوله دون هوادة مهما كانت الظروف ومهما كان الوقت والزمان ... ليقيم الصلاة، فيوقد في العتمة شعلة الضياء، وفي الصبح بسمة الحب والأمل والأمان.
فكانت تلك الحكاية الملكوتية التي تبدو رائعة من روائع الكذب والرومانسية والخيال ... قصة حقيقية واقعية ... لفارسٍ من بني الأرض ... يعشق قريته ومدينته ... يعشق ناسه وأهله ... يعشق قبلته وصلاته وكعبته ... ويهيم في محراب العبادة ... وقد شغله هم آخرته عن الاهتمام بهوامش دنيا الناس المدنسة الممزقة ... كما شغله ذلك أيضاً عن افتعال أو إشعال أو الانشغال بالمشاكل والخلافات القذرة مع الآخرين من حوله من أجل المصالح الوقتية الخاصة والمحدودة ... فنجى بنفسه وبكثيرٍ ممن حوله من نار تلك الفتن المحرقة والأمراض المهلكة ... أو لا أقلاً من كثيرٍ من بوائقها ... وأركبهم سفينة المحبة والطمأنينة والنجاة.
لذا، فيمكننا القول هنا، أنه ليس المهم عندنا هنا في هذا المقام، كيف كان الرجل في عظمة علمه ومعارفه؟ ولا كم كان يحمل في دماغه من مفردات الفلسفه أو المنطق أو الثقافة أو خلافها ... الخ؟ ولا كم كان قياس ذلك العلم أو تلك المعرفة والثقافة التي توافرت عنده في عصره؟ ولا كم يمكن أن يكون قياسها في غير ذلك من العصور ... الخ؟، بل المهم عندنا هنا هو ذلك (الإنجاز) العظيم الذي أنجزه وحقيقته، أو ذلك الرداء الكبير من العطف والحب والحنان الذي نشره ذلك (الشيخ الجليل) فغطى به جميع من عرفوه وتحلقوا من حوله، وذلك الضياء من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة، التي كانت تشع في يديه ليشير بها ناحية الخير، فيلهم بها الآخرين سلوك طريق الحب والحنان والتعاون والألفة والعفة والتواضع والصلاح.
فذلك الخير العظيم كله، الذي أنجزه الشيخ الفاضل بيديه الكريمتين، لا يتأتى إنجازه لأي أحدٍ كان، خصوصاً في عالمٍ كهذا الذي نعرفه اليوم، والذي تتفشى فيه مختلف صنوف الرذائل والمنكرات وأنواعها، ويتكالب فيه الناس في النزاع على المصالح الفردية المحدودة، لتبدو النوايا السيئة ولو من وراء حجاب، لكنه ورغم ذلك كله، فقد لان له ذلك الهدف وأتى إليه طائعاً، لتوحد به صفوف مجتمعه وكيانات الناس من حوله ولتصنع به الوحدة ... فأصبح الشيخ أمةً ... وغدا شعاراً وعنواناً جامعاً لكل تلك الأمة التي أصغت إليه.
نعم، لقد فعلها الشيخ حقاً، فوحد الكلمة، حين كان يمكن أن يأتي من يمزقها ويفتتها، وفعلها الشيخ حقاً، فنشر الحب حين كان يمكن أن يأتي من ينشر البغضاء والكراهية، وفعلها حقاً، فنشر العفاف حين كان يمكن أن يأتي من ينشر الرذيلة والفساد ويمزق الأخلاق ... وحوله تحلقنا حينها في الصلاة والدعاء والمناسبات، مستضيئين بنور قلبه ومنتمين لحبه ونور أخلاقه ... متجاهلين تنوعاتنا الثقافية والفئوية والمناطقية ... فذابت على يديه الكثرات وانصهر الكل في الوحدة والواحد القهار.
وقد مضى (رح) لحال سبيله، وفضله وخيره فينا لا يزال له البقاء، ولولا ذلك الفضل والخير، لربما كان كثيرون منا حتى اليوم، لا يعرفون سوى الشقاق والنفاق وجحيم الفرقة وفساد الأخلاق وشتات الآراء والتناحر ... فرحمه الله ... على ما قدم ... لنا وللجميع.
فيا أيها الرجل العظيم، شيخ قريتنا الكريم، يا أبا الفضل يا أبا الفرجٍ، نم قرير العين مطمئناً هانئاً، يحرسك في مهدك الأخير، كل ما قدمت من العطاء والنقاء.
وأنتم يا من رفعتموه شعاراً، فسميتموه (رجل السماحة)، لتضيئوا به دروب الحياة المظلمة للآخرين، سيروا في دروب الخير الباقية لكم، ليالي وأياماً آمنين سعداء أيضاً مطمئنين تحرسكم رايات السماحة والنبل والطهر والنقاء التي تعلون من شأنها وتعملون لها.
وكلمة أخيرة، أوجهها هنا لمن قد يعاتبنا على هذا القدر من الحب والثناء والإطراء الذي أبديناه ... والذي تحمله قلوبنا للشيخ المبجل عرفاناً وشكراً له دون سواه ... رغم وفرة العلماء والخطباء والفضلاء الأجلاء ... فمهلاً ... أيها الأحبة ... فلا تطلبوا منا (عالماً بلا عمل) لا يضاهيه أحدٌ من العلماء في العلم والمعرفة، وهو في العطاء وتوحيد الصف لا شيء ... إن لم يكن في التفرقة والفرقة والشقاق والنفاق هو كل شيء ... فالعلماء لا يقاسون هكذا فقط بكم العلم في رؤوسهم أو الثرثرة المتوافرة على ألسنتهم ... فحسب ... بل أيضاً يقاسون بما يقدمونه لهذا العالم من هدى ونور وعطاء ... أو بما يسلبونه منه من ذلك ... فهنا قد لا يكون علمهم ذاك الذي نبهر به ... في الأخير ... سوى نفاقٌ وشقاقٌ ووبالٌ وشقاءٌ ... لهم وعليهم ... ولبقية الناس وعليهم.
وهكذا من هذا المنطلق، فقد حق لنا بوعي، لا بسذاجة الأرياف والقرى الفقيرة الأمية والبائسة، أن نبجل الشيخ ونعظمه، فقد كان الشيخ/ علي المرهون (رح)، عنوان حب وسماحة وتسامح وعفة ورفعة وتواضع وعطاء، لأنه كان شيخاً مقدراً يجمِّع الكلمة ولا يشتت الوحدة.
فهل في ذلك من شك؟؟؟!!!.
فتلك إذاً - فيما مضى -، كلمة عرفان منا قدمناها هنا بين أيديكم، حملها القلب قبل القلم، للراحل الفقيد (رح) ... وشاء الله أن نطلقها وأن نجهر بها هنا ... والكلمة الأخرى التي نود هنا أن لا نختم إلا بأن نعرج عليها في نهاية هذا المقال، فنوجهها لكامل المجتمع الذي عاش فيه فضيلة الشيخ (رح)، وهي أن: "تعالوا جميعاً نتعلم الدرس ... درس التجمع والوحدة والحب وعدم التفرق ... الذي تعلمناه من سماحة الشيخ ... تعالوا نختصر المجتمع ... كما تعلمنا منه (رح) ... في رجلٍ واحدٍ منا ... يبرز قوتنا وكفاءتنا ... ويعزز مكانتنا ووحدتنا ... ليكون الرجل حينها أمةً ... بإخلاصه للأمة ... وتكون الأمة بكاملها وبكل تنوعها مختصرةً في رجلٍ ... بتفانيها فيمن أخلص لها ... فنقارع بذلك الرجل الموحد الخطوب العظيمة ... ونسدد به الضربات القوية للجهل والفرقة والتخلف ... ونسند به قضايانا المهمة ... ونهبه قوتنا ... ليكون سلاحنا في الملمات كافة" ... وكفى ... والسلام ... ودمتم بألف خيرٍ وحبٍ وصفاء وسلام.