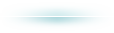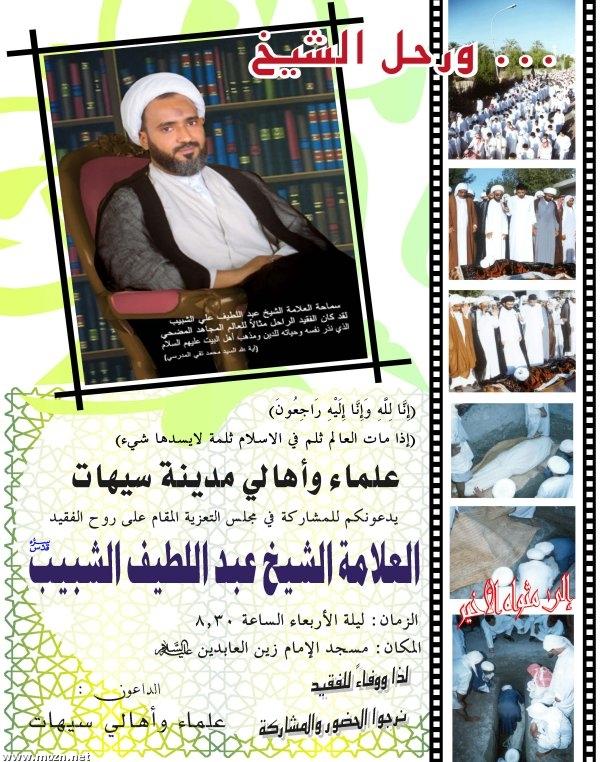سيهات : «في الدين حياتنا »

القى سماحة الشيخ صادق أحمد الرواغة «حفظه الله» يوم الجمعة بتاريخ 27 جمادى الأولى 1426هـ ا في مسجد العباس بمدينة سيهات كلمة بعنوان «في الدين حياتنا »
بمدينة سيهات كلمة بعنوان «في الدين حياتنا »
قال تعالى:﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾
ليس هناك أوضح معنى من الحياة والموت ولا أبرز ظهورا منهما، فلا يحتاجان لكثير توضيح وبيان لظهور المعنى المراد منهما الدالان على حياة الإنسان في الدنيا، والموت بانتقاله منها إلى قبره.
والقرآن الكريم في أكثر من آية قد استخدمهما بالمعنى المعنوي لهما للدلالة على أن الحياة الحقيقية هي بالإيمان وتفاعل الإنسان مع قيم السماء وتعاليم الدين، والموت دلالة على بقاءه على كفره أو عدم تفعيل تلك القيم في واقعه، وإصراره على جهله حتى بأبسط أمور دينه، فلا يكلّف نفسه القراءة والمطالعة ولا تزويد نفسه بالمعرفة، مكتفياً بما لديه من معرفة سطحية عقيمة، وكأن ما يعرفه من معارف هي لبُّ الدين وجوهره.
إن العلم والمعرفة ضروريان لبث روح الحياة في الأفراد والمجتمعات على حدٍّ سواء، إلا أن بقاء ذلك في الزاوية النظرية المجردة هي مشكلة من المشاكل المزمنة التي عصفت وتعصف بنا كمسلمين.
وما التخلف الذي ضرب أوتاده في واقعنا إلا نتيجة للجهل وفقدان المعرفة، أو لتواجد ثقافة سلبية قد اعتمدت الموروث الأسري والاجتماعي في النظر للأحداث وتفسيرها، أو للتباين الواقع بين المعارف والقيم السماوية وبين السلوك العام للأفراد والمجتمعات.
إن الفرد والمجتمع يستمد قيمته وحياته من مصادر ثقافته الأصيلة، فإذا انقطع ذلك المصدر أو لُوّثَ أو فُسّرَ لكي يوافق الأهواء والمصالح، أو أُقصيَ ومُنع من أن يأخذ دوره الحقيقي في الساحة، فإن الموت سوف يكون السمة البارزة حينئذٍ.
إن الموت الحقيقي يكمن في عدم تفعيل الدين وقيمه ومفاهيمه في واقعنا المعاش، وابتعادنا وفرارنا منه، ووضع التبريرات التي تلائم قناعاتنا، والتهرب عن كل قيمة وفكرة ورأي لا يتفق وما تربينا عليه وما أصبح قاعدة ننطلق منها في تفسير القضايا وأمور الحياة.
والحياة في تفعيل قيم السماء وانسجام المعرفة مع السلوك، وأن يكون السلوك عاكساً لتلك القيم، وأن لا تبقى مجردة عن الواقع، عندها يكون الإنسان حياً.
 الهداية الإلهية
الهداية الإلهية
تنقسم الهداية إلى قسمين:
هداية تشريعية وهي: المتمثلة في إرسال الأنبياء والرسل  ، وإنزال الكتب السماوية، وكذلك أي امتداد لحركة الأنبياء والرسل كالأوصياء والأئمة
، وإنزال الكتب السماوية، وكذلك أي امتداد لحركة الأنبياء والرسل كالأوصياء والأئمة .
.
هداية تكوينية وهي: ما تمثله من أنظمة ونواميس أودعها الله تعالى في الكون، وكذلك اللطف الإلهي الذي تفضل به على الإنسان، فقد أودع فيه ما يبعده عن المعصية والمفاسد، وحبب إليه القرب للحسن والخير، وهي هداية داخلة ضمن الإنسان، يقول تعالى:﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ، و﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ .
وبالعقل يتمكن الإنسان من التمييز بين الخير والشر، والصالح والطالح، وبه وبالإرادة والحرية يختار الطريق الأصلح والأفضل له.
نعم إذا تحكّمت النفسُ فيه، وغُيّب دور العقل، حينها يكون أسير هواه ونفسه، مكبلا بقيود المصلحة والهوى، فيصبح العقل في طوعها، يفكر لها ويخطط لما تريده منه.
وهنا يقفز سؤالٌ في الذهن:
إذا كان الله تعالى قد وضّح وبيّن للإنسان الطريقين: طريق الخير وطريق الشر وهداه السبيل، فماذا يعني إسناد الهداية لله سبحانه وتعالى؟
وإذا كان الله عز وجل هو الذي يحيي الناس وينتشلهم من ظلام الكفر والجهل، ويجعل لهم نوراً يهتدون به السبل، فهل يعني ذلك أن الله تعالى هو الذي يختار ويحدد لكل طريق أشخاصاً، فبعضهم مؤمنٌ وبعضهم كافرٌ؟
الكثير من آيات القرآن الكريم تسند الهداية لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى:﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ .
وقوله أيضا:﴿يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ وقوله تعالى:﴿وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ .
إلى غير هذه الآيات المباركة، فهل يعني ذلك أن الله تعالى يختار أقواما للهداية ويترك الآخرين في الغواية؟
إن القول بأن الله تعالى -ابتداء- هو الذي يختار من يريد للهداية ويترك آخرين في ظلام الكفر والجهل، هو قول لا يستند للصحة، بل فيه نسبة الظلم إلى الله واضحة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا.
يقول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيــــاك إيـــاك أن تبتلّ بالماء.
فالإنسان هو الذي يقرر أي الطرق يسلك، والله عز وجل يمده بما يريد، يقول تعالى:﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ .
فالذي يسعى من أجل تغيير واقعه للأفضل والأحسن.. واقعه الثقافي والمعرفي، أو واقعه الديني والسلوكي، يفتح الله تعالى له آفاقا جديدة، ويمده بعونه ولطفه.
ويقول أيضا:﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ .
هذا على مستوى الخير والصلاح، أما على مستوى اختيار طريق الضلال والظلام والبقاء في مستنقع الجهل، يقول تعالى:﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ .
فمن يريد أن يسلك مسلك الشر والفساد يجد ما يعينه على ذلك، والله عز وجل يمد الجميع بما يريدون، فإن كان يريد الجهل والكفر والضلال يمده بما يؤدي لذلك، وإن كان يريد الإيمان والنور والعلم، يمده بالآليات التي تتيح له الوصول إلى ما يصبوا إليه، يقول تعالى:﴿كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ .
 مبدأ التغيير
مبدأ التغيير
إن عملية التغيير تبدأ من الإنسان نفسه -على المستوى الفكري والثقافي والسلوكي والعملي- فيباركها الله تعالى ويؤيد صاحبها ويمده بالعون.
يقول تعالى:﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ .
إن تغيير واقع الإنسان يحتاج عزيمة وبذل جهد مضاعفٍ، فليس من السهولة بمكان تغيير ما ألفه وما تعود عليه الإنسان.
إن التخلص من أي عادة ليس أمرا مستحيلاً، ولكنه يحتاج لإرادة قوية وعزيمة صلبة، فجهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، وهو الجهاد الأكبر كما يعبر عنه الرسول  .
.
 الإصرار على الجهل
الإصرار على الجهل
إن من يكتفي بالموروث والخلفية الثقافية التي تربى عليها، والقيم التي تشكلت لديه قناعة بصحتها من خلال ما درج عليه في محيطه الأسري -قولاً وسلوكاً- تكون بمثابة انطلاقة وركيزة لسلوكه وأخلاقياته، وبالتالي يقيس كل فكرة أو رأي وفق ميزانه الخاص به، فيحكم على الصواب الذي لا يوافق قناعاته بالخطأ، وعلى الخطأ إن كان موافقاً لقناعاته بالصحة وإن كان على حساب الدين وقيمه.
لقد حثّ الإسلام على طلب العلم والتزود بالمعرفة، لأن فيهما حياة الإنسان.
إن مؤمن اليوم يعيش تحديا وصراعا مريرا في مختلف الاتجاهات، فكيف يمكن له أن يكون في مستوى ذلك التحدي إذا أهمل نفسه، ولم يُفعِّلَ الدين في وسطه، واعتمد على ثقافة ضحلة هشة؟!
إن هذا الإصرار على التمسك بالخطأ الموروث أو بقيم الوالدين الخاطئة أو للخشية من ردود أفعال المجتمع له مسببات أهمها:
ضعف الوازع الديني..
الناس يتفاوتون في مقدار إيمانهم وتفاعلهم مع مبادئ وقيم السماء ومفاهيم الإسلام والدين.
هذا التفاوت يحدد اتساع مساحته وضيقها تفاعلُ الإنسان مع تلك القيم والمبادئ، فازدياد ذلك التفاعل هو نتيجة لزيادة الإيمان وتحمل الإنسان لمسؤوليته تجاه الدين، وضعف التفاعل يحدده ضعف الوازع الديني أو انعدامه.
كذلك موت ضمير الإنسان وجموده يؤثر على نسبة إحساسه بالمسؤولية الدينية، وبموت هذا الضمير ينتهي معه الإحساس لانعدام الحراك والفاعلية.
 الغرور المعرفي
الغرور المعرفي
إن من المصائب التي يعيشها بعض مسلمي اليوم في مجتمعاتنا أو في غيرها هي:الاكتفاء بما تحت أيديهم من ثقافة سطحية هامشية، يرون أنفسهم من خلالها بأنهم الأعلم والأفضل والأكثر فهماً لأمور الحياة وقضايا الدين، يقول تعالى:﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾.
إنّ إصرار هؤلاء على عنادهم ورفض الحق إذا كان مخالفاً لأهوائهم يكرس لديهم حالة الجهل، ويُزينُ لهم أعمالهم وأفكارهم على أنها هي الحق المطلق ليمضوا في ضلالهم، ويبقوا في ظلام الجهل.
إن أسوأ أنواع الجهل حين يكون مركباً.. جهلٌ بالشيء وجهل بذلك الجهل، يتخيلُ من خلاله أنه عالمٌ.
 تفسير الدين وفق الآراء
تفسير الدين وفق الآراء
إن تركيب الآراء المتخلفة وسحبها على الدين وتفسيره بها، والإفتاء بالرأي وفق الهوى والمصالح يعد من المحرمات، لأنه إدخال ما ليس من الدين في الدين، وهو افتراء وكذب على الله ورسوله  .
.
هؤلاء قد زين لهم الشيطان أعمالهم، لجهلهم وقلة معرفتهم، بل وجرأتهم على الله تعالى، فيصفون كل ما يخالف رغباتهم وأهوائهم بالباطل، بينما الحق فيما تتفوه به ألسنتهم، يقول تعالى في مثل هؤلاء:﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ
أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾
 تزيين الباطل عزة بالإثم
تزيين الباطل عزة بالإثم
هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا بأقوالهم وأعمالهم التي تخالف الشريعة والدين وقيم السماء، بينما هم في غاية الجهل ودياجير الظلام، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ .
يحكم باطلا، ويفتي جهلا، وهو يحسب أن الحق معه، وما ذلك إلا لسيطرة الجهل عليه، وتماديه في الغي والضلال والعناد.
"فالإنسان قبل أن يمسه الهدى الإلهي كالميت المحروم من نعمة الحياة الذي لا حس له ولا حركة، فإن آمن بربه إيماناً يرتضيه كان كمن أحياه الله بعد موته، وجعل له نورا يدور معه حيث دار، يبصر في شعاعه خيره وشره، ونفعه من ضره، فيأخذ ما ينفعه ويدع ما يضره، وهكذا يسير في مسير الحياة".
 في إحياء الدين حياتُنا
في إحياء الدين حياتُنا
لا يمكن القول أن الدين ميّت، لأن الدين لا يموت أبدا، فهو في كل عصر غضٌّ جديد، يستوعب الزمان والمكان، شاملٌ لكل أبعاد الحياة وما يرتبط بالإنسان من قريب أو بعيد.
ولا يوجد دين سماوية أو نظرية وضعية شاملة لأبعاد الحياة بكل تفاصيلها كالإسلام بنظمه وقوانينه وأحكامه، فهو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووضع لها حكما.
إذاً؛ فما معنى قول إحياء الدين، إذا كان الدين لا يموت وهو حيٌّ دائماً، فهل يصح قول إحياء الدين؟
إنّ الله تعالى يدعو الناس لإحياء الدين في أوساطهم، وإحياء أنفسهم بالدين.
فالدين حيٌ، ولكنه قد يموت إذا تركنا العمل به ولم نفعليه في أوساطنا، فيصبح كدواء المريض عند عدم استخدامه وشربه، فما قيمة دواء لا يستخدم؟!
إن المريض بحاجة لشرب الدواء كي يشفى من علته ومرضه.
والإنسان الذي تتحكم فيه آراؤه وقناعاته الخاطئة، ويعتمدها في حياته ميّتٌ يحتاج للحياة من خلال استعمال تلك الوصفة يقول تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ..﴾ .
فالناس قبل الاستجابة لدعوة الله تعالى أموات، وبمجرد الإذعان والاستجابة لتلك الدعوة ينتشل الإنسان نفسه من غياهب الضلال لنور الهداية الإلهية.
إنّ الدين يحيى بتفعيله في واقع الإنسان، والإنسان يحيى بإحياء الدين وقيمه.
ولكن هذه العملية ليست فعلية بل شأنية، أي أن الدين من شأنه الإحياء بشرط تفعليه على واقع الإنسان المسلم، أما حينما يبقى الدين جامدا غير متحرك في وسطنا، فإننا نبقى أموات لأننا لم نحرك الدين في حياتنا.
فالصلاة وهي مفردة من مفردات الدين، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن بشرط التفاعل مع غاياتها وأهدافها، أما حينما تؤدى من باب إسقاط الواجب، فإن الكاذب يبقى كاذباً والذي يغتاب الناس يبقى على حاله، والذي يفتخر على البشر أو يزدري منهم يبقى على عهده.
إن الذي يدرك غاية الصلاة وهدفها، يمنع نفسه عن الغيبة والنميمة والشتم والكلام البذيء وكل رذيلة، أما الذي تكون صلاته نقرٌ كنقر الغراب، ولا يعرف من الصلاة إلا ألفاظها وحركاتها، أو يلتزم بقراءة بعض الأدعية والمحافظة على أداءها في مختلف الأوقات المخصصة لها بشكل سطحي قشري، فإن الصلاة و قراءة الأدعية المختلفة لا يؤثر فيه، فيبقى على سالف عهده وخلقه، لا تناله عملية التغيير، فليس الدين في الالتزام القشري أوبأداء طقوس معينة، بل الدين معاملة أيضاً.
لذلك يصف الإمام علي  بعض أصحابه الذين أحيوا الدين في أوساطهم بقوله
بعض أصحابه الذين أحيوا الدين في أوساطهم بقوله أَوِّهِ على إخواني الذين تلوا الكتاب فأحكموه، وتدبّروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة .
أَوِّهِ على إخواني الذين تلوا الكتاب فأحكموه، وتدبّروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة .
فهؤلاء قد تفاعلوا وفعّلوا الدين وقيمه ونقلوه من السكون للحركة، لذلك كانت أعمالهم وأقوالهم منسجمة مع بعضها، يفعلون ما يقولون، فأصبحوا أحياءً بفاعليتهم وتفعيلهم.
 الإيمان نورٌ
الإيمان نورٌ
الآية المباركة تقارن بين فئتين وطائفتين من الناس، الأولى كانت في الضلال، وقد غيروا مسيرتهم باعتناق الإسلام والتمسك بالقيم السماوية وتفعيلها في واقعهم، والثانية وهي التي بقت على ضلالها وكفرها وعنادها وعدم تفاعلها مع قيم السماء، وهم الذين لا يكتفون بضلالهم، وإنما يسعون أيضا من أجل ضلال الآخرين بأفكارهم وآراءهم المخالفة للدين.
"إن الإيمان ليس مجرد معتقدات جافة وأوراد وطقوس، بل هو بمثابة الروح التي تحل في النفوس الميتة غير المؤمنة، فتؤثر عليها في جميع شؤونها وتمنح العيون الرؤية، والآذان قدرة السمع، واللسان قوة البيان، والأطراف العزم على أداء النشاطات البناءة... الإيمان يغير الأفراد، ويشمل هذا التغيير كل جوانب الحياة، وتبدو آثاره في كل الحركات والسكنات... والظاهر أن المقصود ليس القرآن وتعاليم الشرع فحسب، بل أكثر من ذلك، حيث يمنح الإيمان بالله الإنسان رؤية وإدراكاً جديدين... يمنحه رؤية واضحة ويوسع من آفاق نظرته لتتجاوز إطار حياته المادية وجدران عالم المادة الضيق إلى عالم أرحب وأوسع" .
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.