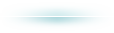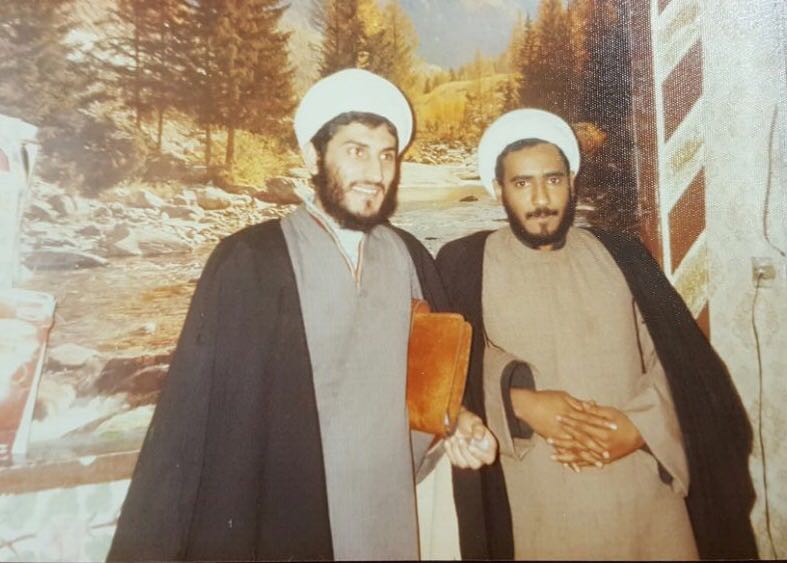مواجهة التحديات بين املاءات الظروف والتمسك بالوحدة الداخلية
تكاثرت التحديات في السنوات الأخيرة على الأمة الإسلامية بشكل عام وعلى الطائفة الشيعية بشكل خاص، فمع سقوط النظام العراقي البائد تنادى التكفيريون من كل حدب وصوب للتواجد في العراق تحت ذريعة محاربة الغزاة إلا أنهم وجهوا نيران الحقد ضد الشيعة ومعتقداتهم، ولعل المحاولات المتكررة لقتل زوار الإمام الحسين  والهجوم على كربلاء المقدسة وأخيراً تفجير مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام يدخل في هذا الإطار.
والهجوم على كربلاء المقدسة وأخيراً تفجير مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام يدخل في هذا الإطار.
والأمر في العديد من المناطق وإن كان لا يصل إلى القتل إلا أنه يبذر المقدمات ويهيئ الأرضية له، فالتكفير ووصف الشيعة بأهل البدع وعبدة القبور يستبدل حرمة الدم والمال والعرض التي يتمتع بها كل مسلم بل وكل مواطن بحلية دمه وماله وعرضه متى ما سنحت الفرصة.
وأمام هذه التحديات يُطل علينا منهج يدعو للتقارب والتعايش على مبدأ الحوار والأخوة الإسلامية، وهو منهج مقبول ومنطقي في خطوطه العريضة، خصوصا وهو يستحضر في انطلاقته تحقيق هدف رفع المظالم عن أبناء الطائفة في هذه البلاد ويلامس الأمل لكل مواطن في أن يعيش حياة كريمة بعيدة عن التمييز والتهميش ويعطي الانطباع للطرف الخر بإمكانية العيش على أساس المشاركة والحقوق والواجبات المتبادلة، ويزيد من الاحترام لأصحاب هذا المنهج حينما يرفقون دعوتهم هذه بالطلب من كل طرف بقبول الآخر على أساس الاختلاف واحتفاظ كل طرف بخصوصيته، وربما اندفع البعض لتأييده والوقوف معه لما يعتقد من أنه ينهي حالة القلق والألم التي طالما رافقتهم منذ أمد بعيد وإلى يومنا الحاضر.
والحق.. انه وبعد جولة من اللقاءات والمبادرات بعثت في مجملها آفاق الوصول إلى حالة من الطمأنينة في نفوس البعض ممن يتوق إلى الإصلاح والتغيير، إلا أن المتتبع للأمر يلاحظ أن أصحاب هذا المنهج يهربون من مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترضهم بمزيد من التركيز على قضايا جانبية تأخذ طابع الإثارة الصاخبة على الصعيد الاجتماعي وترسل ومضات إعلامية خجولة ومشكوك فيها عند من يراد وصولها إليهم، وتوحي في ذات الوقت للأتباع والمريدين بان تعطل المسيرة وعدم النجاح مرده لوجود هذه القضايا فهي العقبة أمام الوحدة، وان التفكير في إعطاء الحقوق لا يمر دون الاشتراك في الحراب الداخلي لتنقية المجتمع منها. وهنا تكمن خطورة الأمر أولا في تحويل الثانوي إلى أساسي وثانيا في طريقة المعالجة حينما تلجا إلى دواء تعلم مسبقا انه سيخلف وراءه آثارا جانبية لا تقل خطورتها عن أصل المرض.
وهنا.. لا نشكك في نوايا القائمين على هذا النهج ولكن الاستغراب يقفز إلى الواجهة حينما نراقب اختياراته وأساليبه وهم ممن يمتلكون الخبرة في هذه البلاد وعلى دراية بطبيعة أبناء مجتمعهم! خصوصا إذا ما علمنا أن بعض الاختيارات تصطدم مع البديهيات في العمل ولا تعمل على تأسيس جبهة يمكنها مقاومة التحديات.
وربما اُعتمد في تحديد القضايا المختارة على أملاءات الظروف وطبيعة مطالب الطرف الأخر فيجري البحث عن مستند يستند إليه حتى وإن كان ذلك على أساس وحدة المجتمع وتماسكه، ولذا فإنك ترى المحور في هذا النهج هو الثابت وغيره متغير. فالوجوه والانتماءات في كل قضية تتغير نظرا لرأي مرجعيتها الفكرية إن لم نقل الفقهية وهي هنا في القضايا المختارة من قبلهم اقرب إلى الجانب الفقهي من الجانب الفكري، وبالتالي فإن المتلقي لها من أبناء الطائفة سيرتكز على رؤية المرجعية الفقهية والفكرية التي ينتمي إليها، بينما -والحالة هنا- لا يمكن التعرف على مرجعية واضحة لمن يثير القضايا سوى الظروف وامتلاءاتها! والعلاقات ومطالبها!
فالقضايا عندهم تأخذ حجومها وترتيب أولوياتها من خلال أروقة اللقاءات والعلاقات مع الآخر وليت الأمر يأتي على خلفية اتفاقات أو تحالفات إنما على أرضية الظنون والآمال، وطبيعة الظروف السياسية المواكبة لهذه اللقاءات، وهي أمور متغيرة بل لا تنتهي عند مطلب واحد فاليوم نبدأ من مسألة خلافية صغيرة وغدا ننتهي إلى مطلب أوسع.
ولو أمكننا القبول بهذه الحالة الانتقائية نظرا لاستنادها إجمالا على رأي فقيه حي جامع لشرائط الفتوى إلا أن آثارها السلبية في الوسط الاجتماعي مما لا يمكن القبول به على الإطلاق، خصوصا مع ملاحظة أن المجتمع المتماسك برباط العقيدة هو القادر على مواجهة التحديات التي تحاول النيل منه بل والقضاء عليه، والصعوبات التي تعترض طريقه في مسيرته نحو الحق والعدل.
وإذا كان هذا النهج يهدف من عمله الوصول بالشيعة لنيل حقوقهم غير منقوصة فمن الأولى مراعاة وحدتهم وتماسكهم بدلا من إثارة موارد الخلاف بينهم، علما بأن التبشير بموارد الخلاف والتحشيد للانتصار لها أو الانتصار لنقيضها لا يخدم الهدف المراد بل يدفع الجميع نحو التكتل والتخندق لرأي المرجعية التي ينتمي إليها والجهة التي يتحزب لها.
وحتى لا نبخس المتصدين إعلاميا لهذا المنهج من حقهم في إبداء آراءهم في القضايا المختلف عليها نقول إن من حقهم ذلك ولعلهم عبروا عن ذلك من خلال المقابلات الإعلامية -وما أكثرها - إلا إن ما يعاب عليهم هو ذلك التحول من حقهم في إبداء الرأي إلى مرحلة التصدي للمخالف إذ لا يمكن فهم مبادرة إصدار بيان وان غلف بأدبيات راقية من التسامح واللجوء للنصح والابتعاد عن التحريم والتجريم -لا يمكن فهمه- في إطار أملاءات الظروف والاستجابة لمتطلبات العمل ألعلاقاتي إلا حالة من التصدي والتحدي ولعله يتبع البيان إجراءات منهم أو من مريديهم أو من الجهة التي انطلقنا سويا نحوها لرفع الحيف عنا فإذا بنا نستعين بها أو نحضها-من دون قصد- على مواجهة أمور خلافية بيننا.
إن نيل الحقوق ورفع المظالم هو بالأساس عمل سياسي ويحتاج لجهد سياسي بالدرجة الأولى فلماذا إدخال هذا الهدف السامي في قضايا خلافية من هذا النوع معلوم سلفا أنها ستقود إلى مزيد من الإثارة والصراع الداخلي. إن التقدم خطوات للأمام في تحقيق انجازات الوحدة والتقارب مع الأخر كفيل بالقفز بالأمة بعيدا عن القضايا الهامشية إن توصيفنا لقضية ما على أنها عمل ظلامي ممكن التغلب عليها ليس بشتمها او شتم القائمين بها وعليها بل بإشعال شموع الانجازات فدعونا نفتش عنها في الكم الهائل من الحضور الإعلامي المتناثر بين الفضائيات والجرائد والصحف والمواقع الالكترونية ونشرات خطب الجمعة لعل فيها الجواب المقنع لمن يريد أن يقتنع بدون صخب اِثأري وجدل اجتماعي في مسائل خلافية.
إن التخندق في القضايا الهامشية وراء الأسماء المحترمة في المجتمع أو دغدغة جهات تتبنى موقف فقهي محترم في هذا النوع من القضايا هو أمر يثير التساؤل والاستغراب سيما ونحن أبناء قرية نعرف البون الشاسع أو فلنقل عدم التنسيق المتبادل في القضايا الإستراتيجية وهي ذات المنحى الأهم في التوافق والاصطفاف على ارض الواقع وهو للأسف ما لا نلاحظه.
إنني أدعو إخواني ممن يعتنقون هذا النهج ولست بعيدا عنهم إلى التأمل والتفكر والمراجعة في هذه المبادرات التي لا تخدم الطائفة في هذا الوطن وفي هذه الأوقات ولن تخدمهم في مسيرتهم نحو المفردات التي تعج بها الادبيات من قبيل المجتمع الأهلي، السلم الاجتماعي, وتقبل الأخر وما أشبه اوليس من الأولى أن نحقق هذه المصطلحات في مجتمعنا.