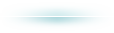بناء المواطنة
قصة تروى عن بائع كان يصنع الأواني الفخارية ثم يبيعها في السوق، و ذات يوم باع جرة لشخص ما وقبض الثمن، لكن القصة لم تنتهي هنا، فلقد قام الأخير بكسر الجرة فور شرائها في مرأى و مسمع البائع، و بهذا التصرف استطاع أن يثير البائع و أن يدفعه للغضب. فبأي منظار يمكننا أن ننظر لهذا الغضب؟؟؟!!!، و بماذا يمكننا أن نحكم عليه؟؟؟!!!، و هل يمكن فهم هذا الغضب أو الانفعال و تفسيره و قد انتقلت السلعة من ملك التاجر الى ملك شخص آخر؟؟؟!!!.
نعم هذا الغضب يمكن فهمه و تفسيره. وهو نفس الغضب الذي يمكن أن نشاهده لو قام شخص ما بشراء لوحة فنان ثم أحرقها أمام ناظريه. إنه الغضب من أجل الحب و الإنتماء الذي نرفض كبشر بنوازعنا الفطرية السماح بتكسيره و تحطيمه. و من هذا الغضب يمكن أن نستفيد و تستفيد الشعوب و الأمم و الحكومات أبلغ الحكم و المواعظ و العبر و الدروس في معاني المواطنة، و أسس الحب و الولاء و الانتماء للأوطان.
إن هذا الحب إنما هو حب عملي أكثر من كونه حبا نظريا، أي أنه: ليس مما يدرَّس في الكتب، و لا مما يوضع في الخطب أو الصحف، و لا مما يكتب في المقالات أو ينشر في الكتب. انه شيء أشبه بالأشجار، التي تنمو و تترعرع بالعناية و الحب و الرعاية و الإهتمام، بالغذاء الحقيقي، لا بالسراب.
إن الحب و الولاء و الانتماء في موضوع المواطنة إنما هو في الحقيقة نتيجة للمساواة في اتاحة الفرص للمشاركة بحرية و عدل في الابداع و البناء لذلك البناء. فالوطن الذي نبنيه و نشارك في ابداعه، من الطبيعي أن نحبه، و أن ندافع عنه و نحميه، و ليس من السهل أن نتنازل عن أوطاننا تلك التي بنيت بسواعدنا و خلقت من أفكارنا، حتى لو تحملنا في سبيلها أقسى الآلام، و حتى لو كنا أبناءها بالتبني فقط، أي حتى لو لم نكن من أبنائها أو مواطنيها الأصليين.
انها علاقة الفن بالفنان، و علاقة المبدع بالإبداع. فحتى عندما يضع الفنان فنه في أيدي الناس فلن يتنازل عنه و لن ينساه، و سيظل محبا له متمسكا بذكراه. فعلاقة المبدِع بالمبدَع هنا هي علاقة أمومة و علاقة بنوة في نفس الوقت، و انها هكذا تغدوا علاقة حب لا ينتزع لا بالطيب و لا بالاكراه.
وهكذا فالمواطنة علاقة لا يمكن أن تكون سليمة لا في ظل القمع و لا في ظل الاكراه. لأنها تتغذى على الحرية و المشاركة و الابداع و العطاء، و لا يمكن أن يكون هناك حب و تولد مواطنة و يولد إبداع في ظل القيد و القمع و الإكراه.
و من هنا فنحن أبناء أوطاننا، نرضع منها حبنا و الحرية، فنبنيها بجهدنا و عرقنا، ثم نتيجة ذلك، نحبها كما نحب أبناءنا و آباءنا. فهي تبنينا كما بنانا أباؤنا، و نحن نبنيها كما نبني فلذات أكبادنا، و من هنا تتجذر علاقة الحب و الولاء و الانتماء، فكلما أتيحت لنا الفرصة أكثر أن نتربى في ظل الحب فيها أصبحنا نحبها أكثر، و نغمرها بمزيد من حبنا، و كلما سمح لنا أن نشارك في تطويرها و تعميرها بحرية، أصبحنا أكثر التصاقا بها، فهي هنا منا و نحن منها أيضا.
فإذا لا يمكن أن نتهم عندها في حبنا أو ولائنا لأوطاننا، إلا إذا كنا أبناء عاقين لأوطاننا، أو كنا في حقيقة الأمر محرومين من المشاركة و الابداع في بناء أوطاننا، و/أو محرومين من العيش و التربية الكريمة في أجوائها. و حيث أنه يستحيل أن نتفق جميعا على أن نكره و أن نخون أوطاننا التي تحسن لنا، فعندها كيف يصح أن يكون الخطأ منا و أن يقع اللوم علينا، بل نحن حينها أولى بأن يغفر لنا، و أن يعفى عنا, و أن يرثى لحالنا، و أن يعطف علينا؟؟؟!!!.
فهكذا هو الولاء، و هكذا هي المواطنة إذا ... فالحب و المواطنة و الولاء، لا يمكن إلا أن تكون مشروطة بالحرية و المشاركة و إتاحة الفرص المتساوية للابداع و البناء و العيش الكريم تحت سماء و في ظل فيافي الأوطان.
وهنا لابد أن نعود لصانع الجرار، علنا نتعلم منه الدرس الذي يبدوا أننا أغفلناه كثيرا. فليست المواطنة الحقة هي في أن نأخذ من خيرات الوطن ما هو أكثر، بل في أن نعطي للوطن ما هو أكثر، في أجواء من الحرية و الحب و المشاركة و الإنفتاح، ثم بعدها يأخذ كل منا ما يستحق، فلا نعطي ما لا يحق لمن لا يستحق.