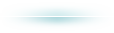إشكاليات مفهوم العداوة
في النظام السياسي العربي
معرفة العدو قضية محورية في رسم علاقات الإنسان بمحيطه وتحديد سلوكه.. وهكذا تكتسب أهمية معرفة ما يندرج تحته، ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين  : «أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ وَأَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ. فَأَصْدِقَاؤُكَ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوُّ عَدُوِّكَ. وَأَعْدَاؤُكَ: عَدُوُّكَ، وَعَدُوُّ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوِّك». وأكدت الآيات القرآنية على معرفة العدو، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ﴾[1].
: «أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ وَأَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ. فَأَصْدِقَاؤُكَ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوُّ عَدُوِّكَ. وَأَعْدَاؤُكَ: عَدُوُّكَ، وَعَدُوُّ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوِّك». وأكدت الآيات القرآنية على معرفة العدو، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ﴾[1].
بيد أن العداوة لا تنحصر في الجهة التي تتعدى على الحقوق (العدوان)، حيث قد يصطنع الإنسان العدو من خلال الخلل في العلاقة التي يبديها الإنسان مما يصنع العداوة. وهذا المعنى يتشظى في أكثر من اتجاه؛ منه العجز عن تمييز العدو من الصديق، وحينها يقوم الإنسان بسلوك عدواني تجاه غير الأعداء، ومنه قوله تعالى:﴿قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِين﴾[2]، وحينها تكون خيارات سلوك العدو المصطنع مفتوحة، ومنها أن يكون الطرف الآخر حياديًّا، وإنما ينتج الأذى عن طبيعة العلاقة التي يرسمها الإنسان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾[3]. فالمال لن يؤذي الإنسان وإنما هو سلوك الإنسان ما يجلب له الأذى.
بالأحرى؛ إن ما يصنع العداوة أو الصداقة في قسم كبير منه هو طريقة تفكير الإنسان وما يحمله من معارف تجاه الآخرين أو ما يرسمه لذاته من موقعية تجعل الآخرين مناوئين كأن يود استغلالهم.
- استعداء الشعوب
هذا الحديث ليس دردشة ثقافية وإنما هو لتصويب النظر على داء الأنظمة السياسية في العالم الثالث، ومنه بطبيعة الحال العالم العربي.
فضبابية تحديد العدو الخارجي هي مشكلة السياسات الخارجية لأنظمة العالم الثالث، وأيضاً تحديد العدو الجدي والداخلي هو الأكثر تعقيداً ممَّا يصنع تباين المسارات بين الشعوب والأنظمة.
إن إشكالية ما يُعرف بالإرهاب لا تعدو أن تكون تضخيماً وتهويلاً، بل وأحياناً تخليقاً وافتراءً ناتجاً عن النظرة العدوانية للشعوب من قبل النخب السياسية، أو يكون «الإرهاب!» نتيجة (رد فعل) الممارسة العدوانية الفرعونية.
قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾، فالحكم الفاسد كما هو السبب في تقويض المجتمعات وتدهور الاقتصاد فهو أيضاً سبب أساس للثورة الاجتماعية.
ويبدو أن من مناشئ الاستعداء هو «العلو» و«الاستكبار» بحيث إن التربع على العرش يتطلب ممارسة استضعاف شريحة واسعة من المجتمع لتكون عمالة منخفضة الأجر، كما يتطلب تمييز طبقة يعتمدها للحكم وتدافع عنه لأنها تستفيد منه:
قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [4].
ومن جهة أخرى تكون العنصرية باختلاف مشاربها العرقية والقبلية والدينية والاقتصادية هي أحد أسباب استعداء عامة الشعب، خصوصاً حين تتداخل مع «العلو» فتشكل عصبة الحكم الفاسد.
والحمية الجاهلية (العصبة/ العنصرية) تعرقل التقدم الحضاري الذي ينشده الإنسان في ظل القيم المثلى، خصوصاً العمل الصالح الذي يستبدل بالعصبيات.
وإذا كنا اليوم نلاحظ بوضوح العنصرية الصهيونية، فهي إنما بدأت بالافتراء على الله، قــال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَآءُ اللهِ وَأَحِبَّآؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُم بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾[5].
وهذه العنصرية تجعل الآخر منعدم الحقوق والاعتبار، قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾[6].
فالنفسية المتشكلة بالنظرة العنصرية تضيق بالخير للآخر لأنها لا تراه يستحق الحياة إلا أن تكون حياته في إطار منفعة الشعب المختار أو القبيلة المختارة.. فهذه النظرة الاستعلائية تفسر لنا سلوكات النخب السياسية حين تمنُّ على الشعوب ببعض الفتات مما هو حق لها أصلاً، وهكذا يتخذون عباد الله خولاً ومال الله دولاً.
إن مشكلة الشريحة المساندة للنخب السياسية، والتي تستجيب للسياسات الفاسدة والظالمة، أنها تنتفع بالفساد مهما تذرعت بمبررات التعقل والواقعية أو الدين. قال تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ﴾[7]. فما كان لفرعون أن يستخف القوم ويبعدهم عن العقل والرشد إلا أن استثار غرائزهم وشهواتهم (مصالحهم)، وما كان لاستثارة الأهواء أن تؤثر فيهم فيطيعون فرعون إلا بوصفهم فاسقين قد استمرؤوا الفساد وظلم العباد.
- لو تمثل الفقر رجلا لقتلته
إن النظم العربية في غنى عن اختلاق الأعداء ومعاداة شعوبها فلديها ما يكفيها من التحديات الكبيرة التي تشدُّها في درك التخلُّف.
ويبدو أن الباحثين الاستراتيجيين يشيرون عادة للمخاطر (ندرة المياه، الأقليات العرقية والمذهبية، الصراع العربي الإسرائيلي، الأرهاب...)، ويشير بعضهم للفقر والفساد ضمن المخاطر الاستراتيجية.. ويبدو أنهما الأهم لاتصالهما بالاقتصاد والمجتمع والسياسة، وأيضاً البنية الفاسدة المنتجة للفقر لا تستطيع التغلُّب على التحديات الأخرى بصورة جدية.
وإذا كان ثمة مرادف للتخلف بمعنى التلازم فهو الفساد. وهكذا فالتخلف عنوان لأوجه الفساد المتعددة.. ومن بين الأوجه السيئة للفساد التي قد تكون من أشدها هدماً، أو ربما يكون آلية الفساد في تقويض المجتمعات.. تحديداً نقصد «الفقر».. فالتلازم بين الفقر جدلي، فهو إحدى نتائج الفساد، كما أن استشراء الفقر يُعمِّق ويُعمِّم الفساد.
إن من توالي الفسادِ الفقرَ العام والغنى الفاحش الخاص.. والفقر يقمع النوازع الخيِّرة في الإنسان لصالح البحث عن البقاء، بينما يقتل الغنى الفاحش النوازع الأخلاقية لتستبدل بقيم الثروة.
وهاتان الصورتان (الغنى والفقر) نجدهما بوفرة في عالمنا العربي، فالبيوت المتهالكة والقصور الفارهة، وطوابير الخبز وحفلات البذخ. وهذا التقابل ليس في دولتين أو شعبين وإنما في البلد الواحد، وأيضاً ليس ثمة بلد عربي بمنأى عن ذلك حتى دول الخليج النفطية.
ويُصاب الإنسان بالاشمئزاز من هذه الصور المتقابلة والمتفاوتة بفحش، والذي يتعجب المرء منه ألفتها، كأنما الفقر قدر المجتمع والغنى قدر حفنة من المحظوظين، وألَّا علاقة بين فحش ثراء هؤلاء وفقر المجتمع.
ويُصاب الإنسان بالغثيان من تخمة خطاب الإشفاق على الفقراء من النخب السياسية، والأكثر سوءاً أن يُتجاهل سلوك النخب السياسية في أسباب التخلف أو عدم الاستقرار الاجتماعي..
إن تراجع القيم الأخلاقية وتآكل الروح الاجتماعية وزعزعة الثقة بالنظام السياسي، كل ذلك يصدر عن الفقر، ويسهم الفساد في إيصاد أبواب المعالجات الهادئة، مما يجعل مقاربة المجتمعات غير لينة، فتتكاثر الاعتصامات والمظاهرات التي أصبحت مألوفة في أقنية الأخبار، والقادم أعظم.
- الفقر في العالم العربي
وبحسب كتاب الفقر والفساد في العالم العربي (د. سمير التنير): إن أكثر البلدان العربية ذات الثقل السكاني تقع في مرتبة متأخرة من حيث التنمية البشرية بين دول العالم الـ177، وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2006 - الجزائر 102، مصر 111، المغرب 123، السودان 141، اليمن 150، وتشير دراسات معاصرة إلى انهيار الطبقة الوسطى العربية التي شكَّلت شريحة أساسية في المجتمعات العربية أواسط القرن الماضي، ما أدى إلى تراكم الفقراء في أحزمة البؤس المحيطة بالمدن العربية التي باتت تشكل أكثر من 56% من العرب، وإلى تفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء منذ الثمانينات.
وقد ارتفع متوسط معدل البطالة في البلدان العربية إلى أكثر من 15%، كما أدى انخفاض النمو الاقتصادي العربي إلى ارتفاع معدل البطالة، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1.2%، وذلك في الفترة الممتدة من عام 1980 إلى العام 2000.
ويرى المختصون أن المتراكم من إجمالي الدخل القومي العربي للنصف الأخير من القرن العشرين (1950 - 2000) يقدر بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، أي ( ثلاثة تريليونات دولار)، ويقدر ما صُرف على التسليح من هذا المبلغ بحدود ألف مليار دولار.
أما عملية إعمار البنى التحتية وما خُصِّص للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية فقد استهلك بحدود ألف مليار دولار أخرى في الفترة ذاتها. أما الألف الثالثة فيقدر أنها ذهبت إلى أشخاص ومؤسسات عملوا وسعوا من أجل تسهيل وتسيير العمليات والأعمال المطلوبة للشقين الأولين. وهذا يعني -إن صحت هذه الأرقام- أن ثلث ثروة الأمة نُهبت وحُجبت عن مشروعات التنمية نتيجة الفساد.
وبحسب جريدة الوقت البحرينية (العدد 801) فاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (أسكوا) تشير إلى أن نصف سكان العالم العربي يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. وجاء في الدراسة أن صورة العرب الأثرياء هي الصورة الطاغية، إلا أن الواقع يُظهر أن بين 40% إلى 50% من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميًّا.
في هذا الصدد، يصف بول سوليفان الوضع العربي بالقول: «رغم الكثير من القوى المولدة للعنف وعدم الاستقرار والغضب في العالم العربي، إلا أن الجمود الاقتصادي في العقدين الأخيرين، لم يساعد على تبريد سخونة المنطقة، فانحدار الدخول والأجور وعدم المساواة في الدخل والثروات وأزمات التعليم والفساد الاقتصادي والقمع السياسي والتوترات، كل ذلك زاد من المشكلات السياسية والاقتصادية.
وكلما اتَّسعت الفجوة بين الحاجات الأساسية للفقراء وقدرتهم الشرائية، ازداد الميل إلى عدم الاستقرار الاجتماعي وأصبحت البيئة ملائمة للتطرف وهدر الإمكانات المادية والبشرية. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان في اختتام مؤتمر الأمم المتحدة حول الدول الأقل تقدماً، إلى «ارتفاع عدد الدول الأكثر فقراً من 21 دولة العام 1971 إلى 49 دولة العام 2001». وهذا يعني أن الإخفاق الاقتصادي في 49 دولة في العام قاد إلى وضع إنساني بائس لشعوبها، وهيَّأ البيئة لاضطرابات وأزمات عدة، حيث إن السياسة الاقتصادية تهدف في الأساس إلى تحقيق رفاهية المجتمع ورفع مستوى المعيشة.
- تصحيح العلاقة
أصبح واضحاً عدم كفاية الحلول والإجراءات الأمنية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم العربي.. وعلى أقل تقدير ينبغي أن تكون المعالجات الأمنية بعد بدء جهود الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي.
إن أزمة الثقة بين المواطن والنظام السياسي ناتجة بدءاً من استهدافات النخب السياسية استغلال جهد المواطن دون اعتبار لحقوقه وكرامته، ومن جهة أخرى تباين مساراتها مع تطلعاته وثقافته.. وبعبارة موجزة: إن بدء الأزمة هو أن المواطن يستشعر أن النخب السياسية تلحق به الأذى وتستغله فمن الطبيعي أن يبادلها العداء.
ومن هنا فإن المقولات المؤسسة على انصياع المواطن لإرادة النظام، وتحديد المواطن الصالح وفقاً لمزاج النخب السياسية؛ هي ثقافة فرعونية تمتهن الإنسان وتجانب الحق، ولن يكون مآلها إلَّا المزيد من المشاكل.
إن أساس شرعية النظام السياسي أن ينبثق عن إرادة المجتمع، وأن يمتثل لقيم العدالة والحرية، وأن يستجيب لتطلعات المجتمع. وبالتالي بقدر ما يكون النظام السياسي مخطئاً في معاداة المواطن فإن استشعار المواطن العداء للنظام السياسي الذي يُلحق به الأذى يكون مبرراً من حيث المبدأ.
إن المبادرة لتصحيح العلاقة تبدأ من النخب السياسية لأنها المشكلة أساساً ولامتلاكها أدوات القدرة والفاعلية، وبالتالي هي التي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى.. بينما قصارى ما يتحمله المواطن في مجابهة العدوان الذي تمارسه النخب هو الحكمة في ممارسة حقه الطبيعي.