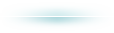الأدوات المعيْنة المساعدة على التدبّر
- يقول البعض:
لا شك أنّ الذي يريد أن يقتحم حقلًا علميًا يحتاج إلى التسلح بأدوات معينة تساعده على سبر أغوار ذلك البحر الخضم، ومن يريد التدبّر في القرآن الكريم يحتاج إلى أمور تساعده على الإبحار في المحيط القرآني العميق.
- ثم يتساءل:
ما هي الأدوات المعينة والمساعدة على التدبّر في القرآن الكريم والتي من شأنها أن تسهّل علينا عملية التدبّر؟
ولعلّنا في الإجابة على هذا السؤال الملحّ نقف عند مجموعة من الأدوات المساعدة التي تأخذ بيد المتدبّر، وتجسّر المسافة بينه وبين المعنى القرآني، وتقرّب له مسافة العبور والوصول، ومنها:
1ـ القرآن الكريم:
فالقرآن الكريم بذاته )مُبِينٍ( (1)، وقد أنزله الله كاشفًا و)تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ( (2)، وكما يقول أمير المؤمنين  : «كتاب الله تبصرون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهّد بعضه لبعض«(3).
: «كتاب الله تبصرون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهّد بعضه لبعض«(3).
وما دام القرآن الكريم «ينطق بعضه ببعض، ويشهّد بعضه لبعض«، و(يفسِّر بعضه بعضًا)، فيمكن الرجوع له ليفسّر نفسه، والرجوع إلى آيات أخرى فيه تسهّل علينا عملية التدبّر، وربط آياته ببعضها، واستخراج معاني بعضها من الآخر، وإضاءة جوانب فيها.
والعلاقة بين الاطلاع على الآيات الأخرى وعمق التدبّر وسعته علاقة طردية، فكلما زاد اطلاعنا على القرآن الكريم كان تدبّرنا أعمق وأوسع وأدقّ.
فحين يقول ربّنا ـ تبارك وتعالى ـ: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) (4)، قد يجول ببالنا أن نعرف: ما هو (الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ)؟؛ فنجد آية أخرى تجيب على ذلك، وتقول: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (5)، أي أنّ الصراط المستقيم هو صراط الله، وهو نفسه (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ) (6).
وقد نقرأ قوله تعالى: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) (7)، ونسأل القرآن الكريم: هل لك أن تبيّن لنا مقصودك من (الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ)؟، من هم الذين أنعم الله عليهم؟
فيجيبنا القرآن بلسانه الصادح الناطق: (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا)(8).
فمن خلال الجمع بين هذه الآيات أصبح المعنى جليًا وواضحًا، فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومَن تبعهم، وطريقهم طريق ثالث يباين طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين.
وبهذه الطريقة يمكن أن نسأل أيضًا:
- من المقصود بـ (المغضوب عليهم)؟
- من المقصود بـ (الضالين)؟
2ـ السنة المباركة:
السنة المباركة جاءت حاشية على كتاب الله المجيد، شارحة وموضحة ومبيّنة ومفصّلة، ومدى معرفتنا بنميرها الزلال يضيء لنا آيات ومعاني الكتاب العزيز.
فلو قرأ أحدنا قوله تعالى عن نبيّه الكريم يونس (ذي النون): (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (9).
فقد تتملكه الحيرة والدهشة ويقول: هل يليق بنبي أن يظنّ أنّ الله لا يقدر عليه؟، أليس ذاك شكًا في قدرة الله النافذة؟، فيبادر حديث لإمامنا عالم آل محمد علي بن موسى الرضا  ، ويفكّ أغلال حيرتنا، فقد سأله المأمونُ العباسي يومًا عن هذه الآية، فقال الرضا
، ويفكّ أغلال حيرتنا، فقد سأله المأمونُ العباسي يومًا عن هذه الآية، فقال الرضا  : «إنّما (ظنّ) بمعنى استيقن أنّ الله لن يضيّق عليه رزقه، ألا تسمع قول الله - عزّ وجلّ -: (وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) (10)، أي ضيّق عليه. ولو ظنّ أنّ الله لن يقدر عليه لكان قد كفر« (11).
: «إنّما (ظنّ) بمعنى استيقن أنّ الله لن يضيّق عليه رزقه، ألا تسمع قول الله - عزّ وجلّ -: (وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) (10)، أي ضيّق عليه. ولو ظنّ أنّ الله لن يقدر عليه لكان قد كفر« (11).
وهذه الرواية تنقلنا من دائرة التشكيك في ثقة النبي يونس  بالقدرة الإلهية؛ لتسبغ على قلوبنا مدى اليقين العميم المطلق عند هذا النبي العظيم بكرم الله الدافق عليه وثقته الواسعة به.
بالقدرة الإلهية؛ لتسبغ على قلوبنا مدى اليقين العميم المطلق عند هذا النبي العظيم بكرم الله الدافق عليه وثقته الواسعة به.
ولو قرأ أحدنا قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (12).
فيمكن أن يقرأ الروايات الثلاث التالية:
الأولى: مروية عن الإمام الصادق  ، وترى أنّ النبي إبراهيم
، وترى أنّ النبي إبراهيم  إنّما «سأل عن الكيفية، والكيفيةُ من فِعل الله - عزّ وجلّ -، متى لم يعلمها العالِم لم يلحقه عيب، ولا عرض في توحيده نقص«(13).
إنّما «سأل عن الكيفية، والكيفيةُ من فِعل الله - عزّ وجلّ -، متى لم يعلمها العالِم لم يلحقه عيب، ولا عرض في توحيده نقص«(13).
فهذه الرواية الثمينة توضِّح أنّ سؤال إبراهيم كان عن كيفية إحياء الله للموتى (الطريقة)، فهو لا يسأل هل الله قادر على ذلك الفعل أم لا (القدرة)؟، وإنّما يسأل عن (الطريقة) التي يتمّ بها الفعل، وهذا لا يستلزم شكًا ولا ضعف إيمان لديه، فسؤاله ليس عن أصل إمكان إحياء الموتى، فذاك لا يليق بنبي، ولو كان لجاء السؤال بـ (هل): (أرني هل تحيي الموتى؟) وليس بـ (كيف).
والثانية: مروية عن الإمام الرضا  : «أنّ الله - تبارك وتعالى - كان أوحى إلى إبراهيم - عليه السلام - أنِّي متخذ من عبادي خليلًا إن سألني إحياء الموتى أجبته، فوقع في نفس إبراهيم - عليه السلام - أنّه ذلك الخليل، فقال: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) على الخِلة، (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) «(14).
: «أنّ الله - تبارك وتعالى - كان أوحى إلى إبراهيم - عليه السلام - أنِّي متخذ من عبادي خليلًا إن سألني إحياء الموتى أجبته، فوقع في نفس إبراهيم - عليه السلام - أنّه ذلك الخليل، فقال: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) على الخِلة، (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) «(14).
وهذه الرواية تبيّن أنّ فلسفة القصة هي لكي يتيقن النبي إبراهيم ويطمئن قلبه أنّه ذاك الخليل المقصود، وذاك عبر تقدّمه بطلب تحقيق السبيل الذي ذكره الله له لمعرفة ذلك، وتذكر (ظرفًا) خارجيًا للقصة هو ما أوحى الله به له عن ذلك الخليل من إجابة دعوته في إحياء الموتى، فهذا الظرف الخارجي - في هذه الرواية - هو الذي خلق في إبراهيم الرغبة في التقدم بذاك السؤال ليعرف أهو المقصود أم غيره.
والثالثة: مروية عن الإمام الصادق  أنّ النبي إبراهيم
أنّ النبي إبراهيم  «التفت فرأى جيفة على ساحل، بعضها في الماء، وبعضها في البرّ، تجيء سباع البحر فتأكل منها، فيشدّ بعضها على بعض، ويأكل بعضها بعضًا، فعند ذلك تعجب مما رأى، وقال: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى)، قال: كيف تُخرِجُ ما تناسخ، هذه أمم أكل بعضها بعضًا، (قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) « (15).
«التفت فرأى جيفة على ساحل، بعضها في الماء، وبعضها في البرّ، تجيء سباع البحر فتأكل منها، فيشدّ بعضها على بعض، ويأكل بعضها بعضًا، فعند ذلك تعجب مما رأى، وقال: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى)، قال: كيف تُخرِجُ ما تناسخ، هذه أمم أكل بعضها بعضًا، (قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) « (15).
وهذه الرواية تذكر (ظرفًا) خارجيًا آخر للقصة، وتمثّل حدثًا موضوعيًا حصل، ووقعت القصة في إطاره، وهي بدورها خلقت (فلسفة) داخلية لدى إبراهيم: أن يعرف كيف يعيد الله الأجساد وقد أكل بعضها بعضًا، ونمى بعضها على بعض في ظلّ (دورة الحياة)، فتداخلت!!، فيما يُعرف بـ (شبهة الآكل والمأكول).
3ـ اللغة العربية:
فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (15)، والإلمام باللغة العربية على المستوى الدلالي والنحوي والصرفي والبلاغي والأسلوبي وغير ذلك تعين المتدبّر في بلوغ المعنى والوصول إليه، وتساعده في استخراج الدرر من محيط القرآن العظيم، ومن دونها قد لا نفهم بعض المرادات القرآنية.
فمن يعرف دلالة الكلمات ومعانيها، ويعرف النحو العربي ومواقع الكلمات من الإعراب، ويعرف الصرف ومعنى التصغير ودلالة اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة، ويعرف البلاغة ومفاد الجملة الاسمية والجملة الفعلية والتقديم والتأخير والتنكير والتعريف والقصر، ويسبر الأسلوب القرآني الفريد، واتكاءه على الحركة والتصوير والحديث عن غير العاقل بأسلوب العاقل، وغير ذلك، سيعينه محصوله اللغوي الثرّ في سبر آيات الكتاب العزيز، والحفر عمقًا في منجمه لاستخراج شيء من معادنه النفيسة.
ولا نريد من هذا تعقيد عملية التدبّر، بمقدار ما نخبر عن حقيقة وصفية هي أثر ذلك الاطلاع في عملية التدبّر، ومن ثم ضرورة زيادة المخزون اللغوي؛ ليساعدنا في التدبّر.
ولأنّ اللغة العربية تحوي علومًا مختلفة: دلالية، ونحوية، وصرفية، وبلاغية، وأسلوبية، وغيرها، أحببنا عرض خمسة نماذج مختلفة المشرب؛ لبيان أثر اللغة في التدبّر القرآني:
أـ مثال دلالي (معجمي):
معاجم اللغة العربية حملت معاني ألفاظ الكلمات وأساليبها التأسيسية (أي المفردات والتراكيب)، وعندما يعسر علينا معرفة لفظ قرآني نستطيع الرجوع إلى تلك المعاجم لمعرفته.
يقول الله تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) (16).
هل ترانا نستطيع التدبّر في هذه الآية الشريفة إذا لم نعرف معنى كلمة (لينة)؟!
بالطبع: كلا..
فماذا تعني هذه الكلمة؟!
حينما نعود إلى كتب المعاجم نجد أنّ اللينة هي: «كلّ شيء من النخل سوى العجوة«(17).
ب ـ مثال نحوي:
يهتم النحو العربي بإعراب الكلمات والجمل، ومعرفة المواقع والعلامات التي تظهر على آخر الكلمات (البناء والإعراب)، (الحروف والحركات)، ويؤثر الإعراب كثيرًا على المعنى، وقد نقف عند آيات قرآنية يهدينا النحو لمعناها، ولو ضيّعنا الإعراب النحوي لاختلف المعنى.
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (18).
لعلّ من لا يعرف أنّ إعراب لفظ الجلالة (اللهَ) ـ هنا ـ هو: مفعول به مقدم؛ يعتقد أنّ الله يخاف من العلماء ويخشاهم!!، أو على الأقلّ: يستغرب من هكذا مفهوم، بينما من يعرف ذلك، ويعرف أنّ كلمة (العلماءُ) في الآية هي الفاعل المؤخر، وأنّ المفعول به قدّم لأمر بلاغي هو إفادة الاختصاص والحصر، وأنّ أصل التركيب هو: (إنّما يخشى العلماءُ اللهَ)؛ سيتضح المعنى بشكل جليّ لديه.
ج ـ مثال صرفي:
والصرف يهتم بالتغييرات التي تحصل في البنية الداخلية للكلمة، ويؤثر في معناها، ومن ثمّ نستفيد منه لمعرفة المعاني القرآنية.
فدلالة اسم الفاعل تختلف عن دلالة اسم المفعول، وهما مختلفتان عن دلالة صيغ المبالغة والصفة المشبهة، ودلالة التكبير تختلف عن دلالة التصغير، ومعانى جموع القلة تختلف عن معاني جموع الكثرة وصيغ منتهى الجموع، ودلالة البناء للمعلوم تختلف عن دلالة المبني للمجهول، وهكذا..
يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (19).
وقف البعض عند قوله تعالى: (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ)، وقرأها (فيَقتلون ويَقتلون) ـ كلتاهما بالبناء للمعلوم ـ، وفهم منها أنّ المؤمنين كثيرو القتل لغيرهم؛ إما لشجاعتهم في الحرب، وإما لأنّهم عطشون نهمون إلى شرب الدم، واتهم الإسلام بأنّه دموي عنيف يلتذّ بمنظر الدم، ويحثّ أتباعه على إراقة سيول الدماء القانية!!، وقال: (الإسلام انتشر بحدّ السيف).
وهو فهم خاطئ؛ لأنّ الحركات الصرفية للكلمتين مختلفة: فالأولى مبنية للمعلوم (يَقتلون)، والثانية مبنية للمجهول (ويُقتلون)، والمعنى أنّهم يخوضون الحرب في سبيل الله فيَقتلون في العدو، وينالون الشهادة (يُقتلون)، يجري لهم القتل كما يجري عليهم، وتلك سنة الحرب.
وقد رأينا كيف أنّ الاستعانة بالحركات الصرفية سهّل لنا الوصول إلى معرفة المعنى الصحيح، وطرد المعنى السقيم.
د ـ مثال بلاغي:
القرآن كلام بليغ، وهو أعظم كتاب بلاغي عرفته العربية، بل أعظم كتاب بلاغي عرفته البشرية عمومًا، وقد حاكى الأساليب العربية في البلاغة (المعاني، والبيان، والبديع)، وتفوق عليها جميعًا، ولفهم بعض أساليبه لابدّ من التعرف على الأساليب البلاغية التي حاكاها.
يقول القرآن الكريم: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) (20).
لقد اتخذ البعض من هذه الآية منطلقًا لاتهام النبي يوسف  بالسعي إلى الفاحشة، أو على الأقلّ بتحرّك نوازعه وغرائزه الداخلية نحوها، وأنّه عرته لحظة ضعف إنساني كتلك التي تعتري غيره من البشر؛ متكئًا على جملتي: )هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا(، فما دام همُّها به معروف المعنى، فهمّه بها له المعنى ذاته؛ لوقوعهما في سياق واحد متجاور!!
بالسعي إلى الفاحشة، أو على الأقلّ بتحرّك نوازعه وغرائزه الداخلية نحوها، وأنّه عرته لحظة ضعف إنساني كتلك التي تعتري غيره من البشر؛ متكئًا على جملتي: )هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا(، فما دام همُّها به معروف المعنى، فهمّه بها له المعنى ذاته؛ لوقوعهما في سياق واحد متجاور!!
ورفضوا أن يكون المعنى: همّ أن يبعدها عنه، أو همّ أن يهرب منها، مع أنّ من أساليب البلاغة العربية الشائعة «أن يُذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته«( )، أي إطلاق الكلمة على معناها وعلى معنى آخر مغاير جاء في سياقها، ويُسمّى هذا الفنّ البلاغي بـ (المشاكلة)، ومع أنّ القرآن الكريم قد استخدم هذا الأسلوب البلاغي في العديد من آياته، فقال:
- (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (21).
- (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) (22).
- (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (23).
- (وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ) (24).
- (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (25).
وأسلوب المشاكلة جار حتى في المحاورات العرفية البسيطة، فلو قال شخص لصديقه الجائع الذي تمزّق ثوبه: (هل أخيط ثوبك؟)، فقد يرد على البديهة: (بل.. خيّط لي طعامًا!!)، أي اطبخ، وطبخ الطعام لا يُسمى تخييطًا، لكنّه لوقوعه في سياق الكلام عن خياطة الثوب، يصحّ تسميته تخييطًا.
ولو قال لنا شخص: (أنا ماض لتخييط ثوبي)، ثم ذهب شخص إليه في الغرفة، فوجده يأكل طعامًا وفيرًا بنهم، وسألنا هذا الآخر: (ما يصنع فلان؟، أهو جالس يخيط ثوبه؟)، فقد يقول: (بل جالس يخيط الأكل!!)، (أي يأكل).
والمقصود من الآيات السابقة: يمكرون ويرد الله مكرهم، ويخادعون الله ويرد الله خداعهم، ونسوا الله فأهملهم، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك، ومن اعتدى عليكم فردوا عليه. والمكر حيلة اللئام، والله ليس ماكرًا ولا خدّاعًا، ولا ينسى، وليست له نفس، ولا يطلب من المؤمنين أن يعتدوا، ورد العدوان ليس عدوانًا، بل.. هو حقّ مشروع، لكنّها أمور سُمّيت بأسماء مجاوراتها؛ لوقوعها في سياقها، فهي تسمية للشيء باسم مجاوره.
هـ ـ مثال أسلوبي:
شاعت في القرآن الكريم أساليب فريدة لم تجتمع من قبل في كلام واحد بهذا المستوى من البهاء والقوة، مثل:
ـ الحديث عن المستقبل بأسلوب الماضي.
ـ الحديث عن غير العاقل بأسلوب العاقل.
ـ التصوير الفنّي.
وسوف نتناولها مع أساليب أخرى في خطوة (الشكل الخارجي).
4ـ كتب علوم القرآن:
ونقصد بها الكتب التي تتحدث عن ملابسات النصّ القرآني وفهمه، أي الأمور التي تدور (حول) النصّ، كالكتب التي تتكلم عن الناسخ والمنسوخ، والمتشابه والمحكم، والخاصّ والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل، والمكي والمدني، و....
ومن أبرز هذه الكتب:
أـ البرهان في علوم القرآن، للزركشي.
ب ـ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي.
ج ـ علوم القرآن، لمناع القطان.
فقد نقرأ قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ( 26).
فيتضح جليًا لنا وجوب دفع الصدقة لمن يريد أن يناجي الرسول  ، ولكن حينما نقرأ الآيات التي تتبع هذه الآية مباشرة - من السورة نفسها - نجد قوله تعالى:
، ولكن حينما نقرأ الآيات التي تتبع هذه الآية مباشرة - من السورة نفسها - نجد قوله تعالى:
(أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( (27)، فنستنتج جواز مناجاة الرسول  دون دفع صدقة.
دون دفع صدقة.
وعند الرجوع إلى كتب الحديث وعلوم القرآن نجد أنّ الآية الثانية جاءت ناسخة لحكم الآية الأولى.
يقول أبو بصير: سألتُ الإمامَ الصادقَ  عن قول الله - عزّ وجلّ -: )إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً(، فقال
عن قول الله - عزّ وجلّ -: )إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً(، فقال  : «قدّم علي بن أبي طالب بين يدي نجواه صدقة، ثمّ نسختها: (أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) «(28).
: «قدّم علي بن أبي طالب بين يدي نجواه صدقة، ثمّ نسختها: (أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) «(28).
5ـ كتب التفسير:
بعض كتب التفسير اشتملت على تأملات قرآنية عميقة ودقيقة ورائعة، وعند قراءتها قد تعيننا في عملية التدبّر في القرآن المجيد.
وقد اختلفت أنواع التفسير ومناهجه حسب اهتمامات المفسّرين، فركز بعضها على التفسير بالمأثور (التفسير النقلي/ الروائي/ الأثري)، وبعضها ركز على معاني الكلمات وبلاغة الأسلوب (التفسير اللغوي والبلاغي)، وبعضها اصطبغ بلون عقدي، أو فقهي، أو علمي، أو فلسفي، أو صوفي وعرفاني وإشاري، أو تاريخي، أو عقلي اجتماعي حركي، أو غير ذلك..
وقد نحتاج ـ أحيانًا ـ إلى الاستعانة ببعض التفاسير لتذليل عملية التدبّر في القرآن الكريم، ومن بين التفاسير الإسلامية التي يمكن مراجعتها:
أـ (تفسير البيان الجامع لعلوم القرآن)، للشيخ محمد بن الحسن الطوسي.
ب ـ (مجمع البيان في تفسير القرآن)، للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي.
ج ـ (مفاتيح الغيب)، لفخر الدين الرازي.
د ـ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)، للشيخ محمود الألوسي.
هـ ـ (في ظلال القرآن)، لسيّد قطب.
و ـ (الميزان في تفسير القرآن)، للسيّد محمد حسين الطباطبائي.
ز ـ (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل)، للشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
ح ـ (من هدى القرآن)، للسيّد محمد تقي المدرسي.
ط ـ (المنير)، للشيخ وهبة الزحيلي.
وينبغي ـ هنا ـ أن ننبّه إلى أمر هام جدًا هو: أنّ عملية التدبّر قد تستفيد من التفاسير، ولكن.. ليس من الصحيح أن نقبل كلّ ما ورد في التفاسير، وننقله في تدبّرنا، ليضحي تدبّرنا مجرّد نسخ وتسجيل لما قاله الآخرون، ومن ثمّ نعطّل عقولنا، ونغفل دورها في عملية الاكتشاف والاستخراج والتأمل الذاتي المباشر في القرآن الكريم، ونحكم عليها بالشلل والموت.
وفي الوقت الذي يمكن أن نستفيد من كتب التفسير لا ينبغي أن نجعلها سقفًا يشلّ قدرتنا التدبّرية والتأملية عن الانطلاق إلى الأفق الأرحب، كما لا ينبغي أن نعدّها مقدّسًا نتبنى كلّ ما ورد فيه، و(نستنسخ) أفكاره.
6ـ الثقافة العامة:
مقدار ثقافة المتدبّر يؤثر في مدى تدبّره وسعة نتائجه ودقتها، فكلّما علت ثقافته استطاع أن يجتني من الزهر القرآني أكثر، فمعطيات تدبّر الإنسان على قدر ثقافته؛ ومن ثمّ فثقافة الإنسان العامة سواء أعادت إلى حقل العلوم الدينية، أم حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، أم حقل العلوم الطبيعية والتجريبية، أم غيرها..؛ تشكل كاشفًا يمكن أن يساعدنا في فهم المعاني القرآنية.
وقد يقف شخصان مختلفا الثقافة عند آية واحدة، فلا يعدو أحدهما الوقوف على ساحل البحر، ويصطاد معنى سطحيًا بسيطًا، بينما يغوص الثاني إلى أعماق الأعماق، ويستخرج أحلى الجواهر والمرجان، وأغلى اللآلئ والدرر.
يقول الله تعالى: (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) (28).
فمن كرم الله أنّه أنزل الغيث من المزن على الجميع بمستوى واحد، لكنّ كلّ شخص يستجمع منه بمقدار إنائه، كما يحمل كلّ وادي ما يناسب عمقه ومساحته، وتستقي كلّ أرض بمقدار قابليتها واستعدادها.
فقد يقرأ شخصان قوله ـ تبارك وتعالى ـ: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (29)؛ فلا يفهم أولهما من قوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ) سوى تشبيه الضالّ بمن يصّعّد في السماء؛ لبيان حالة الضيق الذي يسكنه ويخيّم عليه، وهو تفسير معنوي رائع فتان.
بينما يفهم ثانيهما إضافة إلى ذلك حقيقة علمية وجودية كونية سبق القرآنُ العلمَ الحديثَ إليها، وهي أنّه كلّما صعد الإنسان إلى الأعالي (فوق مستوى سطح البحر) قلّ عنده الهواء والضغط، وقلة الهواء والضغط تؤديان إلى ضيق الصدر؛ لأنّ تقلص الهواء في الرئتين يؤدي إلى انقباض الصدر، كما يقلّ عنده الوزن ودرجة الحرارة، وهو تفسير معنوي وحسي في آن واحد، استفاد من المنجز البشري في الحقل العلمي، وهو تفسير أعلى هامة وشأوًا من التفسير الأول.
وقد يقرأ شخصان سورة التوحيد: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (30).
فيعرف أحدهما أنّها تتكلم ـ إجمالًا ـ عن التوحيد، وتثبت وحدانية الله، وعدم وجود الشريك والمكافئ لله والابن لله.
ويقرؤها شخص آخر: فيقف على الفرق بين (الأحدية) و(الواحدية)، وأنّ قوله تعالى: )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( يتكلم عن (الأحدية) التي هي البساطة وعدم التركيب الحسي والعقلي والتخيلي (الوهم)، بينما الآية الأخيرة )وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ( تتكلم عن التوحيد الذي هو نفي الشريك والشبيه والمثيل، وهما مفهومان مختلفان، ويقف عند الآيات الشريفة بوصفها تحمل ثلاثة براهين جلية على وحدانية الله هي:
أـ انتفاء الأب والسابق: (وَلَمْ يُولَدْ)، فلا إله قبله.
ب ـ انتفاء الابن والوريث واللاحق: (لَمْ يَلِد)، فلا إله بعده.
ج ـ انتفاء المكافئ والندّ: (وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)، فلا إله معه.
وإذا انتفى أن يكون لله ـ جلّ وعلا ـ إله سابق أو لاحق أو مزامن، فقد ثبت التوحيد المطلق.
ومن أهمّ صفات هذا الواحد الأحد أنّه الصمد (السيّد الذي يُقصد في الحاجات، ويُلجأ إليه في الملمات).