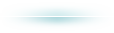مستويات ثلاث في نصرة القرآن (1/3)
في فتراتٍ زمنيةٍ متساوية، يقومُ متطرِّفٌ غربي، ملحداً كان أو مسيحياً أو يهودياً، باستفزاز المسلمين عبر التعدّي على مقدَّسٍ من مقدساتهم، وسواء كان ذلك لحُبِّ الظهور، أو كان بايعازٍ من حكوماتها لالهاءِ الشعوب عن قضايا أكبر، أو كان تغذيةً لخطاب الكراهية المنتشر في تلك البلاد تجاه المسلمين..
إلا أن النتيجة واحدة، واللوم يقع على الحكومات والأنظمة الغربية التي تحتضن هؤلاء وتوفِّر لهم الحماية الأمنية والفكرية والإعلامية.
وكان آخرها ما قام به متطرِّفٌ ملحد في (السويد) بحرق نُسخَةٍ من كتاب الله عزوَّجل.
وقد شاهدنا ردود الأفعال المشكورة التي كان للشعب العراقي قَصَبُ السبق في ذلك ولله الحمد.
ولكن: هل أن نُصرةَ القرآن مقتَصِرةٌ على ذلك؟
بل: هل أن النبي المصطفى  حين يقف أمام الربِّ يومَ الجزاء، هل يشكو أعداءَه حين هجروا القرآن أم يشكو قومه؟ نعم، إنَّه يقول (إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) .
حين يقف أمام الربِّ يومَ الجزاء، هل يشكو أعداءَه حين هجروا القرآن أم يشكو قومه؟ نعم، إنَّه يقول (إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) .
فالحديث عن هُجرانِ القوم، وعن ظُلامَتِه يقع في مستوياتٍ ثلاث، وبالتالي، الحديث عن نُصرَته، يقع في قبال تلك المستويات، وفي هذه السطور سأحاول تبيينها، ليكون ذلك مقدَّمةً للتقرب الى كتاب الله، ولبيان مسؤولياتنا تجاهه.
- المستوى الأول: البُعدِ الشخصي
السؤال المهم: كم يحتل القرآن من مساحةٍ في حياتنا؟
لا أقصد نسبةً رياضية تحصل من حاصل قسمة مجموع الدقائق التي يقضيها الفرد مع القرآن تلاوةً وحفظاً وتجويداً، على 1440 أي عدد دقائق اليوم الواحد، فليس هذا هو الأهم – وإن كان مهماً كمقدمةٍ كما سيذكر بعد قليل-
فرُبَّ فلّاحٍ بسيط، أو تلميذ مدرسةٍ نائية، أقرب الى القرآن من قارئ مشهورٍ يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار.. متى؟ حين يكون فكر الفلّاح وثقافته، وأسلوب حياته، قرآنياً.
فإذا كانت العَلمانية تعني تقليص مساحة الدين في حياة الإنسان وصولاً إلى حذفه، فإن كثيراً منا يُمارِسها من حيث لا يشعر، كيف؟ حين يقتصر أمرُ الله وأحكامه وشريعته على علاقةٍ روحية بينه وبين ربِّه ويحاول أن يحصر الدين بين جدران المسجد دون أن يكون له شأن في الحياة العامة – وهذا سأتحدث عنه في المستوى الثالث-
وفي قبال ذلك، يأتي (تقديس القرآن). أي الاعتقاد به كتاباً مقدَّساً، منزَّهاً عن أي خطأ أو عِوَج، وأن ما فيه حقُّ وحقيقة لا يتغيَّر بتقادم الزمان، ولو تقدَّمت البشرية ألف مليون عام، واستعمرت آخر مجرةٍ في هذا الفضاء الواسع، يبقى القرآن وفكره ومنهجه، هو الحق، لماذا؟ لأنَّه من الله تعالى، المتعالي عن الزمان والمكان.
وهذه الفكرة مع بساطتها إلا أنها تقع في جوهر (نُصرة القرآن)، فلا ينصر القرآن من يراه كتاباً كسائر الكتب، ولا ينفعه حين ذلك نصر القرآن أم لم ينصره.
ثُمَّ: كم نصرف يومياً من الأوقات مع كتابِ ربِّنا؟
كم نقرأه يومياً؟ كم نحفظ من سورَهِ؟ من آياته؟ كم انعجنت تلك الآيات مع شخصياتنا فسَبَكَت قوالِبَ تفكيرنا، وتحولَّت إلى بصيرةٍ ننظر إلى العالَم من خلالها؟
هذا هو السؤال المهم.
فالوظيفة الأولى في نُصرة القرآن: هي العودة إليه.
العودة إلى آياته، وتلاوتها بصورة يومية، طلباً للثواب والبركة، وروماً لتطبيقها لاحقاً، والأهم لبناء الشخصية القرآنية التي يكون القرآن هويَّتها وثقافتها.
وقد وفّقني الله في الكتابة تفصيلاً عن ذلك، في كتابي (الشباب وأزمة الهويَّة / الفصل الثالث) فيمكن مراجعته هناك.
فالخطوة الأولى: وضع برنامج يومي لقراءة القرآن وتلاوته، والأنس بآياته، وكتجربةٍ عملية، أن يكون ذلك بعد كُلِّ صلاة، ولو بمقدار (عشرة دقائق).. وهل يعجز الإنسان أن يخصص هذا الوقت القليل للمعجزة الإلهية الخالدة؟
عن الإمام الصادق  : ما يمنع التّاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتّى يقرأ سورةً من القرآن فتكتب له مكان كلّ آيةٍ يقرؤها عشر حسناتٍ و يمحى عنه عشر سيّئاتٍ
: ما يمنع التّاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتّى يقرأ سورةً من القرآن فتكتب له مكان كلّ آيةٍ يقرؤها عشر حسناتٍ و يمحى عنه عشر سيّئاتٍ
ولكن هل يكفي قراءته دون تأمل وتدبر؟ كلا.
بل يأتي دور إعمال الفكر، والتأمل في كتاب الله عزوَّجل، والتدبُّر في آياته.
قد تقول: وفق أي منهج؟ وكيف أتأكَّد من سلامة تلك التأملات؟ وكيف لا أقع في التفسير بالرأي؟
فأقول: إنَّ المنهج السليم شرطٌ للتدبر في كتاب الله، ولذا، فمن الضروري بذل الوقت والجهد في التعرُّف عليه للنهل من آيات القرآن الكريم، وقد كان لي دورةً مبسَّطة للتدبر يمكن لمن وجدها نافعة الاستفادة منها.
وقد تقول: لا أفهم بعض آياته، ففيها المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ و..
أقول: نعم، ولكن قد سبقك إلى بيان معاني تلك الآيات، علماءٌ فضلاء، صرفوا خيرة أعمارهم في تفسير آياته، بعد أن تشبَّعوا بروايات أهلِ الذكر، النبي وأهل بيته  .. فعليكَ إن وُفِّقتَ أن تعزم على قراءة تفسيرٍ كاملٍ للقرآن، أو أكثر، فتزداد معرفةً بكتاب ربِّك.
.. فعليكَ إن وُفِّقتَ أن تعزم على قراءة تفسيرٍ كاملٍ للقرآن، أو أكثر، فتزداد معرفةً بكتاب ربِّك.
ثم ماذا؟
على المستوى الشخصي: دعوة الآخرين إلى القرآن، وإلى حفظه، والتدبر في آياته.
على المستوى الاجتماعي والحضاري: للحديث تتمة.