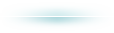المعرفة الدينية: تكليف لا تشريف
قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.(122) سورة التوبة
جرت العادة عند قرّاء هذه الآية المباركة على توجيهها إلى فئة مخصوصة من أبناء المجتمع، وهم من يتوجه إليهم الخطاب الإلزامي بطلب العلم والتفقه في شؤون الشريعة، وكأنها تتحدث بلسان الوجوب الكفائي…
بمعنى أنها تضع التعرف على مفاهيم الشريعة الإسلامية في مصاف الواجبات الكفائية التي إن قام بها البعض من أبناء المجتمع سقطت عن البعض الآخر، حتى لو كان هذا البعض الآخر يفوق الأول بما لا يقاس من الأضعاف.
فتكون نتيجة الآية على ضوء هذا التوجيه اختصاص التفقه في شؤون الشريعة والتعرف على مفاهيم الدين بفئة محدودة من أبناء المجتمع الإسلامي.
بينما لو نكثر من التأمل في الآية نكتشف أنها تتحدث بلسان الوجوب العيني في هذا الخصوص، بالمستوى الذي يتوافق مع ما ورد في الثر عن رسولنا الأكرم محمد  : "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
وإنما يتضح ذلك من عجز الآية في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.. إذ تراكم عدة من الظروف الزمانية والمكانية لمجتمع ما قد يمنع من تفرّغ الجميع بالمستوى الكلي للتفرغ، وإنما يسمح باختصاص فئة بذلك.. لكن هذا الاختصاص لا يرفع الإلزام عن سائر أبناء المجتمع، وإنما يجب عليهم عيناً أن يتعرفوا على المفاهيم والأحكام الضرورية التي تمنحهم القدرة على تأدية الفرائض الدينية على وجهها الصحيح، وهذا هو تمام مفاده قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.. وذلك أن الحذر -وهو ما يراد في الالتزام بقيم الدين- لا يمكن أن يتسنى لأحد لولا العلم، وما استطاع إنسان أن يحذر إلا لأنه عالم بما يحذر.
فلأن كافة أبناء المجتمع مكلفون بصورة عينية بالامتثال لأوامر اللَّه سبحانه وتعالى ونواهيه، كان لابد أن يعرفوا حقيقة تلك الأوامر والنواهي، ولهذا فإن طلب العلم الديني في حده الأدنى الذي يمكّن الإنسان من الامتثال واجب عيني لا كفائي.. نعم ما يتعلق به الوجود الكفائي إنما هو التخصص.
من كل ذلك يتضح لنا أن الآية توجه الخطاب لكافة أبناء المجتمع، بأن يتعلموا ويتعرفوا على مفاهيم الدين، كي يستطيعوا أن يتمثلوا أوامر اللَّه سبحانه وتعالى.
ولكنها أيضاً من جهة أخرى تنهى عن العبث بقيم الدين والتعامل العفوي مع أحكامه، حيث إنها ركزت في صدرت الآية على ضرورة التخصص ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾.
فإذا كان المسلمون بأجمعهم لا يتأتى لهم النفور والتفرغ الكلي، فإن على جماعة مختصرة القيام بذلك ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ﴾.
فمع أن مصادر التشريع كانت متأتية للجميع في العصر الإسلامي الأول، وبالذات عند نزول هذه الآية المباركة وقريبة من الجميع، ومع أن الثقافة الشرعية في ذلك العصر كانت بسيطة وغير معقدة، بحيث لم تكن ثمة مؤونة على الراغب في التعلم كما هو الحال في مثل عصرنا، لكن مع ذلك وجهت الآية الخطاب إلى المسلمين بضرورة التخصص حتى يتسنى لهم ضبط معارف الدين ضبطاً دقيقاً ليستطيعوا ممارسة دور التوجيه والبت في الشؤون الشرعية وتصحيح تصرفات وتصورات غير المختصين من أبناء مجتمعاتهم.
ولهذا نجد عدة من المسلمين نبغوا في ذلك وأُوكل إليهم أمر الإرشاد، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي  ، الذي وصل به الأمر أنه كان ينفرد برسول اللَّه
، الذي وصل به الأمر أنه كان ينفرد برسول اللَّه  أوقاتاً طويلة، يفتح له فيها الرسول
أوقاتاً طويلة، يفتح له فيها الرسول  أبواباً من العلم لم تتسن لغيره، حتى قال فيه الرسول
أبواباً من العلم لم تتسن لغيره، حتى قال فيه الرسول  : "علي من الحق والحق مع علي".
: "علي من الحق والحق مع علي".
كما نشأت طبقات متخصصة في وسط المسلمين في بعض النواحي العلمية، كطبقة القرّاء الذين يشكلون النموذج الأمثل لمثقف ذلك العصر، وطبقة المحدثين الذين برعوا في حفظ ونقل الأحاديث.. وكل أولئك على مستوى من المعرفة بشؤون الدين ما أهلهم لممارسة دور تربوي وتوجيهي كبير.. أما غيرهم ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالتخصص فكانوا على حذر شديد من أن يتقولوا في الشريعة.
لهذا تكونت في وسط المسلمين سيرة كانت تعطي المتخصص في شؤون الدين الحق في الإفتاء والاعتراض العلمي، أما غيره فلا، لأنه لا يتقن استخدام أدوات ذلك العلم وليس محيطاً بكل تفرعاته.
وفي ذلك إشارة إلى أن الدين لم يأذن لأتباعه بالعبث في أحكامه وقيمه، بدءاً من رسول اللَّه  الذي أنزل في شأنه الباري عز وجل قوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ، وانتهاء بأبسط إنسان ينتسب إلى هذا الدين.
الذي أنزل في شأنه الباري عز وجل قوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ، وانتهاء بأبسط إنسان ينتسب إلى هذا الدين.
والعبث إنما هو الرفض والقبول على غير دراية علمية، بل بناء على استحسانات سطحية وسريعة جداً.
وهذا النوع من المنهج في التعاطي مع قيم الدين وأحكامه مرفوض في الشريعة، لأنه ضرب من ضروب التقوّل على اللَّه عز وجل، ومن هذا المنطلق نجد أن أئمة أهل البيت  أوصوا أتباعهم بالحذر الشديد قبال كل ما له صلة بالدين، فإذا ورد إليهم أمر من ذلك وفهموه فبها وإلا ردوه إليهم
أوصوا أتباعهم بالحذر الشديد قبال كل ما له صلة بالدين، فإذا ورد إليهم أمر من ذلك وفهموه فبها وإلا ردوه إليهم  ، أما رفضه فلا يسوّغ لهم.
، أما رفضه فلا يسوّغ لهم.
فقد ورد في الكافي بإسناده إلى الإمام الباقر  قال: قال رسول اللَّه
قال: قال رسول اللَّه  : "إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به غلا ملك مقرب أو نبي امتحن اللَّه قلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى اللَّه وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد
: "إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به غلا ملك مقرب أو نبي امتحن اللَّه قلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى اللَّه وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد  ، وإنما الهالك أن يحدِّث أحدكم بشيء من لا يحتمله فيقول واللَّه ما كان هذا والإنكار هو الكفر".
، وإنما الهالك أن يحدِّث أحدكم بشيء من لا يحتمله فيقول واللَّه ما كان هذا والإنكار هو الكفر".
فهذه الرواية تبين لنا كيف أن الأئمة  كانوا يشددون على رفض المنهج الذوقي الذي قوامه الأساسي الاستحسان العقلي السريع، ويضعون بذلك منهجاً لشيعتهم في كيفية التعاطي مع الأفكار الدينية.
كانوا يشددون على رفض المنهج الذوقي الذي قوامه الأساسي الاستحسان العقلي السريع، ويضعون بذلك منهجاً لشيعتهم في كيفية التعاطي مع الأفكار الدينية.
وإنما يشدد الأئمة  على ذلك، لما تنطوي عليه تلك الأفكار من أثر مصيري خطير، وبالتالي فإن نتيجة الالتزام بها وعدمه ثواب أو عقاب، لأن تلك الأفكار إما عبادات والعبادات في الشريعة توقيفية لا يجوز التصرف فيها، أو مواقف خاصة لا يسع الإنسان المؤمن إلا التعبد بها.
على ذلك، لما تنطوي عليه تلك الأفكار من أثر مصيري خطير، وبالتالي فإن نتيجة الالتزام بها وعدمه ثواب أو عقاب، لأن تلك الأفكار إما عبادات والعبادات في الشريعة توقيفية لا يجوز التصرف فيها، أو مواقف خاصة لا يسع الإنسان المؤمن إلا التعبد بها.
والعبث في العبادات والمواقف تجرؤ على اللَّه سبحانه وتعالى.. وقد حذّر الأئمة  العديد من ذوي الوجاهة الدينية والاجتماعية في ذلك العصر من خطر التصرف بالقيم بغير دراية كافية.
العديد من ذوي الوجاهة الدينية والاجتماعية في ذلك العصر من خطر التصرف بالقيم بغير دراية كافية.
قد جاء في رواية زيد الشحّام قال: دخل قتادة على أبي جعفر  فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال
فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال  : بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم… إلى أن قال
: بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم… إلى أن قال  : يا قتادة إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يا قتادة ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به".
: يا قتادة إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يا قتادة ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به".
فالحذر في التعاطي مع أفكار الدين مطلوب، وهذا ما حدا بأغلب فقهاء المسلمين سنة وشيعة إلى انتهاج الاحتياط في كثير من فتاواهم الشرعية، وعدم تخطي قول المشهور إلا في حالات خاصة وبحذر شديد.. حتى عدّ البعض من النقاد هذا المنهج نوعاً من الجبن الذي يلازم الفقيه، بينما هو في الحقيقة ورع وتحذر من العبث في قيم الدين.
إذاً من خلال هاتين المقدمتين -شمول الخطاب الإلزامي في الآية إلى كل أبناء المجتمع، ونهي الآية عن العبث بالقيم استناداً إلى بعض الاستحسانات الذوقية- نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الإنسان المتدين لا ينبغي له الخوض في قضايا الدين بلا بصيرة، وإنما يجب عليه التثبت والحذر، ولا يتسنى له ذلك إلا بالتعلم إما على نحو التخصص وهو الأفضل، وإما باعتماده الحد الأدنى الذي يمكّنه من تأدية الواجبات العبادية والمعاملاتية على وجهها الصحيح.