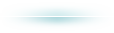فقرنا المعنوي في صوامع الله
للأسف الشديد فإن مؤسستنا المعول عليها التي هي أعظم قبة انطلاق لمشروع العمل الإسلامي سواء من حيث الدولة أو المجتمع أو الاقتصاد أو السياسة و هي المسجد مريضة بانقلاب في المبادئ لما صار المسجد بدلا من نواة تفيض وعيا و إيمانا و إخلاصا مكانا لتلميع شخصية بعض مرتاديه أو مكانا لاستعراض القبيلة و العائلة أو استعراض الذات أو قتل الوقت و تحول من مكان يشير إلى الله إلى مكان يشير مجملا إلى الدنيا و لكن بتغليف أخروي...
المسجد هو أكبر و أعظم مؤسسة تأثيرية انطلق منها نبي الأخلاق و الفضيلة محمد  ليؤثر من خلاله على القلوب المتحجرة القاسية المستعصية الصلدة و على الأنفاس الإجرامية الصحراوية المشركة، و علينا أن نقر بأن النبي الأكرم استطاع من خلال المسجد أن يصنع إيمانا لا تهزه الرياح العواصف و استطاع من المسجد أن يقود دولة إسلامية فتية نحو الصعود للكمالات الروحية و الأخلاقية و الفكرية و الإيمانية المتجلية أبسطها في معارك بدر و الخندق و غيرها و التي مثلت بذل الإنسان و تضحيته بنفسه في سبيل المبدأ الذي وضع دستوره خالق الحياة لا لأجل شيء غير حب الله سبحانه و تعالى، بحيث ضحى المسلمون الأوائل بأرواحهم مع قلة العتاد و العدد في معارك غير متكافئة و غير محتملة الغنائم إلا بنسب ضئيلة...هكذا كان المسجد هو مصنع الإيمان و التضحية و البذل الذي لا يترجم إلا عن بعد معنوي داخلي بناه معلم مؤثر داخل قلوب متحجرة فكسرها و لينها كما لين الله لداوود الحديد، هكذا كانت القيم المعنوية تنبعث من دور العبادة...و لكننا و للأسف لا نجد في هذه الأيام من يحسن قيادة هذه الدور معنويا إلى جانب ما يطغى فيها من فكر، رغم أن المساجد كانت و لا تزال هي و لم تتغير تشريعيا و حركيا بين صدر أيام مؤسسها الأول صلى الله عليه و آله و سلم و بين اليوم. نرى أنفسنا في معابد السير و السلوك و التربية و المعرفة و العرفان عاجزين روحيا و معنويا عن كسب قلوب التائهين عن الدرب اليقيني الحقيقي بحيث أننا نسرف فيهم فيدخلون المساجد و يخرجون و مؤشر كمالهم الإنساني جامد عن الصعود إلا إلى الأسفل.
ليؤثر من خلاله على القلوب المتحجرة القاسية المستعصية الصلدة و على الأنفاس الإجرامية الصحراوية المشركة، و علينا أن نقر بأن النبي الأكرم استطاع من خلال المسجد أن يصنع إيمانا لا تهزه الرياح العواصف و استطاع من المسجد أن يقود دولة إسلامية فتية نحو الصعود للكمالات الروحية و الأخلاقية و الفكرية و الإيمانية المتجلية أبسطها في معارك بدر و الخندق و غيرها و التي مثلت بذل الإنسان و تضحيته بنفسه في سبيل المبدأ الذي وضع دستوره خالق الحياة لا لأجل شيء غير حب الله سبحانه و تعالى، بحيث ضحى المسلمون الأوائل بأرواحهم مع قلة العتاد و العدد في معارك غير متكافئة و غير محتملة الغنائم إلا بنسب ضئيلة...هكذا كان المسجد هو مصنع الإيمان و التضحية و البذل الذي لا يترجم إلا عن بعد معنوي داخلي بناه معلم مؤثر داخل قلوب متحجرة فكسرها و لينها كما لين الله لداوود الحديد، هكذا كانت القيم المعنوية تنبعث من دور العبادة...و لكننا و للأسف لا نجد في هذه الأيام من يحسن قيادة هذه الدور معنويا إلى جانب ما يطغى فيها من فكر، رغم أن المساجد كانت و لا تزال هي و لم تتغير تشريعيا و حركيا بين صدر أيام مؤسسها الأول صلى الله عليه و آله و سلم و بين اليوم. نرى أنفسنا في معابد السير و السلوك و التربية و المعرفة و العرفان عاجزين روحيا و معنويا عن كسب قلوب التائهين عن الدرب اليقيني الحقيقي بحيث أننا نسرف فيهم فيدخلون المساجد و يخرجون و مؤشر كمالهم الإنساني جامد عن الصعود إلا إلى الأسفل.
المراهقون و بيئتهم العاطفية الخصبة
إنَّ المراهق هو عبارة عن وعاء فارغ يقبل معظم الأفكار قبل أن يبادر المربي إلى ملئه، إذ أنه محتاج نفسياً إلى من يظهر لهم ولائه ليصب على حياته شيئاً من الأهمية أو الخصوصية عن بيئته التقليدية، فالمراهقون عبارة عن أفراد لا يدينون لمبادئ راسخة أو لجماعة ما، و هم نتيجة لذلك يبحثون أشد البحث عن مبادئ و جماعة ليتشبثوا بها و يظهروا لها الولاء فإن وجدوها بعد ذلك أظهروا جل حماسهم و تعصبهم لها و رفضوا أي تعرض لهذه الجماعة أو لتلك المبادئ بالسوء، - و إنَّ ذلك حسن إن سمت تلك البادئ التي غُذُوا بها، و كما أن العدو الخارجي قد أحسن اختيار الوسط الذي يتقبل أخلاقه و يقبل الابتعاد عن الروتين إلى التغيير و هم فئة المراهقين و الشباب، و استطاع كذلك أن يطبع أخلاقه بما هو متعلق بالروح، لأن الشهوة ما هي إلا سلوك روحي معنوي، و هي عبارة عن انجذابٍ نحو حنانٍ من الطرف الآخرِ لينفس ما به من همِّ الوحشةِ و الوحدانيةِ إلى دفئ القرب و الوصال، و تطابق الشهوة في صفتها الروحية مشروبات الخمر التي يسميها البعض بالمشروبات الروحية و التي تعترض إلى روح شاربها، غير أن مفعولهما سلبي و ضار; فإنه لو استطاع صانعوا الأفراد أن يستميلوا هذه الفئة إلى جانبهم بالتربية الروحية لكان ذلك أقصر لهم لبلوغ أهدافهم المنشودة. إننا لو لاحظنا الجو العام الذي يعيشه المراهقون وجدنا بأنهم يمثلون الوسط المناسب و الأسهل للتربية المعنوية و الروحية، و خصوصاً أنَّ المراهق يقبل المبادئ لمرة ثم يقبض عليها و يدافع عنها باستبسال ليتبناها بحماس شديد، فإذا ألحمنا المبادئ في قلبه ضمنَّا تبنيه و تقبله لها، و لا ضمان لذلك التأثر إلا بالحب و الالتحام الروحي، و قبض الفرد على مبادئه هو ما يطلبه على وجه التحديد مهندسو الأفراد ليكونوا ناجحين.
و علاوة على ذلك فإن الإنسان مفطور على حب الخير المطلق الخالي من أي من المصالح ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ، فلا يرتاح و لا يطمئن داخليا في حبه إذا كان حبه غير صادق فيمن يحب و كان هذا الحب نفاقا لا لأجل الآخر ذاتيا و إنما لأجل مظهره أو شكله الخارجي على سبيل المثال، و هذا هو تفسير نذرة حالات الانتحار لدى المجتمعات الإلهية و تفشيها لدى المجتمعات المادية برغم ما هو متاح للمجتمعات المادية من تفريغ الآلام و الشحنات الروحية في الشهوة، مما يدل على أن لا غنى و لا استقرار إلا بما قرره الله للإنسان من علاقات و أطر حب، و إنه لا طمأنينة و لا راحة كاملة إلا بربط المراهق و الشاب و الإنسان بحب الله الذي هو عبارة عن حب عذري صادق مئة بالمائة و لا حدود للذته و صدقيته لما كان مؤسسة حب بين الأدنى و الأعظم و بين الصغير و الكبير و بين المولى و العبد دون دخول المصالح بل بكون تلك المؤسسة مؤطرة بنظرة الإعجاب في كمال المحبوب و ألطافه و عظمته...
دار العبادة يُزاح عن منصبه الإلهي
إن دار العبادة اليوم لم يعد متربعا على الصرح العالي الذي أعده الله أن يكون عليه، بل أصبح متقاعسا جدا عن أداء دوره الريادي مقارنة مع عظمة هذا الدور الذي يصل إلى تجييش الجيوش و إعداد الكوادر المؤمنة على يد مؤسسه الأول الإنسان الكامل ص. أخذ دار العبادة يعود القهقرة إلى الوراء مغفلا مجدا و عزا و منصبا بالغ الأهمية نصبه الله عليه. كان المسجد قد أخذ على عاتقه صناعة شخصيات إيمانية فذة مثل عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان و جابر الأنصاري و مصعب بن عمير و كوادر الدولة الإسلامية الصاعدة في مصنع محمد بجودة عالية المقاييس شملت الداخل المعنوي المستعد للتضحية بأغلى ممتلك عند الإنسان بكل إخلاص و وفاء و شملت الظاهر المعرفي كذلك، فما هو ذلك الدور الذي أجاده الرسول بحيث أنشأ رجالا لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله؟ ما هو الدور الذي أداه بحيث تمكن في فترات بسيطة من تحويل قلوب الشباب إلى قلوب ذائبة في سماء التضحية الوفائية لله جل و علا و ماذا فهموا عن الله بحيث رخص عليهم كل عزيز إلا أن يتفاعلوا في سبيل الله، ألم يكونوا عاشقين ذائبين في الله؟
ألم يكن دورا تربويا ركز عليه المسجد كقاعدة أساس؟ و على هذا الأساس؛ ألا يعد انحراف دار العبادة عن تأدية دوره المنوط به من إنشاء قاعدة لله داخل القلب سببا رئيسا في تفشي المادية و غياب المعنوية إلى درجة أصبحت فيها الأعمال المعنوية ممثلة ماديا؟ إننا نرى صمتا لا مباليا للرين الذي نصبه عدو الكمال و الإبداع داخل قلوب الأجيال المسكينة، نرى فقرا معنويا و روحيا مدقعا داخل الكيان الذي يفترض فيه أن يعد جيلا مؤمنا متصلا بهدفه و بروحه بين الأرض و السماء، إننا نشهد انقلابا مأساويا للعلاقة بالله بحيث أصبحت دور العبادة و السمو و الرقي ترقى معماريا عما يرقى إليه المصلون و الحاضرون في أكناف تلك الدور، و هب أن مسكينا عطشانا لا يتقن الحديث مع الله دخل إلى أكناف دار العبادة كمثل أغلب دورنا العبادية الظاهرية الجافة فهل يكون هنالك ثمة تكهن أو أدنى احتمال بوجود من يستنطق قلب هذا التائه نحو الحقيقة المطلقة في هذه الحياة؟ هل أن مساجدنا تربي قلبا متعلقا بالله؟، و إني لأجد التائه قد يخرج من دار الله و هو أكثر بعدا و تعلقا بالمادة عن الله لمّا تحولت دور الله إلى أماكن استعراض لا لأجل الله و مصارعة ليست ضد الذات، و بعد هذا لا يُستحى أن يقال إن دار العبادة متكامل الأوصاف و باب ملك عظيم، هل أن دار العبادة اليوم باب لله و للعروج له؟
إن الله سبحانه و تعالى قد جعل دار العبادة مكانا مصعِّدا للكمال و مصنِّعا للروح و العلاقة المعنوية العذرية الهادفة المخلصة مع الله و جعل هذا الهدف و هذا السبيل هو المحرك الرئيس لكل ما يدور حوله الإنسان من عمل، فكان على المسجد مسؤولية كبيرة في صناعة الأفراد و صياغتهم إلى معين الحنين إلى الله و الارتياح إلى الله و الشوق إلى الله و الهيام مع الله، ما أجمل المسجد لمّا يدخل إليه التائه فيخرج منه بدفعة إيمان و وقود يدفعه ليسرح إلى الله في ميادين السابقين و يسرع إليه في البارزين، ما أجمل المسجد لمّا يحرك في داخل مرتاده شعورا أحديا هياميا عاشقا لواجب الوجود و المؤثر الأوحد في الوجود جل جلاله، ما أجمل المسجد لمّا يحرك في الإنسان تمردا على الأنانية و الصفات الأرضية الدنيوية، ما أجمل المسجد لمّا يحرك في الإنسان بإذن الله قيما كانت مشلولة الحركة (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم)، ما أجمل المسجد لمّا يرقى و يرقى بالعبيد إلى الحرية و الرفعة من الدنيا على طريقة (كونوا أحرارا في دنياكم)، فأين دور المساجد و أين هي تلك الشخصيات الروحية المؤثرة التي ينهل منها المؤمنون وقودا و صعودا و همة لله؟
فقرنا المعنوي و إسرافنا المعرفي
ألا نعيش في واقعنا فقرا معنويا في وقت بدأ الطاعون الأخلاقي يلقي بظلامه على أسدة مجتمعاتنا المغلقة؟ أليس من حقنا أن نحقن إيماننا و نلحمه لحاما فولاذيا من الداخل المعنوي و الخارج الحركي؟ أين أصبحنا و أين أصبح أبناؤنا؟ أين الإشعاعات النورانية التي يجب أن تؤثر في هؤلاء الأبناء المراهقين العاطفيين؟ و لكن و للأسف؛ فبينما نموت نحن و يموت أبناؤنا المراهقون التائهون و غيرهم و تموت قلوبهم الطرية العذبة السريعة التأثر و الانجذاب نرى سرفا كبيرا لا حد له في الطاقة المعنوية، نرى أيام الله تأتي ليأدها المتنسكون دون أدنى تأثير أو تفاعل بيننا و بينهم و بين الله و دون أدنى تجديد و انقلاب في حركة القلب نحو الله، نرى التائهين المنحرفين عن طريق الله و حبه يدخلون صوامع يفترض أن ترشدهم لحب الله و يخرجون منها دون تحرك فيهم و في إيمانهم ، فهل كل العيب فيهم؟ ألسنا مطالبين بأن نتفاعل مع خالق هذا العالم العظيم؟ ألسنا مطالبين بأن نتصدق على من حولنا إن كنا من الميسورين معنويا؟ أين التفاعل مع الله؟ أين الرقي و الصدق مع الله؟ ألا نضع على أنفسنا قليلا من المسؤولية و العتاب على ما ضيعنا من هؤلاء الشباب و المراهقين الذين خُطط لهم بأن يكبرون و يصنعون جيلا و أسرة فاضلة؟ أفلا تكون دورنا العبادية مدنا فاضلة؟
ألم يتخرج الشاب الميسور معنويا و معرفيا مصعب بن عمير الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة على يد المساجد و على يد رائد المسجد؟ و لعمري لو كان ذاك الفتى مصعب في زماننا لآيس أهل الدين و المتنسكون من حاله و هو الذي كان يُستدل على مروره في الأزقة من روائح العطور الفواحة التي يتركها أثره، كان مصعب بن عمير شابا مترفا متابعا لموضة عصره مغازلا للنساء منوع الثياب بإفراط، فما كان من مدرسة المساجد و التربية إلا لتحول هذا الشاب إلى معلم هائم و مهيِّم نحو الله سبحانه و تعالى لأهل يثرب الذين خرجوا لاستقبال نبيهم بأبيات اللهفة و الترحيب و المحبة و الهيام حتى قالوا (...أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع...)، فما الذي فعله مصعب و ما الذي حُمِّل من كنوز إلهية جعلته مؤثرا و هو المتأثر بالأمس؟ إلا أن يحفر الرسول فيه حبا شديدا لله و ثقلا معنويا مذهلا، فما هذا التجاهل عندنا نحن لكل المؤثرات المعنوية العالية الراقية مع الله، ألسنا أمة تحمل من الرصيد المعنوي ما يكفي ليغني أهل الأرض كافة؟ ألسنا من يملك الصحف العلوية و الفاطمية و السجادية و الجنانية؟ ألسنا ممن مولاهم إمام العرفاء و المتقين و المحلقين في سماء الله إذ يقول (ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله فيه و قبله و بعده و معه...)، فأين نحن منه إذ كان عرفانه عرفانا إشعاعيا على من حوله؟ أليس واجبا علينا أن نسلك و من حولنا طريقا يوصلنا إلى الرقي المعنوي المجهول المتجاهَل المدفون الغائب الذي يقود إلى كل خير و نجح و سعادة (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون).
إنَّ سلامة الروح و الزخم الروحاني هما الحبر الذي يحتاجه صانعوا الأفراد لرسم تلاميذهم بقلم القيم و العلم، فنجد أنَّ الصور لا تُرى لناظرها دون حبر، كما أن التزكية و هي تطهير الداخل تسبق التعليم في الإسلام ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ ، و ما تدل يؤكد بوضوح هذا المعنى و ذلك بتقديمها للتزكية على التعليم، لذلك فإننا بحاجة ماسة إلى من يؤثر على الأفراد روحياً فيكون حاجزاً داخل قلوبهم يفصلهم عن الضفة الخطأ و يذكرهم بالله. هذا المؤثر يمثل القدوة الصالحة الذي يجب أن يربي نفسه روحياً و معنوياً على الحب الكبير لله سبحانه و تعالى، حتى يسير على الأرض بنور الصالحين، و هذا متطلب أكيد من متطلبات التأثير، بحيث أن يمشي بنور الله و يجسد روحانية الرجال الصالحين الذين يستطيعون ملئ القلوب بحبهم، و هذا متجل في عظمة رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم- الذي استطاع أن يؤثر على الطبقة المعروفة بقسوتها و شدتها و صعوبة تليينها للحب الإلهي و هي طبقة العبيد المحرومة، لقد استطاع النبي الأكرم أن يؤثر على طبقة العبيد أعظم الشيئ بروحيته، كما يثني ربه عليه و يقول ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ و كذلك يقول فيه ﴿ و إنك لعلى خلق عظيم ﴾ ، لقد واجه النبي المرض بالعلاج المضاد، ثم أخذ بالوقاية عن طريق الروح و التي تضمن له كمهندس للفرد تطبيق ما يأمر به من أحكام، فالعشاق يأتمرون دوماً بأوامر المعشوقين.
أدوار عبادية مقلوبة بين الكم و الكيف
لقد خلق الله الإنسان و جعله موجودا على أرض البسيطة و أنزل إليه الأنبياء و علمه كيف يكلمه و يدعوه و يعبده و يشكره لا لكي يجعل ذلك فرضا روتينيا مملا قاسيا يتخذه المنفذ همّاً متعبا يريد أن ينجزه، و إنما جعل الله هذه المناسك و هذه الأعمال العبادية لكي يتلذذ الإنسان و يشتاق إلى عملها و فعلها و عشقا إلى من هي مقصودة إليه سبحانه و تعالى، فلم يجعل الله عملا تعبديا لزاما على الإنسان بالقهر و القوة بقدر ما أن الله سيحاسب من يتقاعس عنه في أجل غير مسمى. و قد جعل الله الدعاء و التضرع وسيلة لما يسقطه الإنسان بغفلته و ضعفه و ضعف إرادته وسيلة للعبد لكي يتذلل إلى الله و يطلب منه بمنته أن يتفضل على العبد و يقبل منه اليسير مما قدمه في قبال ما كان يجب أن يقدمه متناسبا مع عظمة المقدَّم بين يديه العمل و يعفو عن الكثير من المخالفات و المعاصي، و لا شك بأن هذا يقتضي أن يكون دعاء هذا الإنسان خارجا من قلبه و من كل كيانه لكي يترك الله سبحانه حقه و يغفر للإنسان المقصر المخطئ خطاياه، و إن هذا العمل لا يمكن إلا يكون كذلك في سبيل القبول من ملك عظيم جبار سلطان ليس مجبرا و لا مضطرا و لا مهددا أن يعفو إلا بمنة الله لا بمنة العبد، و على هذا الأساس كان لا بد من الكلمات التي يعلنها العبد أن تكون مترجما للقلب و تفاعلا لما يريد أن يقوله القلب عاجزا عنه اللسان، فليس المهم هو أن ينجز الدعاء و أن تنجز الصلاة و خصوصا فيما لو كانا مستحبين و كانا بقصد العفو و القربان و لم يكونا فرضا، فإنْ تصادم ما خرج من اللسان مع ما انشغل به القلب كان ذلك مشوها و حائلا لمقبولية العمل إلا بمنة الله الذي (يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور) فلا مجال للتمثيل و التصنع و تأدية العمل بملل معه.
لذلك فإن كثرة ما يقرأ الإنسان بلا توافق بين القلب و اللسان لا يوازي ما يقرؤه الإنسان بتفاعل و إيمان و توافق مترجم بديع بين اللسان و القلب و لو كان قليلا (لا تهتموا لقلة العمل، و اهتموا للقبول)، و عليه فإنه لا اعتبار لكثرة الدعاء و الصلاة المفرغة عن التأمل و التفاعل في قبال صلاة واحدة و دعاء واحد و لو بكلمة واحدة و لكن مع تواز مخلص بين القلب و اللسان، و لا مجال للنفاق و التصنع مع من (يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور)، و إن العجب العجاب و التصرف الخالي من النتاج هو ما يؤدى غالبا في أغلب دور العبادة -إلا ما قادها عارف بالتعامل الصحيح مع الله- أن يُستكثر إلى حد عجيب من الأدعية في المناسبات و النفحات الإلهية التي يزداد فيها قبول الله للأعمال و لكن بكم بلا كيف، فتؤدى تلك الأدعية بصورة مملة لسانية أرضية مادية يهتم فيها القارئ و المستمعون لوقت نهاية الدعاء و يبيتون جسدا في المسجد و نطقا بالدعاء و قلبا بأمور الدنيا، و يا للأسف و يا للجوع على ما فقدنا من لذات حلوة مع الله في أيام النفحات و الليالي التي يعتبرها العرفاء ليال للصعود و العروج لا ليال لتنجز و تنهى بفارغ الصبر، فليس المهم في أن تكثر من كلمات خالية من المضمون القلبي مع الله، بل إن المهم هو أن تخرج تلكم الكلمات من القلب، و في هذه الوضعية المملة الخالية من المعنى فلا شك و لا ريب أن يكون المسجد مكانا مملا إلى حد لا يستأنس فيه الإنسان مع الله بقدر ما يستأنس مع الآدميين، و يشعر الإنسان بالوحشة من التعامل مع الله فلا يفتح له أفقا يمكن أن يتفاعل من خلاله نحو حب الله، فيتمثل ساخرا ما هو هذا الحب الذي يتملل منه المتنسكون في المساجد؟ و بالطبع؛ لا وجود لحب الله في هكذا دار للعبادة، فأين دور المسجد الصحيح في هذا؟.
من يحمل المسؤولية القصوى؟
إنني أحمل كل من يمتلك غنىً معنويا مسؤولية دخول تائه بيت الله و خروجه منه دون أدنى تغيير يذكر أو استفادة في كيانه و شخصيته من هذا الغني، و أحمل كل من حال في بيوت الله بين غني معنوي مؤهل أن يفيد التائهين من غناه و يتصدق عليهم، إنني و الله أتحسر على سرفنا في هؤلاء المساكين و في أنفسنا على ما فرطنا لأجلهم و أجلنا في جنب الله، إنني و الله أتألم و أزداد ألما كلما وجدت نفسي و مَن حولي بعيدين عن الكمال و عن التواصل مع الله، إنني و الله لا ألوم كل من قذفه تيار الأخلاقيات المنحطة بعيدا عن جادة الصعود الكمالي المتألق لله لأنني لا أجد دليلا يدله و يدلني بحب أبوي دافئ على الطريق، القرآن نعم موجود، المسجد نعم موجود، العلماء نعم موجودون، و لكن كل هؤلاء صامتون و لا ينطقون و هم بحاجة لاستنطاقهم، ناهيك عن كون معظم أهل العلم مشغولون بعلم الدين المادي الفردي النفع إجماليا عن علم الدين المعنوي المؤثر بكل الحدود و بفعالية ممتازة. و بالله على أهل السعة و الغنى و المسؤولية و الطاقة المعنوية من أين يتأتى لتائه أن يجد الطريق و هو يسير بين أنياب هذه السرابات الملهية الخطيرة المليئة بالنقط الحرجة؟ أنى له ولوج الطريق و هو لا يكاد يجد مرشدا يصنع جوا معنويا شفافا يربطه بالله مباشرة بإخلاص العاشق و المعشوق؟ تراه يدخل المسجد فلا يجد فيه نورا و روحا و قلبا ناطقا، تراه لا يجد من يصعق قلبه صعقا ليستفيق من كذبة الدنيا لصدقية حب الله، يدخل المسجد ليرى الصلاة جامدة لا روح معنوية فيها، ليرى مصعد الصلاة بين التكبير و التسليم ثابت دون صعود، يرى صلاة فارغة من المحتوى و المعاني، أليست الصلاة عروجا يبدأ من التكبير و ينتهي في المنظر الأعلى تسليما على النبي و الصديقين و الأبرار و الصالحين؟ فهل صلاة الجماعة في المساجد هكذا؟
نرى أنفسنا معذبين بين المفاتن و المآسي و المعاصي و المغريات الدنيوية و المعنوية التي يفترض ألا يستهان بقوتها، إلا أننا و في نفس الوقت نجد المسجد لا يغادر في مواد الدين فكرا و مادة و فقها و عقيدة إلا أحصاها و هو لا يكاد إلا ملغيا كل دور روحي معنوي من شأنه أن يحافظ على ما تبقى داخل قلوبنا نحن الشباب من إيمان، ذلك إن وُجد، فهل حفظ الفقه و العقائد و هذه المواد شبابنا عن انحرافهم؟ أو ليس انحراف الأخلاق انحرافا قلبيا و روحيا و عاطفيا معنويا؟ أليس حراما و سرفا أن ينحرف أغلبنا معنويا مع ما عليه ديننا من غنى معنوي؟ ألم ينحرف أغلبنا نحو الجاه و الظهور و العجب و المشاعر المكدرة لصفو الإيمان؟ و برغم ذلك نرى مواضيع تفتق العقل من دقتها و غربلتها لمواد الإسلام العقلية سواء في محرم الأحرار و العبيد أم في رمضان العروج و الصعود أم في بقية أيام التقاويم التوائم، بينما لا نجد في هذه المواضيع ما يغير شيئا في قلوب التائهين أو يزيد فردا في جنود العاشقين، فبحول الله ماذا صنعت و أسست هذه الموضوعات و ماذا نتجت إن كان من تلقى عليه لا يكد يصنَف مهتما بها؟ أليست من كبريات مسؤولياتنا أن نكون مسؤولين عما ظمأ عنه التائهون؟ أم أننا فقراء إلى المسؤولية و التخطيط و العرفان؟ هل كان الأنبياء في عصورهم إلا يدعون أقوامهم بما يعانون من مرض؟ هل لقوم مشركين إلا أن يُدْعَوا إلى التوحيد؟ هل لقوم تائهين عن الله إلا أن يُدْعَوا إلى الله؟ هل لقوم جانبتهم الأخلاق إلا أن يُرْشَدوا إليها؟ أم أن موضوعاتنا ترف بلا هدف؟ أليس من أهم أهداف و مسؤوليات دور العبادة أن تقدم منهجا تربويا يجدب القلوب لبارئها صعقا؟ أفلا يجابه مرض العواطف و المعنويات و الروحانيات بما يمتلكه دين الله الحنيف من رطوبة معنوية لذيذة؟ إني أرانا إلا أعرابا في الإيمان و نحسب أنفسنا مؤمنين، و لا يعرف تمام سوء ما نحن عليه إلا من ذاق حلاوة الإيمان، إن علينا على هذه الحال إلا أن نقول "أسلمنا" و ألا نرفع أنفسنا كماليا إلى أعلى مما نحن عليه، فليست هي مجرد كلمة و ليست الصلاة مجرد حركات و سكنات، أي إيمان يحمل من يخاطب الله متململا لا متوجها فلا يعامل الله بنصف أو حتى بربع ما هو أهله؟ أي إيمان و هو يدعو الله و كأن المنة له لا لله؟ أي دعاء و إيمان يحمل و هو غير مستعد حتى بأن يبذل جوارحه مع الله فيجلس ساكنا خاشعا فداء لله و قربانا لله؟ شتان بينه و بين من قدم دمه و روحه و أهل بيته و أطفاله لله متمثلا (اللهم تقبل منا هذا القربان) و بين من هو غير مستعد حتى بأن يستقبل الله حتى بجارحة خاشعة على الأقل فما بالك بقلبه؟ أي إيمان يحمل و هو يدعو الله متكأ و لا يكاد يتمتم بالدعاء و يدعو الله بمنتهى القسوة و التحجر؟ هل يعد هذا إلا تصرفا أعرابيا أحمقا مع الله؟ أهكذا هي مساجدنا و ما تربينا عليه فيها؟ فأين هم المربون؟ (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان في قلوبكم...)، إن وضعنا الكمالي في أغلب دور عباداتنا لا أسميه إلا إسلاما و ليس إيمانا!.
نظرة في تراث علي  و نقطة تركيزه
و نقطة تركيزه
إني أقدم لكل مسؤول على سدة التبليغ و الوجاهة الدينية دعوة مع نهج البلاغة ليطالع موضوعاته التي تمثل ما قدمه و أبانه ولي أمرنا و أميرنا علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه خلال فترة حكمه و صعوده على منبر العامة أن يطلع إلى مجمل نتاج هذا الرجل القدوة من موضوعات و أن يستقرئ السبب في اختيار تلك الموضوعات، و سوف يجد بأن الأغلب الساحق من هذه الخطابات يركز على ما كان يحيط بمن حول علي  من مرض و هو المرض الروحي و سيطرة الدنيا و المادة على تفكير الناس، و السؤال: لماذا ركز أمير المؤمنين على هذه الموضوعات الروحية و الأخلاقية برغم أنه كان أقدر القادرين و أجدر المتكلمين بأن ينظر في قواعد الأصول و أن يطرح نظرياته العلمية الدينية العميقة و هو باب مدينة العلم و هو الذي ( سلوني قبل أن تفقدوني...سلوني عن أقطار السماوات و الأرض...)؟ ألم يكن علي بن أبي طالب هو الوحيد من قال سلوني قبل أن تفقدوني؟ ألم يكن بإمكان أمير المؤمنين أن يهمل الهدي و التربية و التصحيح المعنوي الذي ركز عليه ليحدث الناس عن أقطار السماوات و الأرض و عن العلوم المختلفة؟ فلماذا أهمل هذه الأمور على العامة و ركز على تربيتهم؟ و إن جواب ذلك واضح لمن لا تطيق له المكابرة سبيلا، و هو أن مرض العامة في زمن علي ع هو المرض الروحي و الأخلاقي و عليه فإننا نجده مركزا بشدة على هذه القيم و على هذه المنطلقات الروحية و المعنوية التي تتخذ الدنيا عدوا، و من هنا نقول و العقل يقول بأن الجدوى التي يترتب عليها التغيير و الصلاح هي التركيز على أكثر الأمراض استعصاء في الناس و معالجتهم من هذا المرض أولا، فأي أهمية لما يطرحه الخطيب من نظريات عقلية و فكرية لا توجد تفاعلا محركا للكمال عند أغلبية الناس من التائهين و المساكين روحيا و قلبيا؟ و إن المشرك لا يتفاعل مع نظرية في الفقه مثلا، فلا بد أن نحركه أولا للتوحيد، كما و إن التائه المنحرف الشاب الذي يدخل المسجد فإن لا أهمية عنده تتشكل من خلال هذا التنظير الفكري العميق الذي لا يشكل لا مشكلة و لا حلا عنده، و إن ما يحتاجه و يلح لأجله هو أن ينفضه المسؤول الميسور روحيا نحو الله.
من مرض و هو المرض الروحي و سيطرة الدنيا و المادة على تفكير الناس، و السؤال: لماذا ركز أمير المؤمنين على هذه الموضوعات الروحية و الأخلاقية برغم أنه كان أقدر القادرين و أجدر المتكلمين بأن ينظر في قواعد الأصول و أن يطرح نظرياته العلمية الدينية العميقة و هو باب مدينة العلم و هو الذي ( سلوني قبل أن تفقدوني...سلوني عن أقطار السماوات و الأرض...)؟ ألم يكن علي بن أبي طالب هو الوحيد من قال سلوني قبل أن تفقدوني؟ ألم يكن بإمكان أمير المؤمنين أن يهمل الهدي و التربية و التصحيح المعنوي الذي ركز عليه ليحدث الناس عن أقطار السماوات و الأرض و عن العلوم المختلفة؟ فلماذا أهمل هذه الأمور على العامة و ركز على تربيتهم؟ و إن جواب ذلك واضح لمن لا تطيق له المكابرة سبيلا، و هو أن مرض العامة في زمن علي ع هو المرض الروحي و الأخلاقي و عليه فإننا نجده مركزا بشدة على هذه القيم و على هذه المنطلقات الروحية و المعنوية التي تتخذ الدنيا عدوا، و من هنا نقول و العقل يقول بأن الجدوى التي يترتب عليها التغيير و الصلاح هي التركيز على أكثر الأمراض استعصاء في الناس و معالجتهم من هذا المرض أولا، فأي أهمية لما يطرحه الخطيب من نظريات عقلية و فكرية لا توجد تفاعلا محركا للكمال عند أغلبية الناس من التائهين و المساكين روحيا و قلبيا؟ و إن المشرك لا يتفاعل مع نظرية في الفقه مثلا، فلا بد أن نحركه أولا للتوحيد، كما و إن التائه المنحرف الشاب الذي يدخل المسجد فإن لا أهمية عنده تتشكل من خلال هذا التنظير الفكري العميق الذي لا يشكل لا مشكلة و لا حلا عنده، و إن ما يحتاجه و يلح لأجله هو أن ينفضه المسؤول الميسور روحيا نحو الله.
قد يقول قائل بأن الإمام الصادق  كان يركز على الفقه و العقيدة و على الفكر في موقفه و عليه فإن من حق المسؤول المبلغ أن ينتهج ما يختار من طرق الأئمة، فنقول و يقول التاريخ و الموقف بأن كلمات الإمام الصادق
كان يركز على الفقه و العقيدة و على الفكر في موقفه و عليه فإن من حق المسؤول المبلغ أن ينتهج ما يختار من طرق الأئمة، فنقول و يقول التاريخ و الموقف بأن كلمات الإمام الصادق  لم تكن خطابا منبريا عاما، بل و لم يكن خطبا أصلا و إنما كان دروسا محدد حاضروها و هم من الخواص و لم يكن درسا للعامة أبدا، فهل ينطبق أن نكرس ما قام به الإمام الصادق على خواصه على هيئة دروس كخطب منبرية أو مسجدية؟ الموضوع و التوقيت مختلف بالفعل، فلا مانع من أن تطرح هذه النظريات التي يعد إلحاحها صفرا بالنسبة للشاب و المراهق -إلا الناذر منهم- في محال خاصة تختص بمن يحب هذه الأمور و يتفاعل معها أو يتخصص فيها، و لا يعيدنا العقل و المسؤولية إلا أن نعمل على قاعدة نظرية الأهم ثم المهم بالنسبة لعامة الناس، فهذا علي ع أشبه بأن يهمل النظريات على حساب الأخلاق و ما جاء الدين فعليا ليحركه (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، على أساس أن النظريات لا يمكن أن تتحرك و تتبلور و تتكامل و تتفاعل مع هدف الله من صناعة الإنسان دون أن تكون مدعومة من قبل قلب شفاف مؤمن مخلص متعلق بالله، و لا فائدة من أي نظرية فكرية ما دامت كامنة في قلب عشعش فيه حب الدنيا و الذات و لا قيمة لها أبدا في عمارة الأرض.
لم تكن خطابا منبريا عاما، بل و لم يكن خطبا أصلا و إنما كان دروسا محدد حاضروها و هم من الخواص و لم يكن درسا للعامة أبدا، فهل ينطبق أن نكرس ما قام به الإمام الصادق على خواصه على هيئة دروس كخطب منبرية أو مسجدية؟ الموضوع و التوقيت مختلف بالفعل، فلا مانع من أن تطرح هذه النظريات التي يعد إلحاحها صفرا بالنسبة للشاب و المراهق -إلا الناذر منهم- في محال خاصة تختص بمن يحب هذه الأمور و يتفاعل معها أو يتخصص فيها، و لا يعيدنا العقل و المسؤولية إلا أن نعمل على قاعدة نظرية الأهم ثم المهم بالنسبة لعامة الناس، فهذا علي ع أشبه بأن يهمل النظريات على حساب الأخلاق و ما جاء الدين فعليا ليحركه (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، على أساس أن النظريات لا يمكن أن تتحرك و تتبلور و تتكامل و تتفاعل مع هدف الله من صناعة الإنسان دون أن تكون مدعومة من قبل قلب شفاف مؤمن مخلص متعلق بالله، و لا فائدة من أي نظرية فكرية ما دامت كامنة في قلب عشعش فيه حب الدنيا و الذات و لا قيمة لها أبدا في عمارة الأرض.
أين علوم العرفان و رجاله؟
نحن في الواقع محتاجون إلى رجال عرفاء أو سالكين على الأقل متصلين بالله فعليا لكي يؤثرون بأنفاسهم و بكلماتهم التي تخرج من القلب إلى القلب لتحييه و تحي العظام و هي رميم، نحن بحاجة إلى رجال مخلصين في طاعة الله ليتفاعل معهم التائهون من المراهقين الذين تمتاز قلوبهم بالليونة و العاطفية، نحن بحاجة لأن ندخل مساجدنا و نجدها تفاعلنا نحو الله و القيم بالطريقة التي تغني عن ألف كتاب أخلاق، لقد سئمنا طرقنا الأعرابية في التعامل مع الله، نحن بحاجة إلى أمثال آية الله السيد الشهيد دستغيب، نحن بحاجة إلى معلمي أخلاق في هذا الزمن الذي تفشى فيه القحط الروحي الإخلاصي الصادق البعيد عن العجب و الأنا و المنة، نحن بحاجة إلى من يكرس و يحمل على عاتقه تفعيل قيم دعاء مكارم أخلاق زين العابدين ع في الناس، نحن بحاجة إلى دعاة إلى الله بطرق جذابة مؤثرة، نحن بحاجة إلى مثل ما يطرح معلم الأخلاق الشيخ حبيب الكاظمي، نحن بحاجة إلى مساجد تهتم بالجوانب المعنوية التي هي أساس كل الإبداعات، نحن بحاجة لأن يتكامل دور المسجد بين المصلين المتفاعلين مع الله و بين إمام المسجد المحلق في ساحة الإخلاص لله و السير إليه بعيدا عن الأنا و العجب و الجاه و الحظوة و الحماقة و اللجاجة و التنازع على الظهور و الجفاف و العصبية و التكبر و البغض نحو الرقة و العذوبة و الأخلاق الحميمة و التواضع و التفاعل مع مناجاة الله جلت و تجملت أسماؤه و صفاته، هكذا يدخل التائه المسجد لينال تفاعلا و عدوى معنوية مقدسة، فليكن المسجد متجر مسك يصيب داخليه بريحه الطيبة مباشرة أو من دون مباشرة، و إلا يكن فإن ضياعنا مستمر بين المعاكسة و الأفلام الهابطة و القيم الكاذبة و المزيد آت. فليعد إلى أذان المسجد محتواه و جماله و ليعد إلى الصلاة محتواها و جمالها و ليعد إلى التعقيب المناجي لله رونقه و جماله و نعيش (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر...)، و ليبدأ الوعظ المعرف بجمال الله و جلاله.
إنني أدعو علماء البلاد و من توجه في سبيل التبليغ إلى أن يولوا اهتمامهم بالعرفان التأثيري على الناس، إنني أدعو كل من يقدس الله و كل عرفاء البلاد الذين تعلقت أفئدتهم بالله أن يتحركوا لينهل المساكين من هديهم و ليربطوهم بحبل من السماء إلى القلب، يا أهل الله الذين صلبوا الدنيا فلم تجد سبيلها إليهم؛ هلموا إلى الناس بهديكم فإن الزمان زمانكم و ظرف الموقف يطلبكم، ألستم أنتم الأجدر بهذه المهمة؟ أليس ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب؟؛ فهلموا إلينا فليس إلينا سواكم، بصِّرونا بلذة الأنس بالله و لا تيأسوا فإن عملكم و الله بعين الله و إن الناس محتاجون لمن يبصرهم الطريق ليروكم متلذذين فيه ليصدقوا بأن الطريق لذيذ عيانا برؤيتهم لكم تماما كما قال إبراهيم ع لربه (رب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي...) و لتطلبوا أيها التائهون أهل الله و المساجد التي يؤمها الذائبون في الله لترون كيف يحي الله الموتى و لتطمئن قلوبكم...
العمل المؤسسي أم ماهية المؤسسات؟
إن انشاء المؤسسات الإيمانية التوعوية و الفنية و الرياضية التي تتيح اجتماع النخب المؤمنة مع شباب الأحياء هو أمر مهم و جيد لتتناغم هذه المؤسسات بشكل تكاملي مع أول مؤسسة و أكمل مؤسسة و هي المسجد، ذلك أن المسجد يتميز بتكامله من حيث البعد الطبيعي و البعد الروحي بغض النظر عن المشكلة التي نشأت لاحقا من فصل المساجد عن الحياة و عن قيادة المجتمع و النظر في أمور الناس و عن الله، إلا أن هذه المشكلة هي قابلة للظهور أيضا حتى داخل مؤسسات العمل التطوعي و هي أن ينفصل العمل التطوعي عن الهدف الرئيس و هو الوصول إلى أفضل صورة في السير إلى الله، و للأسف الشديد فإن مؤسستنا المعول عليها التي هي أعظم قبة انطلاق لمشروع العمل الإسلامي سواء من حيث الدولة أو المجتمع أو الاقتصاد أو السياسة و هي المسجد مريضة بانقلاب في المبادئ لما صار المسجد بدلا من نواة تفيض وعيا و إيمانا و إخلاصا مكانا لتلميع شخصية بعض مرتاديه أو مكانا لاستعراض القبيلة و العائلة و الذات و تحول من مكان يشير إلى الله إلى مكان يشير مجملا إلى الدنيا و لكن بتغليف أخروي، المسجد في الواقع مؤسسة قائمة و موجودة و لكنها بدون تفعيل و تنقصها الإدارة الرشيدة و الواعية بكون الشخص المناسب ذي الأهداف النبيلة الكبيرة و المسؤولة في المكان المناسب. المسجد وحده لو تم تفعيله كما هو لأجله لصنع لنا الكثير و لكن مع الأسف فإن هذا لم يكن حتى الآن و نسأل الله أن يكون.
و انطلاقا من هذا المنطلق فإن الناقص عندنا هو ليس في عدم وجود المؤسسات أو غياب العمل المؤسسي الذي يهدف إلى احتواء الشباب و تربيتهم بقدر ما أن الناقص عندنا هو ماهية هذا العمل و إخلاص هذا العمل و ماهية ترجمة هذا العمل لحب الله و مقدار علاقة كوادر هذا العمل بالله لو كان يهدف لربط الناس أو الشباب بالله سبحانه و تعالى، فإذا كان الهدف هو الله فلا بد أن تكون الوسيلة أيضا في الله و تفاعلا مع الله سبحانه، فها هو المسجد قائم مبني منذ سنين عجاف كمؤسسة أسسها الرسول كأقدم مؤسسة في الإسلام و انطلق منها لكل أهدافه العظيمة التي تهدف إلى صناعة الإنسان و تكامله نحو بارئه (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون)، و لكنها للأسف لا تقوم بدورها الريادي العظيم المقدس الذي يبث إشعاعه و تأثيره على رعاياه، و من هنا فإن المشكلة ليست محصورة في وجود المؤسسات بقدر ما أنها مرتبطة بماهية هذه المؤسسات و تأثيرها و تفعيلها نحو الله و الوصول إليه، فليس المطلوب هنا هو العمل الذي تفوق دعاياه إنتاجيته، كما و ليس المطلوب هو كثرة المساجد فما أكثر الضجيج و أقل الحجيج!، و عجبا لنا إذ نؤمن بالكم بلا كيف، و لعمري لو فعِّل دور المسجد لأوجد في مجتمعاتنا تقدما نوعيا سلوكيا واعيا يميز بين الحقيقة و السراب.
دعوة للرقي و التكامل
يجب على إمام المسجد توعية رواد المسجد معنويا و سلوكيا قولا و فعلا، و أن يحاول أن يصنع هو بنفسه ذاته روحيا و معنويا لأن فاقد الشيء لا يعطيه و إلا كان أيضا رجلا غير مناسب لما يشغله من مكان و سوف يحاسبه الله إذ لم يؤثر على التائهين بما يتناسب و المكان الذي وُضع فيه لأنها و الله أمانة في عنقه، إن المسجد عبارة عن تمازج بديع من أسرة كبيرة تضم الآباء من أب و أم و المعلمين بالمدرسة و الأبناء، و استغلال ذلك يعد اغتناما ذكيا لفرصة الدعوة إلى الله و الأخلاق، و أن يركز الوعظ على المرأة التي هي أم و معلمة و مربية منزل و المؤثرة الكبرى على سلوك أعضاء أسرتها، و لابد أن يسمح للمرأة أن تؤدي دورا دينيا بالحضور في المسجد و تعلّم أمور و قيم و روحية دينها لترسل شعاعا نورانيا إلى أبنائها الذين نحن من نعاتبهم على انحرافاتهم دون أن ننظر في أسبابها، و لربما نكون نحن من أسبابها! إذ أننا من يحرم أمهم و مربيتهم و صانعتهم و المؤثرة الأولى عليهم من الحضور إلى المسجد لتنهل من منبع الله الأصيل كما يجب أن يكون، و إن استمرار منع المرأة من حضورها الضروري و حقها المسلوب هو قمة التخلف و قمة التقوقع الأعرابي الذي لا يرقى إلى الإيمان و فوق درجة الإسلام.
إنني أدعو كل من مسك على عاتقه إدارة مسجد أو صلاة في مسجد أو تعقيبا في مسجد أو أذانا في مسجد أن يراقب الله في تصرفاته و سلوكه و أن يبدأ مشروعا يتعلم فيه كيفية الحديث بلغة الله و أن يصنع في نفسه مشروع حب لله سبحانه و تعالى ليكون متأثرا و مؤثرا و أن يضع قاعدة بأن لا خير في كل ما يمارس من فعاليات إلا لله و إلا كانت دنيا و كان ممن يجعل في كل شيء الدنيا بما فيها الصلاة و الدعاء و التبليغ..، فلينكر في نفسه حب الجاه و الدنيا المستعصي المرتفع، أو ليسيطر عليه و يؤطره بقدر المستطاع، لأن الضرورة ملحة أن يتفاعل مع الله في بيته و يكون ما يخرج من لسانه مترجما عن قلبه، فقد سئمنا ظهور المسجد كحلبة دنيا و جاه و منصب و شهرة برغم أن لا أمل في كل هذا، و قد سئمنا من عبادة الأعراب الجافة في مساجدنا، إننا نريد أن نتفاعل لنصل إلى الحقيقة المطلقة في دنيانا الخرافية و إلى الله و نريد أن يبصِّرنا العارفون بالله كم أن الله عظيم يستحق التفاعل و الحب إلى درجة الذوبان فيه و في عشقه، نريد أن نتفهم على الأقل ما تمثل به أمير المؤمنين (ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله فيه و قبله و بعده و معه..)، نريد أن نفهم متمثل الرسول ص (حب الدنيا رأس كل خطيئة) و أن نفهم بأن حب الله أساس كل كمال و نتفاعل مع ذلك من أعماقنا، لا نريد أن نكون (ما رأينا شيئا إلا و رأينا الدنيا فيه و قبله و بعده معه!!) فقد سئمنا تحول المسجد من دار روح إلى دار مادة، لأنه لم يقدَّر لنا أن نكون محرومين من هذه الفيوضات إلى الأبد. نريد أن نستفيق قبل أن نُفاق بـ (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد) قبل أن تجيئنا سكرة الموت بالحق و الحقيقة المطلقة.