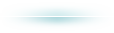سيهات: الشيخ الرواغة «كيف نكون فاعلين؟»

القى سماحة الشيخ صادق أحمد الرواغة «حفظه الله» يوم الجمعة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 10 يونيو 2005م في مسجد العباس  بمدينة سيهات كلمة بعنوان «كيف نكون فاعلين؟»..
بمدينة سيهات كلمة بعنوان «كيف نكون فاعلين؟»..
![]() فيما يلي نصها:
فيما يلي نصها:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ والصَّلاةُ والسَّلامُ على َأشرفِ الخَلقِ أجمعينَ مُحمدٍ وآلهِ الطَّاهرينَ.
قال تعالى:﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾[1] ، إن خلافة الإنسان في الأرض هدفها الإصلاح وعمارة الأرض.. الإصلاح بمعناه الشمولي الذي يتناول جميع أبعاد كل ما يرتبط بحياة الإنسان نفسه، وإصلاح الناس وكذلك إصلاح الأرض، يقول تعالى على لسان نبيه شعيب  :﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾[2] .
:﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾[2] .
فالإصلاح مهمة جميع الأنبياء  ، وإطلاقها يفيد الشمولية، ليستوعب جميع الأبعاد المرتبطة بالإنسان على اختلافها وتنوعها.
، وإطلاقها يفيد الشمولية، ليستوعب جميع الأبعاد المرتبطة بالإنسان على اختلافها وتنوعها.
![]() دوائر التعامل:
دوائر التعامل:
الإنسان في تعامله محاط بدوائر أربع، كما نقل ذلك عن الإمام الصادق  ، حيث يقول:«أصول المعاملات تقع على أربعة أوجه: معاملة الله، ومعاملة النفس، ومعاملة الخلق، ومعاملة الدنيا..» [3] .
، حيث يقول:«أصول المعاملات تقع على أربعة أوجه: معاملة الله، ومعاملة النفس، ومعاملة الخلق، ومعاملة الدنيا..» [3] .
كيف يتعامل الإنسان مع خالقه المنعم والمتفضل عليه.. وكيف يتعامل مع نفسه التي تهوي به نحو الدرجات السفلى، وتشده للدنيا.. وكيف يتعامل مع الناس، سواء أكان ذلك ضمن مجتمعه أو خارج حدود مجتمعه، وسواء أكان مسلما أم غير مسلم.. وأخيرا كيف يتعامل مع البيئة والمحيط والأرض وكنوزها وثرواتها المختلفة؟
هذه هي الدوائر الأربع التي تحوط بالإنسان، والتي نحتاج لفهمها كي ندرك واجباتنا تجاهها.
إن هذه الإحاطة الرباعية الأضلاع، لها حدود وأطر لكيفية التعامل وما يجب فعله وسلوكه، ولسنا بصدد ذكرها، وإلا لخرج البحث عن مجاله.
ولكن ما يهمنا هو الإجابة على هذا التساؤل:
• كيف نكون فاعلين؟
ولكي نكون فاعلين على المستوي الشخصي الذاتي، وعلى المستوى الاجتماعي، لابد من اتخاذ الرسول  ، قدوة وأسوة، وهذا هو القرآن الكريم يحدثنا عن خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرم
، قدوة وأسوة، وهذا هو القرآن الكريم يحدثنا عن خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرم  ، حيث يقول:﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾، فالخطاب عام وشامل، لما يدل عليه حذف الموضوع، أي موضوع الفراغ، وقد ذكر المفسرون عدة معان كما ينقل ذلك الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره:
، حيث يقول:﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾، فالخطاب عام وشامل، لما يدل عليه حذف الموضوع، أي موضوع الفراغ، وقد ذكر المفسرون عدة معان كما ينقل ذلك الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره:
المقصود: إنك إذا فرغت من فريضة الصلاة فادع الله واطلب منه ما تريد.
- عند فراغك من الفرائض انهض لنافلة الليل.
- عند فراغك من أمور الدنيا ابدأ بأمور الآخرة والصلاة وعبادة الرب.
- عند فراغك من الواجبات توجه إلى المستحبات التي حثّ عليها الله.
- عند فراغك من جهاد الأعداء انهض إلى العبادة.
- عند فراغك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد النفس.
- عند انتهائك من أداء الرسالة انهض لطلب الشفاعة.
- ومنها إذا فرغت فانصب عليا بالولاية.
هذه معان ذكرها المفسرون حول الآية، فموضوع «الفراغ» لم يذكر، ولكمة «فانصب» من النصب أي التعب والمشقة، ولذلك فالآية تبيّن أصلاً شاملاً. وهدفها أن تحث النبي  ، باعتباره القدوة على عدم الخلود إلى الراحة بعد انتهائه من أمر هام. وتدعوه إلى السعي المستمر.. [4] .
، باعتباره القدوة على عدم الخلود إلى الراحة بعد انتهائه من أمر هام. وتدعوه إلى السعي المستمر.. [4] .
فهذا التوجيه الإلهي وهذا الحث مدعاة لترك الخمول والكسل، فإن الفراغ من أهم عوامل الملل والخمول والركون للدعة والراحة، فهو في نهاية المطاف يؤدي إلى الفساد والسقوط، يقول الإمام علي  :«إن يكن الشغل مجهدة، فاتصال الفراغ مفسدة [5] ».
:«إن يكن الشغل مجهدة، فاتصال الفراغ مفسدة [5] ».
![]() أولا: التأهيل الفكري والثقافي
أولا: التأهيل الفكري والثقافي
أي مضمار من مضامير الحياة، أو أي عمل يريد الإنسان أن يقوم به، إذا لم يكن على علم بخصوصياته أو بشكل إجمالي، فإنه لا يستطيع التعامل معه بشكل سليم، لذلك لابد من المعرفة ولو الجزئية بالشيء قبل الإقدام عليه.
يقول الإمام علي  :«الناس أعداء ما جهلوا»، فالجاهل بالشيء يكون عدوا له لعدم تمكنه من التعامل معه ولقلة خبرته وتجربته.
:«الناس أعداء ما جهلوا»، فالجاهل بالشيء يكون عدوا له لعدم تمكنه من التعامل معه ولقلة خبرته وتجربته.
ولكي يكون المؤمن فاعلا، عليه أن يثقف ذاته وأن يتزود بالعلم والمعرفة، لأنها سلاح يحارب الجهل به، ويمكن له أن يقف على الأمور الجوهرية التي يحتاج إليها، أما عندما يجهل الإنسان، ولا يكلف نفسه طلب العلم والتزود بالمعرفة، فإنه حينها يكون ميتا وإن كان يعيش بجسده، فإن في العلم والمعرفة حياة الأمم والأفراد معا.
إن الجاهل بأبسط الأمور التي يتعاطى معها لا يمكنه أن يؤدي دوراً مهماً.
فلو تعطل محرك السيارة، فإننا نأخذها للمختص، وليس لغيره. والذي لا يمتلك أدنى معرفة بأمر ما، وليس عنده كفاءة يمكن الاعتماد عليها، لا يمكنه التعامل مع المجهول، والطبيب إذا لم يكن ملما بالأمراض وأعراضها فإنه لا يمكنه أن يصف الدواء الناجع لها.
إن تعاليم السماء قد أكدت في أكثر من مورد، على ضرورة طلب العلم والتزود بالمعرفة، يقول الرسول الأكرم  :«أطلبوا العلم ولو بالصين»، ويقول الإمام الصادق
:«أطلبوا العلم ولو بالصين»، ويقول الإمام الصادق  :«ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا..».
:«ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا..».
ويقول أمير المؤمنين  :«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»، فلا تختلط لديه الأوراق، ولا يتخبط في التيه، بل تكون الأمور لديه واضحة جلية كفلق الصبح، أما حينما يركن للجهل، و لا يكلف نفسه عناء التسلح بسلاح العلم والمعرفة، فإنه يكون متخبطا، لا يعرف متى يتحرك أو كيف يتعامل.
:«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»، فلا تختلط لديه الأوراق، ولا يتخبط في التيه، بل تكون الأمور لديه واضحة جلية كفلق الصبح، أما حينما يركن للجهل، و لا يكلف نفسه عناء التسلح بسلاح العلم والمعرفة، فإنه يكون متخبطا، لا يعرف متى يتحرك أو كيف يتعامل.
![]() ثانيا: الإخلاص
ثانيا: الإخلاص
الإخلاص ضد الرياء، بأن يكون العمل بأي أنواعه رياء، سواء أكان العمل العبادي أم الاجتماعي، فالإخلاص هو أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تشوبه شائبة المصلحة أو الوجاهة أو نحو ذلك.
والأعمال يتقبلها الله تعالى من العبد إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، يقول الإمام علي  :«إنك لن يتقبل من عملك إلا ما أخلصت فيه[6] »، ويقول الرسول الأكرم
:«إنك لن يتقبل من عملك إلا ما أخلصت فيه[6] »، ويقول الرسول الأكرم  :«الناس كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم».
:«الناس كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم».
![]() وثمرته الآتي:
وثمرته الآتي:
1/ اللطف الإلهي.. فإن الله تعالى يمنح لطفه ورحمته لعباده المخلصين، لأنهم قصدوه وحده في عملهم وجهادهم.
2/ التفاف الناس.. فالذي يجعل همّه هو قبول الله لعمله، والذي لا يعمل من أجل رضا الناس، بل من أجل وجه الله وحده، فإن الناس عندها سوف لن يتخلوا عنه، بل سوف يلتفون حوله، يعاضدونه ويساندونه.
3/ قبول العمل.. لا يقبل الله تعالى عمل من كان يعمل لله ولغير الله، فكيف إذا كان العمل ليس لله بل للغير، وكما ورد:«فما كان لي ولغيري جعلته لغيري».
4/ النجاح.. أي عمل يراد له النجاح، لابد أن يكون منطلقا من صميم الرسالة، وقد وعد الله تعالى عباده بالتوفيق والنجاح والهداية لأفضل السبل والطرق بقوله:﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾[7] .
![]() ثالثا: الصمود والاستقامة
ثالثا: الصمود والاستقامة
كثير هم الذين يبدؤون الأعمال، ويؤسسون المشاريع الإنمائية والاجتماعية والدينية، ولكن الكثير أيضا يتراجعون، ويتوقفون عن مهامهم بحجج.. كعدم تفاعل الناس، أو وجود النقد والانتقاد، أو يصاب بالملل والكسل، أو غير ذلك من أسباب.
إن الدنيا لم تبنَ على الراحة والدعة، بل هي محل ابتلاء وشقاء، ومن طابعها الكدح وبذل الجهد للوصول لما يطمح إليه الإنسان، يقول تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾[8] . يحتاج المسلم إلى الكدح والعناء ليصل، حال ذلك حال أي عمل يقوم به، فإنه يحتاج منه إلى بذل الجهد.
والمسألة ليست في بدء أي عمل، ولكن التساؤل هو في الاستمرارية على ذلك العمل وعدم تركه إلا للأفضل، يقول الإمام الصادق  :«إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالا»[9] . ويقول أيضا
:«إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالا»[9] . ويقول أيضا  :«من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها».
:«من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها».
فإن التعود على العمل لضمان استمراره من جانب، ومن جانب آخر فإنه يتحول إلى عادة تعودها الإنسان فمن الصعب عليه الإقلاع عنها، حيث أنها أصبحت جزءا من نشاطه اليومي.
يقول الإمام علي  :«العمل العمل، ثم النهاية النهاية، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، والورع الورع، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ..» [10] .
:«العمل العمل، ثم النهاية النهاية، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، والورع الورع، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ..» [10] .
![]() رابعا: عدم الانشغال بالهامشيات والجزئيات
رابعا: عدم الانشغال بالهامشيات والجزئيات
إن الانشغال بالهامشيات والجزئيات مدعاة لتبديد الطاقات وصرفها في غير محلها، لأنه لا يمكن أن توزع الطاقات والقدرات في الأمور الجزئية والهامشية وكذلك في الأمور العامة والجذرية معا.
إن التوجه لكثرة الأعمال وتنويعها، يدعو لبعثرة الطاقات، وقدرة الإنسان محدودة، وتوزيعها في الأمور الجانبية يأخذ وقتا وجهدا، لأنها لا تنتهي، فكلما انتهى من جزئية برزت جزئية أخرى وهكذا. فالمقياس للفاعلية ليس بكثرة الأعمال وتوزيعها، بل بالتركيز على أمهات القضايا والمشاريع الهادفة التي يكون فيها النتاج شاملا. وكما نقل عن الإمام علي  مخاطبا ولده الإمام الحسن
مخاطبا ولده الإمام الحسن  :«بني إذا رأيت الناس اتجهت إلى كثرة العمل، فعليك بصفو العمل..».
:«بني إذا رأيت الناس اتجهت إلى كثرة العمل، فعليك بصفو العمل..».
ثم أن الانشغال بالهامشيات يجعل الإنسان نفسه في زاوية ضيقة حرجة، لا يمكنه التخلص منها لعدم انتهاءها إلى نهاية.
يحدثنا القرآن الكريم عن أصحاب البقرة عندما أمرهم الله تعالى أن يذبحوها، كيف أنهم ضيقوا على أنفسهم وقد كانوا في غنى عن ذلك كله، وعند ذلك لم تكن أمامهم مندوحة إلا ذبح تلك البقرة الخاصة دون سواها، مع الخطاب الإلهي قد جاء مطلقا، حيث أمرهم أن يذبحوا بقرة لا بشرط، ولكن مع مكابرتهم وعدم اهتمامهم، بدئوا بطرح الأسئلة.. ما لونها هل هي فارض أم غير ذلك، وهل.. وهل.. فضيق الله عليهم لأنهم أرادوا التضييق على أنفسهم.![]() خامسا: إبداع العمل
خامسا: إبداع العمل
المسلمون أمة التقدم والحضارة الإنسانية، وهم أول من وضع الأسس والقواعد العلمية لكثير من الإنجازات، ولسنا في معرض الحديث واجترار الأمجاد السابقة.
فإن في تاريخنا الإسلامي الكثير من الأسماء التي استفاد الغرب من نظرياتهم وتجاربهم، أما نحن فقد أغفلنا كل تلك الثروة الهائلة ولم نستطع توظيفها في حاضرنا لمستقبلنا، فإن اسم جابر بن حيان، والشيخ الرئيس ابن سيناء، ونصير الدين الطوسي، والبيروني وغير هؤلاء الكثير ممن أثروا الساحة العلمية والفكرية بإنتاجياتهم، قد نذروا أنفسهم للعلم والمعرفة، وقدموا للأمة تلك الإنجازات والنظريات العلمية.
لقد أبدع هؤلاء، فكروا وتأملوا، جربوا واخترعوا، وأما نحن فأمة انتظار الفعل لنقوم بردة فعل إما لنقد العمل والفكر وتشريحه، وإما لمحاكاته تفصيلا.
لقد كرم الله الإنسان على سائر ما خلق، ليس إلا لوجود العقل والإرادة، وإلا فلا يوجد هنالك فارق بينه وبين سائر المخلوقات الأخرى، يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾[11] فبالعقل أعطي هذا التكريم الإلهي، ولولاه لما استطاع الإنسان أن يطور حياته ويطور محيطه، وما وصلت إليه التكنولوجيا اليوم شاهد على ذلك.
وإبداع العمل سواء أكان فكراً ثقافةً، أم مشروعاً عملياً كالمؤسسات الاجتماعية في مختلف الميادين. المسلم اليوم في الغالب، ينتظر ما يطرحه غيره، ثم إما أن يقوم بنقده وتفنيده، أو يقوم بمحاكاته، ولا يكلف نفسه عناء التأمل والتفكر كي يكون مبدعا منتجا. إن الفاعلية تكون بالأفعال لا بردودها، فلماذا ننتظر غيرنا يطرح إنتاجه، وبعد ذلك نعقب عليه؟!
![]() سادسا: استقلال العمل
سادسا: استقلال العمل
إن من الأمور التي تقوض وتنهي الأعمال هو أن يرى الواحد منا عمله كثيراً وكبيراً وضخماً. هذه النظرة تؤدي إلى التوقف عن الواجبات وتحمل المسؤولية، لأنها تُشعرُ الإنسان بالاكتفاء، وتقتل عنده الطموح. يقول أمير المؤمنين  :«ولقد خالطهم أمر عظيم! لا يرضون من أعمالهم بالقليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون»، ورد عن الرسول الأكرم
:«ولقد خالطهم أمر عظيم! لا يرضون من أعمالهم بالقليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون»، ورد عن الرسول الأكرم  قوله:«لو كان لرجل عمل سبعين نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ»[12] ، فالتقدم والتطور لا يأتي إلا بعملية الحراك، وتحويل الجهد ليصب في قنواته الطبيعية الفاعلة.
قوله:«لو كان لرجل عمل سبعين نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ»[12] ، فالتقدم والتطور لا يأتي إلا بعملية الحراك، وتحويل الجهد ليصب في قنواته الطبيعية الفاعلة.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.