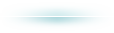سيهات: الشيخ الرواغة «مفهوم العبادة»

القى سماحة الشيخ صادق أحمد الرواغة «حفظه الله» يوم الجمعة بتاريخ 2 جمادى الثانية 1426هـ الموافق 8 يوليو 2005م في مسجد العباس بمدينة سيهات كلمة بعنوان «مفهوم العبادة»..
بمدينة سيهات كلمة بعنوان «مفهوم العبادة»..
قال أمير المؤمنين  مخاطبا كميل بن زياد:« يا كميل بن زياد، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصلاة بقلبٍ نقي، وعملٍ عند الله مرضي، وخشوعٍ سوي، وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول» [1] .
مخاطبا كميل بن زياد:« يا كميل بن زياد، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصلاة بقلبٍ نقي، وعملٍ عند الله مرضي، وخشوعٍ سوي، وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول» [1] .
 الدين الإسلامي مركب من أقسام خمسة:
الدين الإسلامي مركب من أقسام خمسة:
• الأصول العقدية كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما يرتبط بها من تفرعات.
• العبادات كالصلاة والصوم والحج وغيرها.
• الأخلاق وتهذيب النفس كالصدق والوفاء وأداء الأمانة وسائر ما هو مرتبط بهذا البعد.
• المعاملات كالرهن والبيع والمعاطاة والمضاربة وغيرها من سائر العقود الأخرى.
• الأحكام كالحدود والقصاص والديات.
فهذه بمجملها تشكل الدين الإسلامي بمنظومته المتكاملة التي تحكم العلاقات البشرية وترسم الأطر والحدود لها، وتضع الهيكلية العامة للتعامل والسلوك. والعبادات والأخلاق سارية في الأقسام الأخرى، ولا يمكن فصلهما عنها بحال، فإن العبادة تتداخل والمعاملات وغيرها.
العبادات الإسلامية ليست هي المقصودة بالذات، فليست الصلاة مطلوبة لذاتها ولا الصيام لذاته وهكذا سائر العبادات الأخرى، وإنما أهدافها وغاياتها النتيجة التي تؤدي إليها تلك العبادة، وهي التقوى وتحصين الإنسان من الانحراف. أما أن تبقى العبادة جامدة تؤدى بحركاتها وسكناتها وألفاظها، فإن ذلك يحولها إلى مجرد قشور وطقوس بلا مضمون، بعيدة كل البعد عن اللب والجوهر، وإن كان الواجب يسقط بالامتثال حين أداءها ويخرج بها من عهدة التكليف، ولكنها تكون في حيز عدم الفاعلية.
صحيح أن الله تعالى قد خلق الخلق من أجل العبادة حيث يقول سبحانه وتعالى:﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[2] ، ولكن ليس العبادة بمعناها السلبي الجامد، وهو مجرد الإتيان بها وأدائها والتخلص من التكليف، بل العبادة بمعناها الإيجابي المتحرك، الذي يحولها إلى عملية ثورية تغيّر ما عليه الإنسان دائما، وتطال داخله كما تطال خارجه وواقعه الذي هو عليه من صفات سلبية وسلوك مشين، يقول تعالى:﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ﴾[3] ، فنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر هو غايتها وهدفها.
ويقول عز وجل في فلسفة الصوم:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[4] ، فغاية الصوم هو إيجاد الحصانة لدى الإنسان ضد الانحراف والأخلاق الذميمة، من دون فرق بينه وبين أبناء المجتمع، أو بينه وبين أفراد أسرته حتى وإن كان أباً أو أماً، فهذا المقام لا يسوغ لهم التصرف بأخلاق فظة، أو يمارسون الظلم في بيوتهم.
إن البعد والقرب من الله تعالى يقاس بمقدار نهي الصلاة أو قل نهي العبادات عن الفحشاء والمنكر، يقول النبي الأكرم  :«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعداً» [5] .
:«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعداً» [5] .
ويقول  أيضاً:«لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وإطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» [6] ، فما قيمة الصلاة إذا لم تنه عن ارتكاب الفحش صغيرا كان أم كبيرا، في بيته أم في خارجه؟!
أيضاً:«لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وإطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» [6] ، فما قيمة الصلاة إذا لم تنه عن ارتكاب الفحش صغيرا كان أم كبيرا، في بيته أم في خارجه؟!
فتأكيد الإمام  على الصلاة وإفرادها إنما هو باعتبار كونها المركز لكل العبادات، وكونها عماد الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، فهي المحور الذي يقوم عليه قبول سائر الأعمال العبادية، لأنها تشكل عمق الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وكونها أظهر مظاهر العبودية والضعف والاحتياج.
على الصلاة وإفرادها إنما هو باعتبار كونها المركز لكل العبادات، وكونها عماد الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، فهي المحور الذي يقوم عليه قبول سائر الأعمال العبادية، لأنها تشكل عمق الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وكونها أظهر مظاهر العبودية والضعف والاحتياج.
فالصلاة هي التصريح لدخول الأعمال بوابة القبول لكل أعمال الإنسان، فإن فقد التصريح أو زوّر وشوه أو كانت صلاحيته منتهية أقفلت تلك البوابة، ومُنعَ العمل من الدخول في سجل القبول. فعن أبي عبد الله الصادق  قال:«مَن أحبَّ أن يعلم أن صلاته قُبلت أم لم تُقبل، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر، فبقدر ما منعته قُبلت منه» [7] . ويقول الرسول
قال:«مَن أحبَّ أن يعلم أن صلاته قُبلت أم لم تُقبل، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر، فبقدر ما منعته قُبلت منه» [7] . ويقول الرسول  :«مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود، لم ينفع طنب، ولا وتد، ولا غشاء» [8] .
:«مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود، لم ينفع طنب، ولا وتد، ولا غشاء» [8] .
إن العبادة تحتاج لتناغم وانسجام بين النية والسريرة من جانب، وبين الجوارح والجوانح من جانب آخر، وأن تكون حالات الإنسان كلها منسجمة، وأن يتورع الإنسان عن ارتكاب الرذائل في بيته وفي خارجه، يقول الرسول  :«لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يقبل الله منكم إلا بورع» [9] .
:«لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يقبل الله منكم إلا بورع» [9] .
الإسلام دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، في المأكل والملبس، في المشي، في الكلام والحديث، في الإنفاق، وينبذ التطرف بألوانه وأشكاله، فلا يقدم جانبا على حساب جانب آخر، بل يدعو للتوازن والاعتدال وأخذ الطريق الوسط، حتى على مستوى الدنيا والدين أو الدنيا والآخرة، فقد روى ابن شعبة الحراني في تحف العقول عن الإمام الصادق  قوله:«ليس منا من ترك دنياه لدينه، أو ترك دينه لدنياه»، ويقول
قوله:«ليس منا من ترك دنياه لدينه، أو ترك دينه لدنياه»، ويقول  :«ليس منا من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه» [10] .
:«ليس منا من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه» [10] .
 نقاء القلب
نقاء القلب
سلوك الإنسان يحكي ما في داخله، إذ أن الظاهر مرآة الباطن، وهو صورة حقيقية لسريرته، ولا يمكن الفصل بينهما، فمن حسن الظاهر حسن الباطن، يقول الإمام علي  :«اعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله، فما طاب ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه» [11] .
:«اعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله، فما طاب ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه» [11] .
ويقول الإمام زين العابدين  في دعاء مكارم الأخلاق:«وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات.. اللهم وفّر بلطفك نيتي». فصفاء القلب ونقاؤه يؤثر في ظاهر الإنسان إيجاباً، والعكس صحيح أيضاً.
في دعاء مكارم الأخلاق:«وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات.. اللهم وفّر بلطفك نيتي». فصفاء القلب ونقاؤه يؤثر في ظاهر الإنسان إيجاباً، والعكس صحيح أيضاً.
إن النفس هي مكمن الخطر، فإذا تحكمت في الإنسان وسيطرت عليه فإنه يكون عبداً لها تسوقه إلى حيث تشتهي.
وما الانحراف إلا لتحكم هذه النفس بأهوائها وشهواتها ونزعاتها في الإنسان، فلولا هذه السيطرة المحكمة لاستطاع أن ينجو، ولكنها تكبله بحبائلها ومكائدها، ويضعف هو لمطالبها فيسيّر نفسه وفق هواها وميولاتها ورغباتها. إن النفس ضعيفة من جانب وقوية من جانب آخر، ضعيفة أمام الشهوات والأهواء والمصالح، وقوية في إحكام قبضتها على الإنسان وتسييره إلى ما تصبو إليه.
والقرآن الكريم يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام:
وهي التي اطمأنت بالإيمان، وتخلصت من كل شوائب الأهواء، واستطاع المؤمن أن يجعل القياد دائما بيد العقل، لتغلبه عليها، يقول تعالى:﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [12] .
وهي التي تسول للإنسان ارتكاب المعاصي والذنوب، وتزين له ذلك، وكلما ارتكب ذنباً سولت له ارتكاب آخر وهكذا، فيبقى دائما في وثاقها، حيث يغيب نور العقل ويخبو بسبب سيطرة النفس عليه. يقول تعالى:﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [13] .
وهي التي تلوم صاحبها على ارتكاب المعصية، فكلما أسلس القياد لأهوائه وشهواته وغرائزه لامته وأيقظت ضميره كي لا يتمادى في غيه وغيبوبته. يقول الله عز وجل عنها:﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [14] . ويمكن التعبير عنها بالضمير الحي الذي يستجيب لنداء العقل فيقوم بكبح جماح النفس ونزعتها نحو الشر. إن سيطرة النفس على عقل الإنسان تؤدي به للهلاك والضياع.
إن إشكالية العلاقة بين النظرية والتطبيق الخارجي تكمن في مقدار انعكاس الإيمان الداخلي على العمل والسلوك، فهما مرآة ما في القلب. إن هذه الازدواجية يصفها الرسول الأكرم  بالنفاق حيث يقول:«إياكم وتخشع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع» [15] .
بالنفاق حيث يقول:«إياكم وتخشع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع» [15] .
فالصدق يكون في انسجام كلا الجانبين الباطني والظاهري على حد سواء، أما حينما تكون هناك حالة الفصل ووجود الازدواجية فإنه بذلك يفتقد المصداقية وسرعان ما يفتضح حاله وأمره بين الناس ويخسر كل ما أراد بناءه، يقول الإمام الصادق  :«ما من عبد أسرّ خيراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراً، وما من عبد يسرّ شراً فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شراً» [16] . ويقول أيضا:«من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح جوّانيه أصلح الله برّانيه، ومن أراد وجه الله أناله الله وجهه وجوه الخلق» [17] .
:«ما من عبد أسرّ خيراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراً، وما من عبد يسرّ شراً فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شراً» [16] . ويقول أيضا:«من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح جوّانيه أصلح الله برّانيه، ومن أراد وجه الله أناله الله وجهه وجوه الخلق» [17] .
فالذي يستمر في غيه وضلاله مكابرا معاندا، فإن الله تعالى لن يتركه يتمادى في ذلك، وسوف يأتي عليه يوم يكون فيه مفضوحا أمام الناس ويكتشف أمره، ولن يكون بينه وبينهم حالة من الصلاح. تهذيب النفس غاية العبادة
تهذيب النفس غاية العبادة
الدين الإسلامي ليس مجرد طقوس أو أطرٍ فارغة من المضمون والمحتوى تؤدى بشكل يومي روتيني أو في أزمنة خاصة، وإنما هو مجموعة القيم والنظم التي تحكم وتنظم العلاقات الإنسانية في جوانبها المختلفة.
فلا يمكن لنا أن نفرغ الدين من لُبابه ومحتواه، والتمسك بإطاره الخارجي الذي لا يعدو كونه ديكورا وشكلا، والتحلي بكل مظهر يوحي بحالة التدين الظاهري بعيدا عن الجوهر والعمق. إن غاية العبادة هي إيجاد الحصانة ضد الانحراف، الانحراف الأخلاقي والسلوكي، والانحراف الفكري والعقدي، وكذلك الانحراف عن كل قيمة ومبدأ أو مفهوم سماوي وخلق إنساني. يقول تعالى:﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ [18] . فالتزكية هي مجاهدة النفس وجهادها، والاشتغال بتهذيبها وتربيتها، يقول الإمام علي  :«من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل» [19] .
:«من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل» [19] .
أما حينما تتحول العبادة إلى مجرد طقوس ومظاهر يلتزم أصحابها بأدائها شكلا لا مضموناً، مع عدم مراعاة الجانب الأخلاقي والسلوكي، فإن الإنسان حينها يموت قلبه ويزداد من الله تعالى بعداً، وتضيع بذلك العبادات لأنها لا تؤدي دورها ورسالتها.
ويحدث ذلك لأن العقل قد دخل في سبات طويل وما عاد له نور يضيء الدرب ويكتسح ظلمة الجهل ويبددها.
أن الواقع المتخلف إنما أنتجه تحول العبادات إلى طقوس فارغة المعنى، لذلك يقول الإمام علي  لكميل بن زياد:«يا كميل بن زياد، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي، وعمل عند الله مرضي، وخشوع سوي، وأنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول».
لكميل بن زياد:«يا كميل بن زياد، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي، وعمل عند الله مرضي، وخشوع سوي، وأنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول».
التدين لا يعني التوغل في العبادات إلى حد الإفراط فيها والتركيز على بعدها الظاهري الشكلي، وتأكيد الإتيان بالمستحبات والمندوبات بأنواعها، بل التدين يعني إيجاد حالة الرفض التام لكل بدعة وفكر ليس له أساس في الدين الإسلامي، ولا نعني بذلك رفض كل فكر نير يراد منه خير الأمة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن التدين هو أن يعيش المسلم حالة التفاعل السلوكي والعملي، وأن لا يكون هناك تباين واختلاف بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.
إن المحافظة على الظهور بمظهر المتدين المحافظ على أدبه وأخلاقه أمام الناس، والذي يشعر الآخرين بالتزامه بقيم الدين ظاهرا، ولكن باطنه وسريرته خاوية سيئة، يبيّت النية الخبيثة لكل من يعارضه ويعمل في الخفاء ليرضي نزعاته ورغباته، ثم الادعاء بأنه أفضل الناس أو من أفضلهم، وأنه لا يظلم، وأنه يريد الخير للجميع، إن هذا الظهور المزيف لا يجديه نفعاً أمام الله تعالى العالم بالسرائر، ولابد أن يفضحه الله يوماً، وقد روي عن الإمام الصادق  قوله:«ما ينفع العبد يظهر حسناً ويسر سيئاً، أليس إذا رجع إلى نفسه، علم أنه ليس كذلك، والله تعالى يقول:﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ إن السريرة إذا صلحت قوية العلانية» [20] .
قوله:«ما ينفع العبد يظهر حسناً ويسر سيئاً، أليس إذا رجع إلى نفسه، علم أنه ليس كذلك، والله تعالى يقول:﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ إن السريرة إذا صلحت قوية العلانية» [20] .
فالتدين هو أن يكون الباطن والظاهر بمعنى واحد وحال واحدة، وليس مجرد مظهر يتحلى الإنسان به أمام الآخرين لكي يمدحوه ويثنوا عليه.
أما حينما يكون التدين موافقا للخطأ الذي يدين به الآخرون، يتبع آراءهم ويطيعهم فيما يغضب الله، أو يتماشى والوضع السائد كالظواهر الاجتماعية السلبية غافلاً عن أحكام الإسلام، ليرضي الناس وأهوائهم، أو إنكار حكم إلهي، فإن مثل هذا التدين مرفوض جملة وتفصيلاً.
يقول الإمام الباقر  :«لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله» [21] .
:«لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله» [21] .
على المؤمن في تحركاته وسلوكياته وأقواله وأفعاله أن يضع الله تعالى نصب عينيه، ويشعر نفسه دائماً بأنه يحصي عليه حركاته وسكناته، فإن توغل الإنسان في المعصية إنما يكون لعدم خشيته وخوفه من الله تعالى، فلو أنه تذكر دائما أن هناك عقاباً وحساباً ووقوفاً بين يدي جبار السماوات والأرض، وأنه سوف يحاسب على كل حركة قام بها وإن صغرت، فإن هذا الاستحضار يكون رادعا له عن الاقتحام في الذنوب والمعاصي.
﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [22] . ويقول الإمام علي  في صفة المتقين:«ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كم قد رآها، فهم فيها معذبون» [23] .
في صفة المتقين:«ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كم قد رآها، فهم فيها معذبون» [23] .
هكذا تفعل الخشية من الله في القلوب الصادقة التي يهمها مستقبلها الأخروي، لذلك لا تراهم يظلمون أنفسهم ولا يظلمون أحداً من الناس. وأن تكون أعمالهم وسلوكياتهم منسجمة مع العبادة، والشأن فيها قلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.