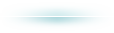العلامة العوامي في حوار مع جمعية التوعية الإسلامية
وجهت جمعية التوعية الإسلامية مجموعة من التساؤلات لسماحة العلامة الشيخ فيصل العوامي دام عزه ، تتعلق بالقراءات المعاصرة للدين ونزعة الأنسنة التي يدعو إليها العديد من المفكرين المعاصرين، على أن تنشر أجوبتها في مجلة التوعية اٌلإسلامية.
وأدناه الأسئلة كما وردت من الجمعية، ثم إجابات العلامة العوامي :
الأسئلة:
المحور الأول : إثارة وتعريف
س1 : سماحة الشيخ، يثير البعض على أن إثارة مثل هذه المواضيع كإشكالات الحداثة و الأنسنة وغيرها ومحاولة الرد عليها، يعطي نتائج سلبية أكثر من إيجابيته، لأن أكثر طبقات المجتمع ليست مطلعة عليها، بينما إثارتها هي التي تحفز المجتمع للانجرار نحوها. ما هو تعليقكم؟
س2 : في كلمة لليزدي في زيارته للبحرين مؤخراً، وصف هجمة الهرمونيطيقيا وأحاديث الأنسنة بأنها من أخطر المراحل التي تهدد الإسلام، هل لكم أن تبينوا لنا ماذا تعني الهرمونيطيقيا ومحاولات أنسنة النص؟ وماهي مناطق مصادمتها مع الفكر الإسلامي؟
المحور الثاني : إشكالات ومناطق مصادمة مع الثوابت
س3 : الإشكال الأول الذي يطرحه البعض هو هل هناك نظرية محددة في تأويل القرآن وتفسيره؟ ومن الذي حددها؟
س4 : إشكالية رائجة هذه الأيام مفادها أن "التأويل والتفسير حالة تدل على أن هناك حرية للقارئ في إسباغ استنتاجه على النص، فمجال الإختلاف مفتوح إذاً، لك تأويلك إذاً وللآخرين تأويلهم، بينما نشاهد أن البعض يحاول أن يضع تأويله أو تفسيره للقرآن بمثابة النص ذاته، ويفرضه كوصاية إلهية على الناس، بينما هي لا تمثل سوى تفسيره وتأويله هو". كيف تناقشون ذلك سماحة الشيخ؟
المحور الثالث : التفسير بديل الأنسنة
س5 : سماحة الشيخ قبل أن نطرح بدائل التفسير في مجال الأنسنة، ربما تكون الأنسنة كمشروع يعاني من الخلط بين مفهومي التفسير و الاستنباط. هل لكم أن توضحوا ذلك؟
س6 : أصحاب مشاريع الأنسنة يقولون أن سمة مشروعهم أن "العقل ينازع العقل بالعقل لإفادة العقل"، في المقابل هل تعتقدون أن التفسير يعني إغلاق العقل؟ وما هو دور العقل في ساحة التفسير؟
• هل من كلمة أخيرة؟
أجوبة سماحة العلامة الشيخ فيصل العوامي دام عزه
بسم الله الرحمن الرحيم
المحور الأول:
الجواب الأول: قد لا أتفق بنحو مطلق مع مثير هذا التصوّر، إذ ليس هناك حظر شرعي يمنع من إثارة الأفكار والنظريات المغايرة لمجرد مغايرتها وعدم انسجامها مع الثقافة الدينية، فالقرآن الكريم أثار العديد من التصورات الخاطئة في معرض تأسيسه للرؤى الدينية، كما في قوله تعالى:(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (يونس:48)، وكما في الآيات 51-54 من سورة الزخرف، التي تضمّنت إشكالات فرعون على نبوة نبي الله موسى(?)، وأمثال ذلك كثير ليس في القرآن فحسب وإنما في الروايات أيضاً.
بل هو أمر جرت عليه سيرة العلماء قديماً وحديثاً، إذ من عادتهم في بحوثهم العلمية عرض النظريات الأكثر خطورة على الدين والقيم قبل مناقشتها.
فأصل الإثارة بغض النظر عن أي عناوين ثانوية ليس فيه حظر من جهة الشارع المقدس، وإن كان في النصوص الشرعية ما يظهر منه وجوب الرد على أي فكرة إذا صدق عليها عنوان الفتنة، حيث روى يونس بن عبد الرحمن عن الصادقين(?): (إذا أقبلت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا سُلِب نور الإيمان).
نعم إذا كانت الأفكار المغايرة ضرباً من الشك، ولم يحرز بخصوصها علمٌ وجداني أو تعبدي، وكانت إثارتها بغرض التشكيك للرأي العام، أو كانت بطبيعتها تستلزم التشكيك، فالظاهر من النصوص الشرعية حرمة إثارتها والله العالم، لما ورد حول حرمة تداول ونشر كتب الضلال، وحرمة إثارة التشكيكات، كما يظهر من الآيات 51-56 من سورة الصافات، وما أشبه. ولذلك فإنها لو أثيرت في محافل خاصة بعيداً عن الرأي العام فلا إشكال.
أما إذا كانت الفكرة المغايرة تستند إلى علم وجداني أو تعبدي، ومغايرتها مجرد مغايرة لفكر سائد لا أكثر، فلا إشكال من إثارتها، ولو كان صاحب العلم هذا يعلم من جهة أخرى بخطأ ذلك الفكر السائد وجداناً أو تعبداً، فآنئذ يجوز له إثارة فكرته المغايرة حتى على نحو التشكيك، كما فعل خليل الله إبراهيم(?) مع قومه عندما رأي الكوكب والقمر والشمس وكرر القول:(أهذا ربي) على نحو التشكيك.
وأعتقد أن إثارة القرآن الكريم والروايات وكذلك العلماء للأفكار المغايرة عند تأسيس الأفكار الدينية، هو تعبير عن الإعتزاز بالفكر الديني، وأنه إلى درجة من القوة بحيث لا يمكن أن يصرعه أو يشوهه فكر آخر، فترى القرآن الكريم يأتي بأخطر الأفكار ثم يجيب عليها بأدق الأجوبة بحيث لا يدع مجالاً للشك أبداً. لذلك فإن التخوّف الذي نلحظه كثيراً في الأوساط الثقافية الدينية من إثارة الأفكار المغايرة، ما هو إلا نوع من ضعف الثقة بالفكر الديني، واستعداد مسبق للهزيمة أمامه، وقد يكون أيضاً كاشفاً عن ضعف القدرات العلمية عند المثقف الديني. أما المتمكِّن والمتعمِّق في الفكر الديني فلا أعتقد أن الأفكار المغايرة تخيفه.
ثم أن الفكرة المغايرة مهما كان مستواها التشكيكي، لا يمكن حجبها في مثل هذا العصر، فهي ستقال من قبل غيرنا لأن وسائل عندهم أقوى منا بكثير، فأن نقولها نحن ونناقشها غير من دس الرأس في التراب. فنحن - بحسب المثل الصيني- لا نستطيع أن نمنع العاصفة، ولكننا نستطيع أن نقوي الشجر.
الجواب الثاني: المشروع الهرمنوطيقي كتساؤلات علمية - وليس علماً مستقلاً، إذ لم ترق تساؤلاته بعد لمستوى العلم المقنن- يتضمن عدة مبادئ مهمة تنتهي في نهاية المطاف إلى القول بالمدخلية المطلقة للزمان والمكان في الأفكار، وعدم الإعتراف بإمكانية صناعة الثوابت، وعدم القدرة على تشخيص مراد المتكلم -النص-، ومن أهم تلك المبادئ:
1- تأثر القراءة للنص بأفق المعاني عند القارئ.
2- تأثر القراءة بالقابليات المسبقة للقارئ.
3- عدم إمكان إحراز فهم ثابت غير متحرك للنص، فالقراءات لا متناهية، ولا يمكن إدعاء الثبات في أحداها.
4- ليس المطلوب من قراءة النص معرفة المراد الجدي للمتكلم، فالقارئ يقرأ النص فقط، وبالتالي فهو لا يعنيه مقصود الناظم للنص.
فإذا كانت القابليات الذهنية مختلفة من شخص لآخر، وكذلك أفق المعاني، ولم يكن مراد المتكلم ذا أهمية في القراءة، فالنتيجة الطبيعية عدم إمكان إحراز فهم ثابت، إذ لا معايير ولا ضوابط تحدد الفهم الصحيح من غيره، كما تفترض الهرمنوطيقا.
بناء على ذلك فإن الهرمنوطيقا تتصادم مع الفكر الديني في منطقة الثابت المتغير، فالفكر الديني يؤكد وجود الثوابت والمتغيرات، بينما الهرمنوطيقا لا تقر بالثوابت وتصر على دخول كل الإبداعات الفكرية في حيز المتغيرات، وبالتالي تكون كل أحكام الدين متغيرة.
هذه صورة مختصرة جداً للمشروع الهرمنوطيقي، وللإستزادة يمكن مراجعة دراسة مفصلة نشرتها في مجلة القرآن نور، العدد الثاني.
لكن هنا ينبغي القول أن تساؤلات الهرمنوطيقا تبقى تساؤلات علمية ينبغي أن تبحث بعيداً عن أي توتر مسبق، لأنها قد تثري البحث الديني في بعض جوانبه، وإن لم نقبل بأكثر معطياتها.
ثم إن هذه التساؤلات ليس جديدة على البحث الديني، الفقهي والأصولي منه على وجه الخصوص، فقد تولّدت في داخل هذا البحث تساؤلات شبيهة بتساؤلات الهرمنوطيقا من عهد قديم، وقدِّمتْ لها إجابات كثيرة، وإثارة الهرمنوطيقا من جديد قد يستفز الباحث الفقهي لتجديد النظر وتعميق الأجوبة، وهو أمر حسن على كل حال.
وبحوث مثل المورد والوارد، والقضية الحقيقية والخارجية، والإعتبار، والعديد من مباحث الألفاظ، وما أشبه من المباحث الأصولية، كلها تتضمن تساؤلات من صميم التساؤلات الهرمنوطيقية، وقدم البحث الأصولي فيها أجوبة دقيقة جداً. ولذلك فإننا لا ننظر إلى التساؤلات الهرمنوطيقية بصفتها تساؤلات جديدة، وإنما نعتبر إثارتها من جديد نوع من المراجعة للأجوبة القديمة، ولا أعتقد أن في هذا ما يخيف.
المحور الثاني:
الجواب الأول: قيل في التأويل نظريات متعددة، فبعض اعتبره تطبيق للمعنى الحقيقي للآية الذي يصل إليه المفسّر بعد تأمل كاف، ولا يمكن أن يكون هناك ظاهر آخر يخالفه، في حين اعتبره بعض بأنه كشف عن المعنى الخفي الذي قد يكون مخالفاً لظاهر الآية، واعتبره بعض المفكرين المعاصرين بأنه ما يتشظّى على مستوى الأذهان المتكثرة، من خلال تقسيمه النص لنص تنزيل وتأويل، فالأول هو النص قبل نزوله، والثاني النص بعد نزوله، فإذا نزل إلى الإنسان تشظى بعدد أذهانهم، مستنداً في ذلك بما أثر عن النبي(ص): (إختلاف أمتي رحمة)، ففهم البشر للنص مع تعدده اللامتناهي هو التأويل، وآخرون نظروا إليه على أنه عبارة عن القدرة على التفريخ المستمر للنصوص القرآنية، باعتبار أن النص القرآني لا متناه.. وما إلى ذلك من النظريات.
لكن الذي يبدو للنظر أن التأويل غير ذلك، والمبيّن لمعناه الحقيقي إنما هو القرآن الكريم نفسه.
فالتأويل من الأوْل، وهو الرجوع، وهو هنا بمعنى إرجاع الظاهر من الكلام إلى حقيقته. (والظاهر من الكلام) أعني به ما كان محكماً أو متشابهاً، فهو في البداية يظهر منه معنى سواء كانت الآية محكمة أو متشابهة، والتأويل يرجع ذلك المعنى إلى حقيقته.
ومما يشهد على شمول التأويل للمحكم من الآيات ما ورد عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله(ع): أخبرني عن قول الله عزوجل (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعاً) قال: من حرق أو غرق، ثم سكت، ثم قال: تأويلها الأعظم: أن دعاها فاستجابت له."الكافي للكليني، ج2 ص211".
وما ورد عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر(ع): قول الله عزوجل ? في كتابه (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعاً)؟ قال: من حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الأعظم."الكافي، ج2 ص210".
هذا بالنسبة للمحكم، وأما المتشابه فالأمر فيه واضح، باعتبار أن المتشابه يستبطن الخفاء بطبيعته.. ورجوع الضمير إلى خصوص المتشابه في قوله تعالى:(وما يعلم تأويله) لا يعني انحصار التأويل فيه، وما ذكر في الآية إلا لمناسبة المقام، وإلا فإن الروايتين السابقتين تدلان على شمول التأويل للمحكم أيضاً.
وبذلك افتُرِض في المراد الحقيقي الخفاء حتى لو كانت الآية محكمة فضلاً عن المتشابهة، ولهذا فالتأويل يهتم بإبراز وإيضاح المراد الخفي - المراد غير الظاهر-.
والمعنى الخفي ليس من الضرورة أن يكون مخالفاً بصورة تامة للمعنى الظاهري، فقد يسير معه في خط واحد، كما في تأويل قوله تعالى:(ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعاً)، وقد يكون مخالفاً له لكن لا بمعنى الصدق المخالف للكذب - لأن ذلك يلزم منه كذب المعنى الظاهري وهو محال على الحكيم سبحانه وتعالى- ولكنه بما له من عمق وشدة خفاء أصبح وكأنه مبائناً للمعنى الظاهري، كما في قصة موسى(ع) مع العبد الصالح:(ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً)(الكهف: من الآية82)
كما أن المعنى الخفي تارة يرتبط بأصل الفكرة - المعنى- حيث تكون خفية، وتارة يرتبط بالمصداق الذي يكون خفياً أيضاً، فتأويل يوسف(ع) لأكل الخبز من قبل الطير من على رأس صاحبه في السجن:(قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ )(يوسف: من الآية37) إيضاح لأصل المعنى المراد، وتأويل الرسول(ص) للشجرة الملعونة بفئة معروفة من الناس:(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ )(الاسراء: من الآية60) إيضاح لمصداق خفي وهو التطبيق على الواقع الخارجي، فالتأويل تارة يكون إيضاحاً للمعنى، وتارة يكون تطبيقاً للمعنى على المصداق الخفي، ولذلك فالتأويل إيضاح لمراد يلزم فيه الخفاء سواء كان معنى أو مصداقاً.
الجواب الثاني: لا شك أن كل من له أهلية التفسير - والتأويل بناء على القول بشمول معنى الراسخ لغير المعصوم- له الحق في أن يلتزم بما يتوصل إليه من خلال محاولاته التفسيرية، ويتخلى عن الإلتزام بما يتوصل إليه غيره، ولا يحق لأحد مهما كان مستواه أن يفرض استنتاجاته على الغير باعتبارها الحق المطلق.
لكن لا يعني ذلك حرية القارئ في اسباغ استنتاجاته على النص في عمله التفسيري أو التأويلي، إذ من شروط القراءة للنص القرآني:
1- القبول بالنص، بمعنى التسليم به باعتبار أنه نص إلهي مطلق.
2- التسليم بالمعنى المستنبَط، وذلك يستلزم الخضوع أمامه وإن خالف الهوى الشخصي للقارئ. وهو ما أُكد عليه في قوله تعالى:(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا )(آل عمران: من الآية7)، فالراسخون في العلم إذا توصلوا لمعرفة المعنى المراد سلّموا أمامه وعملوا به وإن خالف أذواقهم الشخصية، إذ لا يصح فرض الهوى والذوق الشخصي على النص والمعنى المراد، كما صرّحت الآية المباركة:(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ )(آل عمران: من الآية7).
بالتالي فكل مؤهَّل من حقه أن يقرأ النص إعتماداً على المنهج الذي يراه مناسباً لذلك، ولا يحق له أن يفرض قراءته على غيره من القرّاء باعتبار أن قراءته تمثّل الحق المطلق.
المحور الثالث:
الجواب الأول: في الحقيقة التفسير من جهة كونه كشفاً للمعنى الظاهري للنص، يتطابق تقريباً مع الإستنباط، لأنه أيضاً يرمي لتشخيص ما يظهر من النص الشرعي، لكن الممارسة الخارجية أضفت نوعاً من الإختلاف على كل منهما، حيث اختص الإستنباط بفهم الأحكام الشرعية خاصة، الشاملة للعبادات والمعاملات، بينما استوعب التفسير ما هو أوسع من ذلك، بحيث شمل غير الأحكام من المفاهيم والتوجيهات والوصايا وما إلى ذلك.
كما أصبح للإستنباط مؤهلات خاصة ليس من الضرورة توفرها عند المفسر، إذ ليس كل مفسِّر مستنبِط، بينما كل مستنبِط مفسِّر. ولهذا يقال بأن من لا أهليه استنباطية لديه ينبغي أن يتوقف اهتمامه عند حدود التفسير، ولا يتعداه إلى الإستنباط المتعلق بخصوص الأحكام الإلهية.
الجواب الثاني: الخطاب القرآني أعطى العقل صلاحيات واسعة في دائرة التفسير والتفكير الديني بشكل عام، وعندما نقوم باستقراء الخطابات القرآنية المتحدثة عن تلك الصلاحيات نكتشف تلك السعة.
لكن في نفس الوقت نجد أن هذا الخطاب وضع حدوداً لنشاط العقل، خاصة بالنسبة للأحكام والتكاليف، فهو لم يعط للعقل صلاحية التصرف في الحكم لا من حيث الرفض ولا من حيث التوسعة والتضييق. بمعنى أن الآيات الرابطة بين العقل والأحكام نجد أنها قائمة على أساس الفهم الدقيق للحكم والمعرفة بخصوصياته والتدبر فيها بهدف التعمّق في فهمها، ومن ثم التدخل في عملية التطبيق، خاصة عند طروء بعض العناوين الثانوية، أو تبدلات الزمان والمكان، ولكن لا يوجد فيها - الآيات- ما يشير إلى حق العقل في الرفض الدائمي للحكم، ولا التصرّف في ذاتية الحكم بتوسعته أو تضييقه.
بناء على ذلك فإننا من خلال الإستقراء التام للآيات المتحدثة عن العقل وصلاحيته في التعامل مع النصوص، نتوصل إلى نشاطه في هذا المجال عبارة عن:
1- التعمق في فهم النص.
2- انتزاع قواعد كلية من النصوص صالحة للتطبيق على العديد من المصاديق الخارجية المفتقرة لدليل شرعي.
3- تقديم وتأخير بعض مؤديات النصوص - التشريعات- بضوابط علمية.
4- التدخل لإضفاء طابع المرونة عند تطبيق التشريعات.
وللإستزادة يمكن مراجعة أحد كتبي الصادرة أخيراً عن دار الإنتشار العربي بعنوان "عن ثقافة النهضة"، ففيه تفصيل لهذا البحث.
والنتيجة أن للعقل دوراً كبيراً في عملية التفسير، لأن التفسير الصحيح هو التفسير المتحرك والمتفاعل مع اللحظة المتجددة، وهذا النمط من التفاعل لا يتم إلا بتدخل مباشر من العقل. لكن ليس للعقل صلاحية تجاوز الحدود التي تؤسسها النصوص القرآنية، فالنص القرآني حاكم بشكل مطلق على حركة العقل.
وفي الختام أحب أن أؤكد بأن التوجّس المبالغ فيه من الأفكار والإثارات ليس في محله، فكل فكرة تطرح مهما كان مستوى المغايرة فيها، ينبغي أن تعطى حقها من البحث العلمي، فإن كانت صالحة أستفيد منها في تنشيط البحث الديني، وإن كانت خاطئة فالفكر الديني بما يتضمن من عمق قادر على الإستجابة لها.
ولذلك فإني أعتقد بأن تصادم الإثارات الجديدة مع الفكر الديني، قوى من شوكة الأخير وزاده عمقاً.