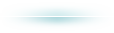ترويض الانفعالات والمشاعر خيار الناجحين
أم تقتل طفلها لأنه مزق فستان فرح قريبتها قبيل حفلة الزفاف بساعات؛ أب يقتل طفله لأن درجته في الامتحان كانت أقل من المتوقع؛ زوج يضرب زوجته حتى الموت بسبب خلاف عائلي؛ زوجة تخنق ابنة زوجها بسبب الغيرة؛ معلم يعتدي على طالب بالضرب بسلك كهربائي لأنه لم يحل الواجب؛ طالب يعتدي على مدير مدرسة بالضرب لتوقيفه عقب نهاية الطابور الصباحي؛ ....
هذا غيض من فيض – كما يقولون - من مسلسل الواقع الدرامي الذي نعيش أحداثه يوميا؛ والذي أصبح يعج بالأخبار العاجلة من فئة المذكور أعلاه؛ مما يشير إلى طغيان السلوك اللحظي الانفعالي في مجتمعاتنا، حيث ينساق المرء وراء انفعالاته فيفرط في رد الفعل مما يتسبب غالبا في أمراض مزمنة أو عاهات مستديمة أو كوارث فادحة؛ وما كارثة حريق الجهراء عنا ببعيدة.
كلنا قد يتعرض لمواقف صعبة وامتحانات حرجة، وهذا شيء طبيعي، فالحياة كما يقول الشاعر ( طبعت على كدر)؛ وكلنا ينفعل أيضا، وهذا شيء طبيعي أيضا، فليس منا من لا يغضب أو يفرح أو يحزن أو يضحك أو يبكي أو يحب أو يكره؛ هذه كلها انفعالات ومشاعر طبيعية تصدر من الإنسان بما هو إنسان. إذن ما هو الفرق بين إنسان وآخر ما دام الكل ينفعل ويتفاعل؟!
الجواب يكمن في قدراتنا المتفاوتة على التكيف وترويض الانفعالات والمشاعر؛ وهذه القدرات قد تكون من طبيعة الشخص وسجيته، أي من موروثاته الجينية والبيئية، وقد تكون مكتسبة من خلال التعليم والتدريب، وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق  حين قال: إن الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه، فمنه سجية ومنه نية.
حين قال: إن الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه، فمنه سجية ومنه نية.
وهذا المنطق يرفض الحتمية الوراثية التي لا يستطيع الإنسان الفكاك منها؛ فالإنسان يستطيع إحداث التغيير الذي يريد متى ما أراد، والله يعينه ويوفقه إذا صدقت منه النية.
إن تحديد واختيار نوع الاستجابة للمؤثرات والمحرضات الداخلية والخارجية تبقى بيد الإنسان، وهذه المساحة من حرية الاختيار التي تفصل بين المؤثر أو المحرض وبين الاستجابة أو رد الفعل هي التي تجعل الإنسان إنسانا، ومنها يستمد مبدأ الثواب والعقاب مشروعيته.
ففي نفس الموقف أو في موقفين متماثلين نلاحظ لدى الأشخاص ردود أفعال متباينة، فقد ينتحر شخص أو يصاب بجلطة لأنه خسر في سوق الأسهم التي
لا تبقي ولا تذر؛ بينما نرى شخصا آخر يتعرض ربما لخسارة أشد ولكنه لا يفقد توازنه رغم تأثره وحزنه بالطبع؛ ونفس الشيء قد يحصل عندما يفقد الناس بعضا من جاههم أو صحتهم أو أي شيء عزيز لديهم، فتختلف ردود أفعالهم بمقدار ما يمتلكون من قدرة على التكيف وترويض المشاعر.
- وهنا أذكر موقفين لعالمين جليلين من علمائنا:
الموقف الأول للشيخ آغا رضا الهمداني ( رحمه الله ) الذي أصيب بمرض السل عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تسنم المرجعية. كان بالإمكان أن يحمله هذا المرض على الانزواء في منزله وقضاء بقية عمره متحسرا على حظه المتعثر وصحته التي ذهبت؛ ولكنه لم يستسلم لمثل هذه المشاعر السلبية، ووجدها فرصة للتفرغ للتأليف فكتب كتابه " مصباح الفقيه " في ثلاثة مجلدات، وكان بعدها أحد تلاميذ الشيخ يقول – كما نقل ذلك سماحة المرجع السيد صادق الشيرازي في محاضرة له- : هذا لطف من الله تعالى للشيخ لأنه أغنى بقلمه أكثر مما أفاد بلسانه.
الموقف الثاني لسماحة المرجع السيد محسن الحكيم ( قدس سره )؛ حيث أنه بعد انتهائه من كتابه الفقهي المشهور " مستمسك العروة الوثقى " الذي استغرق من عمره الشريف سنوات طويلة، وكلفه من الجهد والعناء الكثير، وكانت ظروف تأليفه صعبة وحرجة للغاية، جاءه أحد المدرسين المغمورين في الحوزة العلمية، فقال له: سيدنا! إن الشيخ الأنصاري رحمه الله قد رفع المستوى العلمي في النجف الأشرف بكتبه القيمة وأنت قد أخفضته بكتابك هذا. وكان بإمكان السيد الحكيم رحمه الله أن يطرد هذا الرجل وينهره ويهينه ـ من خلال استفادته من مكانته المرجعية ـ أو مواجهته مواجهة علمية يبطل فيها كذبه في ادعائه الخطير. إلا أنه لم يختر لا هذا ولا تلك، بل قال له بكل أدب وتواضع وخفض جناح: وكيف تقارنني بالشيخ الأنصاري؟ أين أنا من الشيخ؟ حبّذا لو تدوّن ملاحظاتك على الكتاب، لأكون شاكراً لك.
فلم يسع الرجل حينها سوى الاعتذار إلى السيد الحكيم بعد سماعه لردّه هذا، والإقرار بعظمته والاعتذار له مما بدر منه من تحامله عليه 1 .
والسؤال: ألم يتألم جسد الشيخ الهمداني بسبب المرض، وألم تتأثر نفس السيد الحكيم للانتقاص من جهده وشأنه؟!
الجواب: بلى، فهذا أمر طبيعي، ولكنهما في المقابل استطاعا إدارة مشاعرهما بطريقة إيجابية فبلغا بذلك ذرى المجد.
أما كيف يتم ترويض الانفعالات والمشاعر فهذا ما سنتركه لحديث قادم إن شاء الله.