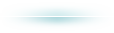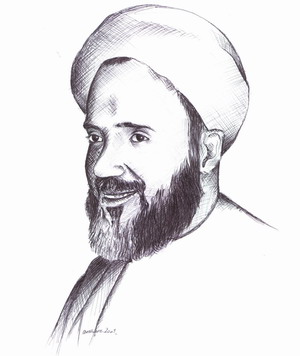الهويات بين القمع والاستيعاب
هناك حقيقة بسيطة لا تخفى على أحد؛ وهي إن العالم مركب من هويات متعددة ومعقدة إثنية وقومية ودينية ولغوية وغيرها. وبرغم بساطة هذه الحقيقة إلا أن التعامل معها لم يكن بالأمر السهل أبدا، حيث شهد تاريخ البشرية اندلاع الكثير من الحروب التي أزهقت أرواح الملايين، وكانت عبارة عن صراعات بين هويات مختلفة، أو استُغِلت فيها الهويات لتحقيق مآرب أخرى.
يقول التاريخ: غالبا ما حاولت الهويات المركزية ابتلاع الهويات الطرفية الأخرى المحيطة بها رغبة في إخضاعها أو تذويبها أو محوها من الخريطة.
حدث هذا ويحدث بين المنتسبين لدين واحد أو طائفة واحدة أو قومية واحدة أو وطن واحد. الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى من التاريخ القديم والحديث. المثال القريب الذي لا يزال طريا في الأذهان هو يوغوسلافيا السابقة التي اشتعلت فيها الحرب بين أبناء الوطن الواحد ( الصرب والكروات والبوسنيين )، وبين أتباع الديانة الواحدة، الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك وهما طائفتان تنتميان للديانة المسيحية.
وهذا ما يطرح سؤالا ملحا على المهتمين بمسألة الهويات وكيفية التعاطي معها، خصوصا أنها ليست محصورة في بلد دون آخر، بل هي ذات بعد عالمي. هنا مثال لدول ثلاث من قارات ثلاث؛ العراق يضم 64 هوية، رومانيا 27 هوية، زامبيا 73 هوية. لكل ذلك فقد تزايد الاهتمام بها خصوصا في عصرنا الراهن الذي احتلت فيه قضايا حقوق الإنسان مرتبة متقدمة في الوعي الإنساني.
الحلول التي طُرحت أو تطرح في هذا المجال لا تخلو من واحد من ثلاثة: الاستيعاب التام والإنكار التام والأمر بين أمرين.
- الحل الأول: الاستيعاب التام
كما حدث في الهند مثلا. الهند ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، وأول دولة من ناحية تعدد الهويات بمختلف أطيافها. ومع ذلك فقد استطاعت بناء دولة موحدة تضم كل تلك الهويات من خلال استيعابها وإدماجها وليس عن طريق إقصائها أو تهميشها.
فمن ناحية التعددية الدينية مثلا يشكل الهندوس أكثر من 82% من السكان، وتقتسم الطوائف الأخرى من مسلمين ومسيحيين وسيخ وبوذيين وغيرهم النسبة الباقية، ولكن هذا لم يمنع أن يصبح الرئيس الهندي من الأقلية المسلمة. لقد وضع أول رئيس وزراء للهند ( جواهر لال نهرو ) حجر الأساس لذلك حين دعا إلى استيعاب الجماعات الثقافية في إطار مشترك ليس من خلال القسر والإكراه وإنما من خلال توليد القناعة بضرورة الاندماج لبناء الدولة/ الأمة، ومن خلال الضمانات الدستورية والإجرائية التي تكفل الحرية لكل المنتمين إلى هوية ما بالحفاظ على هويتهم وتنميتها. مثال ذلك أنه لا يحق – بحكم الدستور – لأي حكم محلي استصدار قوانين تفرض ثقافة الأغلبية على الأقلية التي تعيش تحت سيادته. ويكفل الدستور أيضا للأقليات حرية إنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والهيئات اللازمة لحماية مقوماتها الثقافية.
بالطبع القوانين وحدها لا تكفي، إذ لا بد أن يصحبها عمل ثقافي ضخم يقوم بتخليص الهويات الصلبة من عُجبها المفرط ونظراتها الاستعلائية وممارساتها الإقصائية. هذا ما فعله الغرب – كما يذهب لذلك الكاتب عبد الله المطيري في مقال له بجريدة الرياض في 16 أبريل 2009 - إذ يرى أن الغرب قام بتحويل الهوية من هوية جبرية إلى هوية اختيارية فالهوية الدينية مثلا لم تعد جبرا أو فرضا على الأفراد بل أصبحت خيارا لا يترتب على التخلي عنه ضرر أساسي. كما تم تفكيك الهوية العرقية الصلبة من خلال تجاوزها إلى مفهوم الجنس البشري من خلال مفهوم المساواة الأساسي.
الغرب ذهب إلى أبعد من ذلك حيث شرعن التعاون العابر للحدود بين الجماعات ذات الهويات المتماثلة، بدلا من وضعه في خانة التخوين والمؤامرة. ونصت ديباجة المعاهدة الإطار لحماية الأقليات القومية على أن ازدهار أوروبا متسامحة وناجحة لا يتوقف على التعاون بين الدول فحسب، بل يستند كذلك إلى تعاون عابر للحدود بين الجماعات المحلية والإقليمية في إطار احترام الدستور وسلامة الأراضي الوطنية لكل دولة.
- الحل الثاني: الإنكار التام
كما حدث لكثير من الهويات في العالم، وتسبب في صراعات مريرة. فبرغم الصراع الطويل في منطقة كازامانس السنغالية مثلا، صرحت الحكومة السنغالية في تقريرها إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، والذي عرض عام 1997، بأنه لا توجد أقليات في السنغال، وبالتالي ليس لديها ما تقدمه من معلومات حول الاعتراف بالأقليات الدينية والإثنية وحمايتها. انظر ( جوزيف جاكوب، ما بعد الأقليات ). السنغال في نهاية الأمر وتحت المزيد من الضغوط الداخلية والخارجية اضطرت إلى الاعتراف بالمشكلة، وبالتالي قبول التفاوض لإيجاد الحلول.
الأمازيغ في شمال أفريقيا تعرضوا هم أيضا ولعقود طويلة لإنكار هويتهم اللغوية والثقافية، وحظرت السلطات المغربية حتى وقت قريب تداول الأسماء الأمازيغية إمعانا في حالة القمع والإنكار.
الأدهى من ذلك مساهمة بعض المفكرين العرب في تمرير هذه الحالة وشرعنتها. فقد دعا محمد عابد الجابري – وهو أمازيغي بالمناسبة – إلى إماتة اللغة الأمازيغية لأنها تشكل في رأيه خطرا على العروبة والإسلام، كأن اختلاف الألسن ليس من آيات الله.
وعانى الأمازيغيون ولوقت طويل من هذا الإنكار المجحف، وكانت ترفع في وجوههم لافتات التخوين والعمالة للأجنبي وغيرها من اللافتات القذرة كلما طالبوا بحقوقهم.
ولأن القسر لا يدوم، ولأن النضال يؤتي أكله ولو بعد حين، فقد حصلت انفراجات نسبية في سبيل الاعتراف بهويتهم، خصوصا في المغرب، حيث تجاوبت الدولة مع مطالبهم المتعلقة بإنشاء معهد للدراسات الأمازيغية وإدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية واستعمالها في المجال الإعلامي، ونص الدستور الجديد على الأمازيغية كلغة رسمية.
بالطبع كما ذكرنا، ونكرر ذلك دائما، أن النصوص الدستورية مطلب أساس ولكنه غير كافٍ لحل الأزمة. وهذا ما يؤكده عبد الرحيم منار السليمي الخبير السياسي المغربي وأستاذ القانون الدستوري الذي يرى أن الأمازيغية معترف بها الآن دستوريا لكن نفاذ القاعدة الدستورية واستقرارها يحتاج لمدة زمنية قد تصل إلى عام حيث يحتاج الأمر إلى قانون تنظيمي ليصل إلى الأعوان والمصالح المحلية في البلاد.
- الحل الثالث: الأمر بين أمرين
لعل أبرز مثال يمكن أن نقدمه هنا هو المتعلق بوضع الطائفة الشيعية في دول الخليج العربي. صحيح أن أسلوب التعاطي يختلف من دولة إلى أخرى، ولكنه في جوهره يبقى واحدا. فالشيعة يعيشون في منطقة برزخية بين الإنكار التام والاستيعاب التام، حيث لم يتم الاعتراف التام بهويتهم بما يكفل لهم تحقيق المواطنة الكاملة، وفي نفس الوقت وُجدت بعض المؤسسات الرسمية الخاصة بهم والتي تشكل اعترافا ضمنيا، كما سُمح لهم ببناء المساجد في بعض مناطق تواجدهم بشكل رسمي أو شبه رسمي. وفي نفس الوقت لم يسمح لهم ببناء المساجد في مناطق أخرى، بل تم منعهم من الصلاة التي كانوا يؤدونها جماعة في بعض الأماكن التي أعدوها للصلاة كما حدث في منطقة الخبر في السعودية.
سأقتصر هنا على السعودية كمثال يوضح الحالة أكثر. نلاحظ أن المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تدخل في منطقة الاعتراف الضمني هي ما كان يعرف سابقا بالمحكمة الجعفرية والتي تقلصت صلاحياتها شيئا فشيئا لتنتهي إلى الإلغاء وتحويلها إلى دائرة فرعية ملحقة بالمحكمة الكبرى. هناك أيضا خطوط حمراء مسكوت عنها في مسألة التعيين في الوظائف العامة.
في مقاله بعنوان (الشيعة السعوديون : مشكلات المواطنة في ظروف التحول) يتحدث الدكتور توفيق السيف بالحقائق والأرقام عن هذه المسألة قائلا: " لكن التمييز لا ينحصر في الوظائف العليا، فهناك دوائر حكومية تمنع الشيعة من تولي وظائف صغيرة. فمنذ 1960 لم يعين أي شيعي رئيسا لبلدية. كما إن وزارة التربية لم تسمح بتولي أي سيدة شيعية وظيفة مديرة مدرسة بنات (عدا واحدة عينت في 2009)، ولم تسمح (حتى العام الجاري 2010) بفتح مدارس أهلية للبنات في مناطق الشيعة. كما لا تسمح وزارة التعليم العالي بتوظيف أساتذة شيعة في جامعات معينة مثل جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ومن بين 30 جامعة تضم مئات الكليات، وصل شيعي واحد فقط إلى منصب العمادة في كلية هندسة البترول بجامعة الملك فهد في الظهران. كما لا تسمح وزارة الخارجية بتوظيف الشيعة في الكادر الدبلوماسي. وينطبق مثل هذا التمييز على جميع المؤسسات شبه الحكومية والشركات الحكومية الكبرى ومعظم الشركات التي تساهم فيها الحكومة". طبعا هذا جانب واحد، وإلا فالحديث طويل عن الحريات الدينية، وما يتعرض له الشيعة من حين لآخر من تكفير لهم وهجوم على معتقداتهم وتسفيه لرموزهم من خلال العديد من المنابر الإعلامية.
لقد كان بإمكان مجلس التعاون الخليجي أن يستفيد من تجربة المجلس الأوروبي في كيفية التعاطي مع مسألة الأقليات، إلا إننا لا نلحظ أي إسهام إيجابي للمجلس في هذا الصدد، ربما لسيطرة الهاجس الأمني والحلول الأمنية على المجلس منذ تأسيسه، وإلا فكيف نفسر تجاهله التام لقضايا هامة كالمسألة الشيعية أو قضية البدون.
لقد آن الأوان لاختيار الأسلوب الأمثل والحل الناجع للتعاطي مع مسألة الهويات المتعددة؛ الحل الذي يعترف بها اعترافا كاملا لا مواربا، ويقوم على دمجها طوعيا في هوية وطنية جامعة لا تلغي أحدا. هذا الدمج والاستيعاب لا يتم من خلال الشعارات الرنانة والمؤتمرات ذات القرارات والتوصيات غير النافذة، بل من خلال برامج على الأرض يشعر بها كل أحد بدءا من المناهج المدرسية الخالية من تسفيه الآخر، مرورا بتكافؤ الفرص، وانتهاء بالمواطنة التامة بما تتضمن من حقوق والتزامات.