ثقافة البذل و العطاء

أولى القرآن الكريم أهمية خاصة لمسألة البذل والعطاء، وتعددت أساليبه في الترغيب إلى ضرورة وجود هذه الثقافة في المجتمعات الإسلامية، إلا أننا نجد ضعفاً شديداً عندهم في المبادرة للاشتراك في الأعمال الخيرية، ودعمها ماديا، حتى وإن كان لها نفع على المجتمع، وأنها أحد أسباب رقيه وتقدمه، فلا نسمع بينهم عن تبني أحد الشباب للدراسة، أو تكفل جماعة منهم بنفقة علاج مريض، أو مساهمة أحد الأفراد بكفالة عائلة مستحقة، وتحمل نفقاتها، فضلاً عن أن يبادر إلى إيجاد سكن مناسب لهم.
ولم تقتصر الآيات الشريفة على الترغيب لثقافة البذل والعطاء، بل تعرضت أيضاً إلى عرض المصالح والحكم المترتبة على وجود هذه الثقافة في الوسط الاجتماعي، لأن وجودها يوجب رفع العديد من متطلبات الإنسان، وتلبية احتياجاته، وهذا يعني أن لها ارتباطاً وطيداً بالمجتمع الإنساني.
- قيمة المال اكتسابية:
لا يختلف حال المال عن بقية الموجودات في هذا الكون في لزوم اتصافه إما بصفة الإيجابية، أو صفة السلبية، والتوصيف بأحد هذين الوصفين، إما أن يكون لذاته دون أن يلحظ معه شيء آخر، أو يتوسط بينهما شيء، أو يكون ذلك نتيجة ملاحظة شيء آخر يكون عارضاً عليه، أو مرتبطاً به، لأنه لا يكون ذلك الشيء ثابتاً له بنفسه، بل يكون ثبوته له جراء أمر خارجي يحيطه فيعطاه، فمن الثاني، ضرب الطفل على سبيل المثال، فإنه لو كانت الغاية من ضربه هي التأديب، فلا ريب أنه سيتصف بصفة الإيجابية، بخلاف ما لو كان موجب ضربه تعذيبه، فإنه سيوصف بالسلبية.
وهذا يعني أن وصف الضرب قد انتزع من خلال الداعي الموجود عند المتصدي لعملية الضرب، وأنه وفقاً لذلك استحق هذا التوصيف.
ومثل ذلك الطعام، فإنه لا يكون متصفاً بالإيجابية أو السلبية، لذاته، وإنما يكون وصفه بذلك بملاحظة كيفيته، وأنه محلل أو محرم، وملاحظة كميته، وأنه كثير خارج عن حدّ الاعتدال، أو أنه معتدل فيه، وملاحظة الهدف الداعي لتناوله، وأنه إشباع غريزة البطن، أو التقوي به من أجل العبادة، وهكذا.
ومن الأول، العدل والظلم، فإن وصف الأول بالإيجابية، والثاني بالسلبية لذاتهما، فلا يحتاج في التوصيف وجود واسطة كما لا يخفى.
ووفقاً لما تقدم، هل يحكم بكون القيمة للمال قيمة ذاتية، أم أن قيمته، تكون قيمة اكتسابية؟
إن الرجوع للنصوص الشريفة، يفيد أن قيمة المال، قيمة اكتسابية، وليست قيمة ذاتية، ذلك أن الملاحظ لها يجد أنها ركزت على المال بلحاظ عنصرين:
الأول: مصدر التحصيل.
الثاني: مجال الصرف.
وعليه، فسوف يكون وصفه بالإيجابية أو السلبية منتزعاً من خلال هذين الأمرين، وأن ذلك يدور مدار ملاحظتهما، ولا يمكن أن يوصف إلا من خلالهما، فتدبر.
- البذل قيمة اجتماعية:
ثم إنه بعد الفراغ عن كون قيمة المال قيمة اكتسابية، يتبادر إلى الأذهان سؤال، عن السبب في التركيز والاعتناء بثقافة البذل والعطاء، وإعطاء ذلك مجالاً من الأهمية، فما هو الدور الذي يمثله هذا المفهوم في التخطيط لحياة الإنسان وحركته، وهل أن ذلك يعود للقيمة الذاتية للإنسان، والتي تتمثل في الدوافع والأجواء النفسية التي عيشها المنفق طلباً للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، بعيداً عن أية حالة إنسانية ترتبط بالواقع الاجتماعي، أو أن ذلك يعود للقيمة الاجتماعية من خلال ملاحظة ما يحققه الإنفاق من رعاية للمجتمع في حاجاته العامة والخاصة؟
من المعلوم عدم انحصار التشريع الإسلامي في جانب واحد فقط، بل هو يشمل الجوانب الحياتية كلها، لعدم انفصال أي جانب من جوانب الحياة عن البقية، وهذا يمنع من تصور الجانب الذاتي الروحي منعزلاً عن الجانب الاجتماعي، لأن قوة الروح الاجتماعية في الإنسان تكمن في القيمة الروحية الذاتية لشخصيته، كما أن الأعمال الصادرة منه خلال دوافعه الروحية تؤثر تأثيراً كبيراً في نمو المجتمع وسلامته وتطوره. فالصلاة وإن كانت عبادة روحية تشتمل على بعد ذاتي روحي يحقق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى في أعماق النفس، إلا أنها تشتمل أيضاً على بعد أخلاقي اجتماعي يحقق حماية الإنسان وإبعاده عن الفحشاء والمنكر في ما يعنيه من قيمة فردية واجتماعية، بل لا يبعد مدخلية البعد الروحي وبقوة في تعميق البعد الأخلاقي، على أساس أن عبودية الإنسان له سبحانه وتعالى تمثل مسؤوليته العملية في الانضباط أمام إرادة الله تعالى في ما يحبه وما لا يحبه في حياة الفرد والمجتمع.
ونلمس هذا المعنى أيضاً في عبادة الصوم الذي يحقق الإنسان فيه معنى العبودية لله تعالى، فإنه كما يتضمن خلقاً للإرادة الصلبة، يعيش الصائم فيه الشعور بمظاهر البؤس والجوع والعطش في حياة الناس الآخرين، لما يثيره الصوم داخل نفسه من إثارة للجوع والعطش والحرمان، وغيره.
وهذا يكشف عن أن التشريعات السماوية العبادية وغيرها، قد لاحظت جميع الأبعاد الإنسانية في ما تشتمل عليه من جوانب روحية ومادية في آفاق الفرد والمجتمع، على أساس أن الإنسان كل مترابط الأجزاء في ما ينطلق فيه من إيجابيات وسلبيات.
ولا يخرج البذل والعطاء الذي يقدمه الإنسان المؤمن لأفراد مجتمعه عن هذه الدائرة التشريعية، فهو يمثل النموذج الحي لهذا الخط في التشريع، كما أن القيمة فيه لا تتمثل في الحجم المادي له، بل تتمثل في تحقيق الشخصية الانسانية الاسلامية في ما تعيشه من روح العطاء الذي تنساب معه كل المشاعر الإنسانية التي تلتقي بالهموم الكبيرة للإنسان في الحالات الفردية الصعبة التي يعاني فيها الفرد آلام الحرمان، وفي الحالات التي يفقد فيها المجتمع عوامل الكفاية والاستقرار الاقتصادي والحياتي، فيتحرك العطاء في بعدين: البعد الروحي الذاتي الذي يدخل في تكوين شخصية الإنسان في دوافعه وحركاته من موقع القيمة الروحية الفردية في ما تمثله من خصائص الذات، والبعد الاجتماعي في ما تحققه من عناصر الاستقرار والأمن والقوة للمجتمع.
وهذا المعنى يكشف عن المنهاج القرآني التربوي الذي يستخدمه القرآن الكريم في صياغة وصناعة الإنسان الذي يعيش هموم المجتمع، ويشعر أنها همومه الذاتية ويتحمل مسؤوليته في قضاياه الاجتماعية، على أساس أنها مسؤوليته في قضاياه الخاصة، فيحصل اندماج بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية في عملية تكامل إنساني روحي عملي، ولهذا كان العطاء والبذل يحقق للإنسان هذه الشخصية، ما يجعل القيمة للمبدأ بدلاً من أن يجعلها للمقدار، فلاحظ[1].
- أساليب الترغيب في البذل والعطاء:
ولما كان القرآن الكريم على دراية ومعرفة بالواقع البشري، ومحيطاً بأن العنصر الإنساني يعيش حالة من الحب والعشق للمال، عمد إلى إيجاد مجموعة من المحفزات والدوافع التي تحركه للبذل والعطاء والإنفاق في الوسط الاجتماعي، وليكون مساهماً في المشاريع الاجتماعية الخيرية التي يعود نفعها على المجتمع، دون فرق بين ما يكون منها دينياً، وما يكون منها تربوياً، وما يكون منها غير ذلك.
وقد تنوعت تلك المحفزات والأساليب التي عرضها القرآن الكريم، فلم تأخذ شكلاً واحداً، بل أخذت أشكالاً متعددة، نشير لبعض منها:
منها: دعوته الناس إلى عدم القلق من بذل المال وإعطائه، لأنهم لن يفقدوا شيئاً مما قد جمعوا وحصلوا ببذلهم إياه، بل سوف تبقى تلك الأموال المبذولة محفوظة وسوف ترد عليهم يوم الحاجة إليها، في ساحة القيامة وفي عرصة المحشر.
وقد عالج هذا الأسلوب الفكرة الموجودة عند بعضهم من أنه لما كان هو الباذل للجهد والوسع في تحصيل المال، فكيف يسمح له نفسه أن يعطيه للآخرين الذين لم يبذلوا فيه جهداً ولم يقوموا بأية مشقة لينتفعوا به دونه؟!
إن التبرع في المشاريع الخيرية والمساهمة في الأعمال البنائية للمجتمع بنظر هؤلاء، إنما هي استنـزاف لأموالهم التي يختصون بها دون غيرهم، وليس لأحد الحق أن يشاركهم فيها، فلا يمكنهم دفعها إليهم أبداً.
وقد كان بيان المحفز السماوي لهؤلاء، بأن ما يبذلونه سوف يكون مذخراً ومحفوظاً لهم، وأنه لا يضيع ولا يفوت عليهم، حتى أنهم سوف يجدونه ويتحصلون عليه في الظروف الصعبة عندما يكون الإنسان في أصعب المواقف وأشدها. قال تعالى:- (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله)[2]، وقال عز من قائل:- (وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون)[3]، فإن هذه الآيات تؤكد على أن أفضل وسيلة لحفظ المال، ورعايته، بل ونمائه، تكون من خلال بذله وعطائه في المصالح الاجتماعية النافعة، والمساهمة في كل ما من شأنه النهوض به وتنميته، فلاحظ.
ومنها: اعتبار الإنفاق والبذل والعطاء نوعاً من أنواع الإقراض إلى الله سبحانه وتعالى، ما يجعل الناس يرغبون في الإقدام على ذلك، لأن الله تعالى سوف يكون مديناً إليهم، وكلنا يعلم أن موجب الكثير من الامتناع عن الإقراض لسائليهم، علمه أنهم لن يفوا له بأداء أمواله، وهذا المعنى لا يجري في شأن الباري سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل أمين، ولا إشكال في أنه سوف يؤدي دينه.
فإذا كان المكلف يعلم بأنه متى ما أقرض شيئاً من أمواله فسوف يعود إليه ذلك المال المقرض، كان ذلك محفزاً إليه في أن يقدم على عملية الإقراض دون حزازة أو توقف. قال تعالى:- (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون)[4]
ومنها: مجموعة من المحفزات المرتبطة بعالم الآخرة، مثل الوعد بالمغفرة والأجر، والتسامح والعفو عن أخطاء المنفقين، قال تعالى:- (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[5].
ومنها: عدّ العطاء والبذل أحد موجبات حصول الفلاح للإنسان، لأن الإنسان المؤمن يطمح أن ينال هذه المرتبة، وأن يكون من المفلحين.
ولا ريب أن هناك حجباً وموانع تحول بينه وبين بلوغ ذلك، وعلى رأسها العلاقات المادية، فإنها تصدّ الإنسان وتحرمه عن السمو نحو الكمال والسعادة الأبدية، فمن أمتلك القدرة على التحرر من ذلك، والتخلص من قيود وغلّ المال، وعلاقاته، تكتب له الحرية، ويعدّ من الأحرار، وما ذكرناه من خضوع أصحاب العلاقات المالية للأموال، وإصابتهم بمرض الشح، أشير إليه في قوله تعالى:- (وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)[6]، إذ نجد أنه تعالى اعتبر الذين لا ينفقون أموالهم ولا يبذلونها مصابين بمرض الشح، في مقابل من أمتلك الوقاية التي يصان بها من الوقوع في الخطر، وإنما أعطوا هذه الصفة، لأنهم كان من أهل البذل والعطاء.
ومنها: مضاعفة الأجر على البذل والعطاء، مع مجموعة من الامتيازات الأخرى، قال تعالى:- (إن تقرضوا الله قرضا حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم)[7]، فقد جعل سبحانه وتعالى العطاء الذي يبذله الدافع في وجوه البر والإحسان ويساهم من خلاله في الحياة الاجتماعية، ليتحمل شيئاً من مسؤولياتها، سبباً لمغفرة الله تعالى لذنوبه، فهو بمثابة ما يوجب تكفير الذنوب والخطايا والمعاصي، فتدبر[8].
- موانع البذل والعطاء:
ومع أن الشريعة السمحاء قد أوجدت محفزات وسبل كي ما تبعث المؤمنين للقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية، وأدائهم للدور المناط بهم، عن طريق المساهمة في المشاريع الخيرية، والتنموية للمجتمع، والقيام برفع شيء من الحرمان والفقر والجوع من بين صفحاته، إلا أننا نجد عزوفاً بيناً في أوساط مجتماعتنا الدينية، بل بين أحبتنا الشباب[9]، حتى قد ينذر أن تلمس مبادرة حيوية في مثل هذه المجالات، ما يكشف عن افتقاد المجتمع لثقافة البذل والعطاء، وأن بينه وبينها نفرة وفرقة، فربما تعتبر هذه الثقافة غريبة عليه، وأجنبية بالنسبة إليه.
ومن الطبيعي أن يكون لمثل هذه الحالة من العزوف موجبات أدت إلى وجودها، ربما يكون بعضها متأصلاً وجذرياً ضرب في الأعماق ومضى بعيداً، بينما قد نجد بعضها الآخر، لا يعدو كونه شيئاً سطحياً يمكن العمد إلى استئصاله وعلاجه قبل أن يستفحل ويستشري في وسط المجتمع.
وبالجملة، فلنشر لبعض ما يتصور أنه موانع تحول أن تكون هناك مبادرات في مثل هذا المجال، تكشف عن فقدان هذه الثقافة الدينية الاجتماعية:
- أحدها: ضعف الإيمان، أو فقده:
فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعدّ محفزاً أساسياً لكل الأعمال الخيرية، ومنطلقاً منه إلى القيام بها، ومن المعلوم أن الإنسان ينطلق في علاقته مع وسطه الاجتماعي، فيرتبط بالناس الذين يعيش معهم من خلال علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، فتعتبر علاقته مع الباري عز وجل المفتاح والأصل الذي يتحرك من خلاله في علاقاته الاجتماعية معهم، وكما أن هناك موجبات لنمو علاقته بربه سبحانه وتعالى تتمثل في ما يقوم به من طاعات يتقرب بها إليه، فإن هناك مقومات لها أبرز الأثر في تنمية علاقة الإنسان بمجتمعه، تتمثل في ما يبذله بينهم من عطاءات وهبات.
وطبقاً لما تقدم، فإنه متى أفتقر الإنسان إلى عنصر الإيمان بالله تعالى، أو ضعف هذا القانون في بواعثه الداخلية، وأنطفأت جذوة نوره، ستتأثر علاقاته الاجتماعية، ولن تكون مضيئة مشرقة عندها، لما عرفت من التلازم بين الأمرين بعضهما مع بعض.
ولعل ما تقدم، يعطي ميزاناً للإحاطة بمقدار ما يملكه الإنسان من درجة الإيمان وعنصر التقوى، إذ لا ريب في وجود تفاوت بين من يملك ثقافة البذل والعطاء، ومن يفتقر إليها، أو تكون عندها بنحو ضعيف جداً، وقد عرفت أن هذا يمثل عنصراً رئيساً في ميزانية الإيمان، فتدبر.
وقد يساعد على هذا المعنى، ملاحظة الآيات الشريفة التي قرنت بين الصلاة والزكاة في غير واحدة من الآيات المباركة، فإن أحد المنبهات التي ربما قصدت الإشارة إليها، بيان ما لهذين الأمرين من علاقة وارتباط بعضهما مع بعض في تحديد ميزان الإيمان من جهة، وفي رسم الشخصية الحقيقية المؤمنة من جهة أخرى، فالصلاة تمثل عنصر ارتباط العبد بربه، والزكاة تمثل عنصر علاقة المكلف بمجتمعه، فلاحظ.
- ثانيها: فقدان الثقة بالله تعالى:
ربما هناك الكثيرون الذين يحرمون من نعمة البذل والعطاء، ولا ينالون هذه الثقافة جراء خلل عندهم في المعتقد والارتباط بالباري تعالى، بسبب ما يعيشونه من هاجس وخوف الوقوع في الحرج، أو الإصابة بحالة العسر، ما يؤثر عليهم سلباً فيعيقهم عن تسيـير أمور حياتهم، والقيام بشؤونهم ومتعلقاتها، بل قد يخشى البعض منهم أن لا يجد ما يسدّ به رمقه، ويعول به عياله، ولهذا يتوقف هؤلاء كثيراً قبل أن يقوموا ببذل شيء أو اعطائه.
ومن الواضح، أن ما هذا الذي ذكر إلا أحد أنحاء فقدان الثقة بالله تعالى، فإن من يجعل ثقته في الله تعالى، ويوقن أنه سبحانه يكفل له ما يحتاج إليه، ويسبب له الأسباب التي لا تجعله في موقع ضيق أو حرج، فضلاً عن ضنك، لا يخشى شيئاً، ولا يمتنع المشاركة ببذل وإعطاء.
وقد يكون فقدان الثقة عند بعضهم من خلال حرصهم على المال بداعي ضمان مستقبل الأبناء، ومحاولة إعداد مستقبل زاهر لهم، وتوفير إذخار يقيهم العوز والحاجة للآخرين، لذا تجده يمتنع أن يبذل أو يعطي، حتى لا يختل البرنامج الذي هو بصدده، وهذا أوضح في فقدان الثقة بالله تعالى، فلاحظ.
- ثالثها: الجهل بعاقبة الإنفاق:
إن عدم إحاطة الكثير من المكلفين بالمحفزات السماوية التي جعلت للباذلين أصحاب ثقافة العطاء، حرمهم أن يكونوا من أصحاب هذه الثقافة، ولهذا يحتاج المجتمع اليوم إلى توعية، وزيادة تعليم وتنبيه، وإرشاد إلى تلك المحفزات التي تضمنتها الشريعة الإسلامية، سواء ما تضمنه القرآن الكريم في آياته المباركة، أم ما جاء في النصوص المعصومية الصادرة عن المعصومين ، فإن زوال غشاوة الجهل وارتفاع غمامة الأمية، يوجد المحفز للآخرين للمساهمة والإنفاق، فتدبر.
، فإن زوال غشاوة الجهل وارتفاع غمامة الأمية، يوجد المحفز للآخرين للمساهمة والإنفاق، فتدبر.
- رابعها: اضمحلال سجية وخلق الكرم عندنا:
وحلول صفة الشح والبخل، وقد ذم القرآن الكريم البخلاء، قال تعالى:- (ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء)[10].
ولو أن هؤلاء البخلاء توجهوا إلى أن بخلهم في الحقيقة ليس على المبذول لهم، وإنما هو بخل منهم على أنفسهم لما يفوتهم من ثمرات وخيرات، وعطاءات البذل في سبيل الله، لما توانوا عن المساهمة في ذلك.
وقد تمثلت عملية علاج القرآن الكريم لهذا المرض لهذا المرض النفسي، من خلال إيجاد عنصر التشويق للسخاء والبذل تارة، فقال تعالى:- (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)[11].
ومن خلال مبدأ التهديد والترهيب أخرى، قال تعالى:- (والذين يكنـزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم* يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون)[12].
- خامسها: الطمع وحب المال:
وهو من أسوأ الأمراض النفسية التي يعيشها الإنسان ليكون نتيجتها عبداً لماله، وعوضاً عن أن يكون ماله حارساً إليه،
ينقلب الحال ليكون هو من يحرس المال، فيضيق حتى على نفسه، لأنه كلما وجد ذلك المال قد ازداد واجتمع، ضن به حتى على نفسه فكيف يسمح به لأبناء مجتمعه.
وقد عرض القرآن علاجاً لمثل هذا من خلال استعمال أسلوب الموعظة بذكر بعض القصص القرآنية، وما كان إليه مصير هؤلاء، قال تعالى:- (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* ولا يستثنون* فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون* فأصبحت كالصريم* فتنادوا مصبحين* أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين* فانطلقوا وهم يتخافتون* أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين* وغدوا على حرد قادرين* فلما رأوها قالوا إنا لضالون* بل نحن محرمون)[13].
- خاتمة:
ولأن كلام محمد وآله ، هو إمام الكلام، وأنه الهادي دائماً إلى سواء السبيل مع القرآن العظيم، نختم حديثنا برواية واردة عن رئيس المذهب الإمام الصادق
، هو إمام الكلام، وأنه الهادي دائماً إلى سواء السبيل مع القرآن العظيم، نختم حديثنا برواية واردة عن رئيس المذهب الإمام الصادق ، ذات ارتباط بما نحن فيه، تشير إلى مدى أهمية البذل والعطاء، وما لهذه الثقافة من مدخلية في بقاء الإسلام وبقاء المسلمين، متى كان المال موجوداً عند من يملك هذه الثقافة، وعلى العكس تماماً، فإنه لو كان المال بيد من يكون مفتقداً لمثل هذه الثقافة، كان وجود المال بأيدي هؤلاء أحد موجبات الفناء الإسلام والمسلمين، قال: إن من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق، ويصنع المعروف، وإن من فناء الإسلام والمسلمين، أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق، ولا يصنع المعروف[14].
، ذات ارتباط بما نحن فيه، تشير إلى مدى أهمية البذل والعطاء، وما لهذه الثقافة من مدخلية في بقاء الإسلام وبقاء المسلمين، متى كان المال موجوداً عند من يملك هذه الثقافة، وعلى العكس تماماً، فإنه لو كان المال بيد من يكون مفتقداً لمثل هذه الثقافة، كان وجود المال بأيدي هؤلاء أحد موجبات الفناء الإسلام والمسلمين، قال: إن من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق، ويصنع المعروف، وإن من فناء الإسلام والمسلمين، أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق، ولا يصنع المعروف[14].




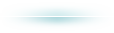




 الآية رقم 38.
الآية رقم 38.