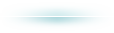الفائدة الاجتماعية للصوم . ( حديث رمضان ) للشهيد السيد حسن الشيرازي
كتاب (حديث رمضان) لمؤلفه الإمام الشهيد السيد حسن الشيرازي (قد س سره) قد استقى من بحر فضائل الشهر الفضيل شهر الصيام، من المعاني والقيم ما يجعل مطالعه يلقي له بأزمة نفسه ويرد معه في موارد عذبة من فرائد المعاني ما يجعله منبسط النفس ومتفتح الذهن للارتفاع درجات ودرجات إلى مستوى قدسية الشهر، وعلى جمام من أمره لكسب المزيد من المعنويات والفضائل. غاية القول في هذا الكتاب، أن قارئه لا يجد من الأمر ندحة حتى يتغير ويتأثر عن وعي وإدراك لعظمة شهر رمضان المبارك، نظراً للأسلوب المتميز الذي يتصف به السيد المؤلف (قدس سره) في جل مؤلفاته.
س سره) قد استقى من بحر فضائل الشهر الفضيل شهر الصيام، من المعاني والقيم ما يجعل مطالعه يلقي له بأزمة نفسه ويرد معه في موارد عذبة من فرائد المعاني ما يجعله منبسط النفس ومتفتح الذهن للارتفاع درجات ودرجات إلى مستوى قدسية الشهر، وعلى جمام من أمره لكسب المزيد من المعنويات والفضائل. غاية القول في هذا الكتاب، أن قارئه لا يجد من الأمر ندحة حتى يتغير ويتأثر عن وعي وإدراك لعظمة شهر رمضان المبارك، نظراً للأسلوب المتميز الذي يتصف به السيد المؤلف (قدس سره) في جل مؤلفاته.
وإقتطفنا منه هذا الجزء لعموم الفائدة
الفائدة الاجتماعية
تتجلى الفائدة الاجتماعية للصوم في الأمور التالية:
النظام
فهذا الكون الفسيح، خاضع لنظام رهيف دقيق، منذ (الذرة) ـ التي تعتبر أصغر شيء كشفه العلم الحديث ـ حتى السديم الذي هو أكبر ما تناوله العلم الحديث.
فالسديم خاضع لنظام الذرة، والذرة خاضعة لنظام السديم، كلاهما يجريان تحت نظام واحد دقيق رهيف، لو انفرط إحدى جزئيات أيهما، عن مداره المحدود، سار بسرعة جنونية، لتصطدم بنفسها وبالأخريات، فتهلك وتبيد..
هكذا الكون وحدة متممة الأجزاء، ولا يسير فيه شيء إلاّ بضوابط دقيقة محكمة... وكل شيء فيه ينطبق بحركات تكوينية قهرية لا يد له فيها ولا ورأي ولا اختيار، ما عدى الإنسان والحيوان، في بعض حركاتهما الخاصة، فلهما الخيرة فيه، غير أنّ غريزة الحيوان، دليله إلى رأي الطبيعة، وهو منساق بإرادة الغريزة، وأما الإنسان فإنْ اشترك مع الحيوان تحت سلطان الغريزة، فإنّه بملك إرادته المطلقة، في بعض الأعمال الأخر، التي يدله الدين على إرادة الحياة فيها، ليؤدّي امتحانه في دار الدنيا. ويبلغ تكامله المنشود...
فالتغذية والصلاة، جميعاً، من الحاجات الضرورية للإنسان، غير أنَّ الغريزة تدله على التغذية، والدين يدله على الصلاة... ليهلك من هلك عن بينة، ويحيي من حي عن بينة... فكان لا بد للإنسان أنْ يلتزم بهما معاً، ولكنه يلبي نداء الغريزة في باطنه، لقوتها وتحسس أثرها القريب، في الوقت يتكاسل عن استجابة الدين، لأنّه لا يشعر في نفس الوقت، بنتاجها العاجل...
والإنسان صعب عاتي الشكيمة، تجاذبه النفس إلى الهوى والشهوات، بينما الدين يدعو إلى الهدى والاتزان، فلا ينفذ أوامر الدين، وإن اقتنع بها فلسفة، حتى لو شاء أن ينفذها في واقعه، يتوانى عنها، فينسى منها كثيراً، ويتناسى كثيراً لأنَّ أوامر الدين موقوتة رتيبة، والمدائبة في تنفيذ الأوامر الدائمة الموقوتة، تحتاج إلى مراس على النظام، حتى يصبح قطعة من حياته العفوية، فتذكرها هي بنفسها، وإنْ شاءت الطوارئ الإغفال عنها، كالغريزة ترفع صوتها كلما ألح بها النسيان...
تمرين التكبير
ويأتي الصوم، ليمرن المسلم على النظام في حياته، وعلى الجماعية في معيشته، فالمسلم في أي وقت من ساعات النهار، يجد الطعام أو الشراب موفراً لديه، وقد يطول النهار، حتى تفرغ معدته من بقايا الطعام، فتتحرك ليتضور صاحبها جوعاً، وربما يلح به الحر في الصيف القائض، فيحن إلى جرعة من الماء، ويجد أمامه أرطالاً من الماء القراح، ولكنه يمسك عن تناول أي شيء، قبل أنْ تأذن الشمس بالمغيب، وفي لحظة الغروب، في جميع أقطار العالم الإسلامي ـ كل بحسب توقيت بلده ـ تعتبر لحظة انتهاء المنع العام، فيكون جميع المسلمين جالسين بين عوائلهم، ينتظرون لحظة المغرب، إلى أنْ ينتهي فيها النّهار ويسوّد الليل، وينصتون بخشوع وإيمان، إلى كلمة: (الله أكبر) تنطلق من المآذن أو من المدافع، لتمد الأيدي في جميع البلاد، إلى أول جرعة أو أول لقمة.
ريجيم خاص
لقد انطلقت كلمة: (الله أكبر) مع انطلاق الفجر ـ أول النهار ـ فردت الأيدي وكفّت الأفواه، في لحظة واحدة، وانطلقت كلمة: (الله أكبر) ـ في آخر النهار ـ فانطلقت الأيدي والأفواه، في لحظة واحدة، ليتركز في وجدان عامة المسلمين، النظام الجماعي، الذي يرفض التمييز بين فرد وفرد ويرفض التقديم أو التأخير ولو لحظة أو أقل من لحظة.
أو ليس (الريجيم) قد اشغل أطباء هذا العصر وكل عصر، فيقسو المرء على نفسه قسوة بالغة، لاتباع (الريجيم) الذي يفرضه عليه طبيب مختص، حتى يخفّف من وزنه بضعة أرطال، أو يهدأ من ضغط دمه، بضعة درجات، ويحرم نفسه من الدسومات والحلويات والروائح ـ وهي في متناوله ـ شهوراً وأعواماً، لهدف صحي فحسب؟. ثم أو ليس الهدف النفسي أسمى من الهدف الجسمي؟ أو ليس المجتمع أفضل من الفرد؟...
إن (ريجيم)، رمضان يجعل المسلمين ـ جميعاً ـ ممرين بأقسى التجارب، ليكونوا ـ أبداً ـ على أهبة الاستعداد، للترحيب بالأزمات، التي تضعف بهم فتحاول اجتياحهم، دون أنْ يزعزع شيئاً من مناعتهم الصلدة، لأنّ (ريجيم) رمضان قد جعلهم كالجنود المدربين، الذين تمرسوا بأعنف التجارب، ليتغلبوا على الطوارئ، مهما أمعنت في الوحشية والإرهاب.
المساواة
لقد أصبح الاقتصاد، عصب الحياة المعاصرة، التي محضت إيمانها وولائها للمادة، وحيث كان (البطن) الوعاء الرئيسي للمادة، كان من الطبيعي: أنْ تصبح (مشكلة البطن) رأس المشاكل، التي تجتاح العالم، بفلسفتها ومبادئها وحلولها، فالرأي الحديث يرى أنَّ (البطن) هو (العقل العملي على الأرض).
وفي (البطن) نكبت البشرية، وانتكست القيم، ومن (البطن) انطلقت الحروب، وتناقضت المشاكل. وقد تضاربت الاشتراكية والرأسمالية، حول مصير (البطون) و (أصحاب البطون)... ولكن المذاهب ـ التي اختلقوها حتى اليوم ـ لحل (مشكلة البطون) لا تزال مذاهب الكتب والمؤتمرات، ومناهج الذين يحاولون إسعاد الإنسان، بزيادة أو نقص في أعصابه.. ووسط هذا المعترك الصاخب، يرتفع صوت الإسلام ليقول كلمته ـ كما هو شأنه ودأبه في جميع المعارك ـ وليعلن رأيه وقراره لحل هذه المشكلة.
فإما رأيه، هو يرى أنَّ نعم الحياة، مهما توفرت وتزايدت، لا تقدر على إشباع جشع إنسان واحد، ما دام الإنسان خلق مجبولاً بالجشع، فإن جاع يطلب الرغيف، وإنْ ملك الرغيف ينازع الآدام، وإن ظفر بهما يحاول تلوين مائدته، ولو توفرت له مائدة ملونة يحرص على ادخار ما يزيد على حاجته وأولاده وأحفاده، وإنْ حصل كل ذلك، يروم تسلق المناصب الرفيعة، ولو أتيحت له، يرمي إلى سل العروش وانتزاع التيجان، وإنْ نالها، حن إلى جمع السلطات كلها في قبضته، ولو أعطاه الله أزمة الدنيا، واسنده على عرش سليمان، أراد العروج إلى السماوات واستعمار النجوم، وإن تمكن منها، حنت به أنفة فرعون، فقال: أنا ربكم الأعلى، ورمى الله ـ في زعمه ـ بسهم نمرود، وبغى التوسع إلى حيث يرفض الحدود والوقوف.
وإذا كان الإنسان نهماً توسعياً، لا يرضى بالحدود، فمن غير المجدي معالجة (مشكلة بطنه) بتوفير النعم عليه، أو إتاحة الفرصة له، حتى يمتص الدماء ويكرع الدموع، لأنّه كالمصاب بمرض (الاستسقاء) لا يزداد على شرب الماء إلاّ عطشاً، وإنما النافع له، تعقيم مادة الجشع في قرارته، حتى لا ينبض في نفسه حنين إلى ما في أيدي النّاس، بل يصبح خاضعاً للشعور بالمساواة، التي تجعله كبقية الأفراد، عليهم أنْ يتعاونوا في توزيع الفرص عليهم، لينال كل نصيباً متقارباً من نصيب شريكه في الحياة.
وأما قراره، فهو قرر فريضة (الصوم) ليشعر الجميع، بنوع حكيم متزن من (المساواة)، التي تشجب غريزة (الاستئثار)، دون أن تشل المواهب المتفوقة، عن التفاعل والإنتاج.
فـ (الصوم) فقر إجباري، تفرضه الشريعة الإسلامية، ليتساوى الجميع في بواطنهم ـ سواء من يملك الملايين ومن لا يملك شيئاً ـ كما يتساوى الجميع في صفوف الصلاة، وموقف الحج، ليشعر أصحاب الأموال والأنساب والمناصب، بأنَّ النّاس ـ جميعاً ـ متساوون في اعتباراهم، كما أنّهم متساوون في أجسامهم، فجسم الملك ليس أضخم من جسم الجندي، ولا يأكل أكثر مما يأكل الحارس، ولا يتصرف بجسمه في الملابس والمساكن، أكثر مما يتصرف فيه فراشه، وربما كان الأمر بالعكس، وأما الأموال والأنساب والمناصب فإنّها أمور خارجة عن واقع الأفراد، وتمايز الأفراد بالأمور الخارجة عن واقعهم، تمايز غير واقعي، وإنّما التمايز الواقعي بين الأفراد، إنّما يكون بالأفكار والأعمال فحسب. وحتى ذلك التمايز، يكون معنوياً وأخروياً، لا يسمح بتطاول أحد على أحد بسببه، ولا بتغيير موقفه أمام الله أو النظام أو المجتمع.
فها هم الأغنياء والكبراء، وأولئك هم الفقراء والضعفاء، يجوعون ـ جميعاً ـ في وقت واحد، ويشبعون، جميعاً ـ في وقت واحد، ويجمعهم شعورٌ واحد، وحسٌ مشترك وطبيعة سارية فيتعبدون بأمر عام من الله، فالله تعالى فوق الجميع، والجميع متساوون أمامه، وهذه الأموال المتراكمة المبعثرة، لا يتمتع بها أحد، حتى ولو نفثة في (سيجارة) إلاّ بأذن الله، لأنّ المال لله، يصرفه كيف يشاء، والجميع عباده.
وهكذا الصوم يدع الفقير يشعر بشعور الغني، والغني يحسُّ بإحساس الفقير، فيتعاطفان، ويتراحمان، على صعيد المساواة، لا على حساب السيد والمسود، والمعطي والسائل.
فـ (الصوم) فريضة إسلامية، ومن طبيعة الإسلام أنْ يخلع طابعه العام على جميع فرائضه وشعاراته، فهو يطبعها بالمساواة.
و (الصلاة) رأس العبادات وعمود الدين، تفرض على الجميع مع انطلاقة (التكبير) من المآذن والمدافع، فيقف الجميع في وقت واحد، في صفوف متساوية منسقة، متجهين إلى نقطة واحدة ـ وهي الكعبة ـ.
و (الضرائب) الإسلامية ـ المتماثلة في الخمس، والزكاة، والجزية والخراج، والمقاسمة ـ تجبي من الجميع، بنسبة محدودة، عند توفر شرائطها، وتوزع على الجميع بنسبة محدودة، عند توفر شرائطها.
و (الحج) واجب عام يشمل كل من استطاع إليه سبيلاً، ويؤديه الجميع، في زيٍّ موحد، ويقفون في مواقف معينة، ويمارسون طقوس خاصة، ويهتفون بنداءات محدودة.
و (الجهاد) واجب عام يشمل كل من يطيق حمل السلاح ـ عند توفر شروطه ـ ولا يستثنى منه إلاّ فاقدوا الشروط.
و (الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) واجبان عامان، يشملان كل من يشاهد معروفاً متروكاً، أو منكر معمولاً، ويقدر على الأمر بالأول والنهي عن الثاني ـ مع توفر شروطهما ـ من غير فرق بين الشخصيات بالمسؤولة، وغير المسؤولة، ولا بين رجال الدين وغيرهم.
و (التولي) ـ لأولياء الله، و (التبري) ـ من أعداء الله ـ واجبان عامان، يشملان كافة المسلمين، بلا تمييز أو تفريق، بين أعظم الأفراد وأصغر الأفراد.
و (الصوم) هكذا، فهو يساوي بين الطبقات المتمايزة، على صعيد الجوع والعطش، فيعرف الغني ألم الفقير، ويعرف الفقير مساواته للغني.
وكذلك، يطبق الإسلام نظام المساواة العملية، واضحة صريحة، معلناً أنّ الحياة الصحيحة ـ على أتمّها ـ إنّما تكون حين يتساوى النّاس في الجوع والشبع، لا حينما يتفاضلون بالأموال.
وهنا ينهض الشاب الطليعي، ليقول إذن، فالإسلام يدعو عن طريق الصوم، إلى المساواة التي ندعو إليها عن طريق الاشتراكية.
غير أنّ الجواب، يأتي عفو القلم وجري الخاطر، فالفرق بين الصوم، الذي فرض لإشعار المساواة، وبين الاشتراكية الجائرة، التي فرضت لهدم الأسس الفطرية للاقتصاد الحر، كالفرق بين الرياضي الذي يحمل الأثقال، ويقوم بأعنف الحركات، وبين السجين الذي يرزخ تحت الأصفاد، والأعمال الشاقة، كلاهما في الظاهر يتحمل الأعباء الثقال، ولكنهما يختلفان في الأسلوب والهدف، أشد الاختلاف.
إنَّ الصوم، يولّد في الأفراد الشعور بالمساواة، حتى يندفعوا إلى تلبية الوازع الداخلي، لرفع مستوى الفقير، كما أنّ التعاليم الصحية، تدفع الأجهزة المعوية، إلى توزيع خلاصات الأغذية على العضلات، بنسبة عادلة، بينما الاشتراكية تقطع هذا بالحديد والنّار، لتوفر على ذاك، كما لو أردنا التسوية بين عضلات إنسان مترهل، فقطعنا اللحوم المنسدلة من البطن والأكفال، لنلصقها بالمناكب والأعضاء.
إنَّ الفارق بين الطريقتين، ظاهرٌ بيّن، وإن كان قد يدقُّ على المتحمسين المندفعين، الذين تعودوا: إلقاء النظرة السطحية على الحقائق، دون أنْ يكلفوا أنفسهم عناء التوغل، لإدراك كنه الأشياء.
الرحمة
ومتى شعر الجميع، بأنَّ هذه الأموال، التي كانوا يحرصون عليها، ويعرفونها مقياس التمايز بين الطبقات، أصبحت لا تغني عنهم شيئاً، فقد تساوي الأغنياء، بأولئك الفقراء، الذين لم يتكاثروا بالمال... تهون الثروات في أنظارهم، فلا يحرص عليها الأغنياء، ولا يحقد على أصحابها الفقراء.
ومن الجانب الآخر، حيث يشعر الأغنياء، بوطأة الجوع تفتت أحشائهم، يتذكرون أولئك الفقراء، الذين هم أبداً بمنزلة الصائمين في الجوع الحرمان، ومن الأمور المثبتة في علم النفس: أنَّ الرحمة لا تنشأ إلاّ من الألم.
وطريقة أيلام الفرد تنحصر في أمرين:
الأول ـ إصابته بالكوارث النكبات.
الثاني ـ فرض الصوم عليه، حتى يمتنع عن الغذاء وشبه الغذاء، مدة، آخرها آخر الطاقة ـ أو أدنى منها ـ والأمر الثاني أقرب إلى تفجير الرحمة في النفس، لأنّه يترك للفرد مجال التأمل والتفكر، بينما الأمر الأول، يذهله ويربكه، ويصادر منه كل إمكان للفكر والاستنتاج.
ومتى تبودلت الرحمة بين الغني والفقير تآلفاً، واطمئن كلٌ منهما إلى صاحبه، فتخبو ثورة الفقير، كما تذوى كبرياء الغني.
فبالصوم يصبح المجتمع ملائكياً، يشعر الأغنياء والفقراء فيه بالمساواة، فلا يثور الفقير على الغني، ولا يستعلي الغني فيه على الفقير، فيكون المجتمع الملتزم بالصوم، معجزة من معجزات الإسلام، التي عجزت عن الإتيان بمثلها قوانين الأرض.
وممّا يجدر ذكره أنَّ فائدة الصوم هذه، ليست مما يخص الأغنياء، الذين لا يدفعون الزكاة، حتى يقال: فلم فرض الصوم، على الذين يؤدون الزكاة؟!. فالنّاس جميعاً ـ يجب أنْ يكونوا رحماء بينهم، فالكل راع، والكل مسؤول عن الرحمة على رعيته، والغني الذي يدفع الزكاة ـ مثل الغني الذي لا يدفع الزكاة ـ يلزم أنْ يكون رحيماً، يشفق على من رأسهم. كما أنَّ الفقير ـ مهما كان مدقعاً ـ فله زوجة وأولاد وأقارب، يتكفل حمايتهم، فيجب عليه: أن يفيض عليهم من عفوه ورحمته، ما يكافئ غلظة العيش وخشونة الحياة.
إذن فالرحمة حاجة الجميع، ولا يستغني عنها أحد، وإنْ كانت في الغني أنفع، فإنّها في الفقر أروع.
الحرية
والصوم، ينشر في المجتمع روح الحرية ـ كما يجب أنْ نفهم الحرية ـ لأنَّ (الحرية) هي: (التخلص من أنواع الأسر، الذي يجعل الإنسان أخيذاً، لسلطة عليه إرادتها، ويدين لها بالطاعة) وهي كلمة، تقابل كلمة (العبودية).
وبتعبير آخر، إنَّ (الحرية) تعني: (استقلال تفكير الفرد، في أنْ يفعل ما يشاء) وإذا كانت هنالك سلطات تحاول فرض توجيهها على فرد، فتلك هي (العبودية) سواءٌ أكانت تلك السلطات، خارجة عن كيان الفرد، أو داخلة في كيانه، فالخضوع لله (عبودية)، والرضوخ للعقل عبودية، والخنوع أمام السلطان الجائر عبودية، والاستسلام للنفس عبودية. ولكن هل تكون جميع هذه الأنواع من العبودية مكروهة، أو تكون كافة هذه العبوديات مستحبة، كلا، إنّ الرضوخ للعقل وإن كانت عبودية إلاّ أنّها عبودية محمودة، والاستسلام للنفس عبودية مذمومة، إذن، فذات العبودية، ليست حسنة ولا سيئة وإنما هي حقيقة مجردة من الصفات، ولا تتصف بالحسن والقبح إلاّ إذا طرأت عليها ألوان خارجية.
فالعبودية لله محبوبة، لأنّها عبودية واقعة، لا يستطيع أيُّ مخلوق فكاكاً منها ((وَللهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً)) ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)) ((وَيُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ))، ولأنّها عبودية تنفع ولا تضر، والعبودية للعقل كتلك، محبوبة، لأنّها ترشد إلى الخير، ولا تضل في الشرور، وأما العبودية للسلطان الجائر، فإنّها عبودية مبغوضة، لأنّها ليست واقعة، ولأنّها تضر ولا تنفع، والعبودية للنفس كتلك، مبغوضة، لأنّها تضل في الشرور، ولا ترشد إلى الخير.
ومنن الحقائق: إنّ الإنسان أبداً يكون خاضعاً لاثنتين من هذه العبوديات الأربع، ولا يستطيع التحرر من اثنين منها إلاّ ليرضخ لأخريين، فأما يكون الإنسان خاضعاً لله والعقل، وأما أن يستعبده السلطان الجائر والنفس، ولا يمكن أنْ يتحرر من عبودية السلطان الجائر والنفس، إلاّ إذا رضي بعبودية الله والعقل.
ولا ريب: إنَّ عبودية الله والعقل، خير من عبودية السلطان الجائر والنفس، بل العبودية الأولى، شرفٌ لا يدانيه شرف، وفوق النبوّة والرسالة، كما نقرأ في الصلاة: (أشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله) ولولا أنَّ العبودية لله أشرف من رسالة السماء، لما قدّمت عليها، بينما تكون العبودية للسلطان الجائر والنفس، جريمة لا تدانيها جريمة، حتى جعلها الله أول جريمة يحاسب عليها الإنسان قبل الموت، كما في قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها)).
وإذا كان الإنسان مخيّراً بين أن يختار أي نوع من هذه العبوديات الأربع، فالذي يرضى بعبودية الله والعقل، يكون حراً بأكمل معاني الحرية وأنبلها، فيما يكون الذين يجدون حريتهم في مخالفة الله والعقل، قوماً مستعبدين، قد استبعدهم سلطان جائر بأفكار مزيفة، أو استبعدتهم شهواتهم، فانجرفوا في تيارها المسعور. وهم حينما يعيبون على المؤمنين عبوديتهم لله والعقل، يعبدون أتفه ما في الحياة من أفكار وغايات، وها هي صورتهم تظهر في القرآن ـ بكل وضوح ـ: (أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ؟) فمن يتمرد على عبودية الله تعالى، يكون قد استسلم ـ سلفاً ـ لعبودية الهوى: وما أجمل قول (ابن خضرويه): (في الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية).
وتقتصر الحرية ـ في مفهوم كثير من النّاس ـ على أحد معنيين: ـ
الأول: أنْ يكون الفرد، عبداً مملوكاً لفرد آخر.
والثاني: أنْ يتمتع الفرد، بالحقوق الإنسانية العامّة ـ التي وردت في (الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان) غب الثورة الفرنسية ـ التي أهمها حق الحياة وحق الملك، وحتى المأوى، وحق الوطن... وتتلخص، في: أن لا يكون الفرد، تحت سلطان حاكم مستبد، أو عدو مستمر.
وهذان المعنيان لمفهوم الحرية، وانْ كانا صحيحين، إلاّ أنّهما ليسا كل ما في كلمة (الحرية) من محتوى، إذ تسبقها حرية أخرى ـ قد تكون هي الحرية الحقة، التي تنطلق منها بقية معاني الحرية ـ وهي حرية الفرد من شهوات النفس، لأنّ الفرد، لا يباشر عملاً إيجابياً أو سلبياً، إلاّ تلبية للوازع الداخلي، فإذا سيطرت عليه شهواته، عاش أسيراً يخضع لنفوذها، ويمتثل أمرها، فكيف يستطيع مثله ـ وقد صرعته نفسه التي بين جنبيه ـ أنْ يتغلب على حاكم مستبد، أو عدوٍ مستعمر؟
وهذا المعنى للحرية، هي التي جرت في منطق امرأة عمران، إذ حكى عنها القرآن: ((إِذْ قالَتِ امْرَأةُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)). فما قصدت تحرره من عبودية الإنسان لأخيه الإنسان، وإنّما قصدت تحرره من عبودية شهوة النفس، حتى يستطيع الخلوص لعبادة الله.
فهؤلاء الذي يجرون وراء الملذات، عبيد لما وقعوا في أسره، من مال ومتاع، كما في بعض القول المأثور: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة) وكما قال بعض الأحاديث المأثورة أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما انتصر في عزوة، قال لأصحابه: ((... لقد فرغنا من الجهاد الأصغر، فعليكم بالجهاد الأكبر). فقالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ (فقال (صلى الله عليه وآله وسلم)): (جهاد النفس).
وفي صوم سموٌ، لا يدركه إلاّ من مارس الصوم، فها أنت ـ في شهر الصيام ـ تماماً كعهدك بأي يوم من أيام السنة، تجد حولك الطعام والشراب والنكاح ـ في كل لحظة ـ وتستطيع أن تمد يدك لتنال ما تشتهي، وقد تكون طبيعة بلدك وعملك، بحيث تضحي شبقاًً جائعاً ظامئاً، وربما تكون جرعة ماء، كافية لبل ريقك، ولكنك تربأ بنفسك عن الإسفاف إليها، وتسمو على جميع ما في الدنيا ما تشتهيه نفسك، وبإلحاح، إنّك تربي نفسك على التسامي والتعالي، لتكون كبير النفس حقاً، حتى تستطيع أنْ تعتمد على نفسك، لممارسة مهامّ الأمور، إنّك تنمي في نفسك الثقة بالله والثقة بنفسك، لتخرج إلى المعارك المصيرية، سواءٌ أكنت فرداً، أم حفّت بك الألوف؟... فمن يستطيع قهر نفسه، يستطيع قهر كل ما يتعرضه من صعاب، فإذا طلب الحرية العامّة، وحميَ وطيس معركتها مع متحكم ظالم، أو مستعمر غاشم، لم تتعلق نفسه بعرض من الدنيا، بل آثر الموت في سبيل الحق، والحياة الحرة في حماية السلاح على العيش الناعم في ظل الطغيان.
وعلى هذا المعنى تربى الرعيل الأول من أمّة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهوت على أقدامه الرؤوس والتيجان، ورفرفت راية القرآن على ثلاثة أرباع المعمورة.
وهنالك سؤال يفرض نفسه على البحث، وهو:
(إذا كان الصوم لمجرد الارتفاع بالنفس عن (عبادة الطعام) فقد تبزغ في المجتمعات، النفوس الكبيرة السامية، التي لا تعرف للطعام وزناً، ولا تعتبر الإمساك عنه إلى أمد قريب، من الامتحانات العسيرة الشاقة، كالأخيار في كل جيل أو على رأسهم المعصومون (عليهم السلام) فيجب أنْ تخصص فريضة الصوم بغيرهم، لأنهم بلغوا ما يحاوله الصوم).
الجواب من الوجهين:
أولاً: إنّ رسالة الصوم، لا تختصر في مجرد الارتفاع بالنفس عن (عبادة الطعام) حتى يستغني عنه كل من لا يأبه بالطعام وعلى رأسهم المعصومون (عليهم السلام) وإنّما تكون للصوم فوائد كثيرة متنوعة. منها الاجتماعية، ومنها النفسية، ومنها الصحية، وقد تتوفر هذه الفوائد ـ بأجمعها ـ في بعض الأفراد، وقد لا يتوفر إلاّ بعضها في البعض الآخر، فلا بد من ممارسة الصوم على الجميع، ليكمل كلٌ نواقصه من تلك الفوائد. والمعصومون (عليهم السلام)، وإنْ استغنوا عن فوائده الاجتماعية والنفسية، لأنّهم قد بلغوا فوق ما يحاوله الصوم، إلاّ أنَّ من المحتمل، احتياجهم إلى فوائد الصحية، وإنَّ الله تعالى: كان أعلم منا بحاجاتهم ونواقصهم، يوم أمرهم بالصوم.
ثانياً: وحتى لو فرضنا اختصار فوائد الصوم، في الارتفاع بالنفس البشرية عن (عبادة الطعام) ووجد في المجتمعات، الأخيار الذين يستهينون بالطعام، فإن هذه الصفة السامية ـ شأنها شأن بقية الصفات ـ تحتاج إلى التغذية والتشجيع، حتى تبقى وتتركز، وإنْ تركت وأهملت، تضعف وتتوتر، فالأخيار يستهينون بالطعام وكل ما في الدنيا من نعم، ولا بد أن يؤكدوا ـ في أنفسهم ـ هذه الصفة باستمرار، ليزدادوا سمواً وارتفاعاً، كالبطل، الذي يرفع بيديه (500) كيلو غرام من الحديد، فإنّه إذا استطاع أن يرفع هذه الكمية الكبيرة من الحديد، لا يكشف عن استغنائه، عن الدؤوب في ممارسة الحركات الرياضية اليومية، التي يؤديها مع عدة أرطال من الحديد، لأنّه قد أحرز البطولة بواسطة الرياضة اليومية الخفيفة، وسوف يفقد بطولته إنْ ترك رياضته اليومية.
ثالثاً: وإذا استغنى الأخيار، وعلى رأسهم المعصومون (عليهم السلام)، عن فوائد الصوم برمتها، فإنّ الصوم ذاته عبادة تقرب إلى الله تعالى، والمعصومون (عليهم السلام) مهما بلغوا، لا يستغنون عن العبادات، التي تقربهم إلى الله زلفى.
الضمار
والصوم ـ بطبيعته ـ رياضة عنيفة في ذاته، ورياضة عنيفة في حدوده التي ترفض التلاعب ولو بمقدار لحظة واحدة، وهو رياضة للنفس، بما يكبح من جماحها، ورياضة للبدن، بما يحمله من تجربة قاسية.
وهو تعبئة إعدادية عامّة، وتأهب القادرين على خوض معترك الحياة، لاقتحامه، كلما دقت الأجراس.
فالخيل، تضمر قبل السباق، والجند، يدرب قبل المعركة، وكل صاحب مهنة أو وظيفة، يجرب قبل أنْ يعهد إليه بمسؤوليته، ولكن ليس هنالك إعداد عام لحمل أعباء الحياة، سوى الصوم، فهو الضمار العام للحياة.
والصوم ـ شهراً في العام ـ بالنسبة إلى الروح، كالرياضة السنوية، بالنسبة للجسم.
فقانون الصحة الجسمية، يحتم على كل عامل يريد حفظ صحته: أن يضمر نفسه شهراً كاملاً في السنة، فيقلل في من غذاء النفس ـ أي الأشغال العقلية ـ وكذلك قانون الصحة الروحية، يحتم على كل إنسان أنْ يقلل من غذاء الجسم، شهراً كاملاً في السنة. ولما كانت حجة أطباء الأجسام، في ضرورة الإقلال من تغذية النفس، شهراً كل عام، هو لزوم تعويض ما فقده الجسم من القوة، مدى الأحد عشر شهراً، باستهلاك الاشتغالات العقلية، كذلك يحتج أطباء الروح، بأنّ القصد من إقلال تغذية الجسم شهراً كل عام، وهو تعويض ما فقده الروح من القوة، باستهلاك الاشتغالات المادية.
ولا يهدف الإسلام من هذا التنظيم الحكيم، سوى حصول التوازن، بين حقوق الروح وحقوق الجسم، ليصبح الفرد المسلم، إنساناً كاملاً معتدل المزاج، متوسط المطاليب الطبيعية، حتى يسهل له نيل السعادة التي مات الفلاسفة دون الوصول إليها، وحتى يتقمص الوجود (روحانية) قبلت شكل العالم وأكسبت تلك الحفنة المتواضعة من الحطام البشري ـ في الجزيرة العربية المهملة ـ خلافة الله في الأرض، أنجبت منها قادة الملوك، وإخوان الملائكة.
وليس الصوم، من نوع الرياضات الهندوكية، التي يمارسها المرتاضون الهندوس، لسحق النفس، وإهمالها نهائياً، وإنما هو من نوع الرياضات الخفيفة، التي يوصي الطب جميع النّاس، بممارستها لتنشيط عضلاتهم، لا لسحقها وإنكارها، ولعلّ القرآن الكريم حاول التعبير عن هذه الحقيقة، عندما اختتم بيان الصوم بقوله: ((يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) أو لم يقل الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم): (الصوم نصف الصبر، والصبر ثوابه الجنّة)،. ولو كان الصوم يعادل طاقة الإنسان، يقضي على كيان النفس، لكان كل الصبر، ولم يكن نصف الصبر، لكنه ترويض لا تحطيم.
الأيمان
(الإيمان) عادة، أكثر مما هو فكرة، فالصدوق يسهل له الصدق، وبينما يثقل عليه الكذب، عندما الكذوب يهون عليه الكذب، ويصعب عليه الصدق، والصلاة كبيرة إلاّ على الخاشعين.
وهكذا ينطبع الإنسان بكل ما تعوده من حسن وقبيح، حتى المفكرون، فإنّهم يتأثرون في تفكيرهم بالتقليد والعادة، ولهذا الواقع، نجد المفكرين، يرزحون تحت عقائد وتقاليد مجتمعهم وأرضهم، ولا يتحررون منها، بل يرهقون أنفسهم، في محاولة تصويب تراثهم، وتبرير أخطائهم الموروثة، نعم ربما تكون التقاليد سخيفة إلى ما لا يمكن تأييدها بأي منطق، فيثور. عليها المفكرون، أو تقهرهم الجواذب الخارجية، لمكافحة عقائدهم البالية، فيفكرون في إلغائها، غير أنَّ هذه الحالات قليلة لا تغير الاتجاه البشري العام، الذي يدعو إلى التحمس للتراث القومي، بقطع النظر عن كونه حقاً أو باطلاً، إلاّ الأنبياء والأئمة المعصومون (عليهم السلام)، فإنّ البيئات لا تنال منهم، ولا تفرض آرائها عليهم، لأنّهم لا ينطقون عن هوى، ولا ينحرفون عن إرادة الله قيد شعرة.
وانطلاقاً مع هذه الحقيقة، يفرغ الإسلام طاقته، لجعل الأيمان عادة ـ ولكنها عادة علمية حكيمة ـ ولا يقتنع لتركيز الأيمان في العقول، بالحجج والبراهين فحسب. فالأيمان ليس فكرة علمية تنعزل في الخيال، دون أنْ تغادر مقرها إلى يوم النشور، إلاّ لتتسرب من خيال أستاذ إلى خيال تلميذ، وإنّما الأيمان ـ أو الدين لو شئنا التعبير في إطار أوسع ـ عقديةً، وعملاً، وحياةً، وهي تأبى أنْ تخضع للبرهان، فمتى استطاعت البراهين أنْ توجه الأعمال أو تنظم الحياةَ؟ بل لا بد في ذلك من القوة، أما القوة المادية ـ وهي لا تتماسك إلاّ لتتلاشى، ولا تزحف، إلاّ لتعصف بها الانتفاضات، فتكسحها من الطريق ـ وأما القوة المعنوية الكامنة في النفوس، وهي تحكم ولا تزول، وتصلح للبقاء والخلود.
والإيمان ـ بذاته ـ قوة معبئة في النفوس، وجاهزة للتفجير، وإلقاء الضوء أمام الإنسان، في كل خطوة ونبضة وكلمة، غير أنَّ الأيمان الذي يُتلّقى من الأدلة والمناقضات فقط، لا تعدو أنْ تكون فكرة، لها مكانتها في الخيال والكتب إلى الميدان، وتحاكم النّاس، وتحاسب المترفين، وتأخذ وتعطي، فذلك ما لا يؤديه الأيمان الفكري، وإنّما يكون ذلك من صلاحيات الأيمان الواقعي، الذي أصبح فكرة وعادة، ثم الفكرة تولد العقيدة، والعادة توجه المجتمع. وبهذه ـ جميعاً ـ تكمل العناصر اللازمة للدين.
والإسلام لهضمه هذه الحقائق، يكدّس بين أيدي النّاس، ملايين الأدلة العلمية والكونية على الدين، لإنتاج الفكرة التي تنتهي بالعقيدة، وبهذا يكمل الدين الفكري، الذي هو شطر من الدين، وحيث يبقى الشطر الآخر شاغراً، لا تفهمه الحجج والبينات، يأمر الإسلام بالعبادات، لتكوين الدين العملي، وأحفل مظاهر العبادات، والصلاة، ثم الصوم، ثم الحج، ومتى احتلت العبادات مركزها الحيوية، تبعتها الاجتماعيات: (المعاملات ـ في عرف الفقهاء ـ) بالتبع، ومتى كررها الإنسان أصبح عادة، يألفها ويأنس بها ولم يجد في مزاولتها تعباً ولا نصباً، بل كثيراً ما يهرب من المتاعب إليها. لأنّه يجد فيها راحة ضميره، واطمئنان قلقه، والقرب إلى الله تعالى. وهكذا العادة توجه المجتمع.
وأمّا كيف تفتح العبادات مجالها إلى التطبيق، بعد ما ظهر أنَّ الفكرة لا تنطبق إلاّ بالعادة، وكيف الفكرة تولد العادة؟؟. فجوابه إنَّ الفكرة ـ في المستويات العادية ـ لا تقدر على فرض نفسها، ولكنَّ الفكرة ـ في المستويات القيادية ـ تكون قوية نابضة، إلى حيث تشق طريقها في الحياة بنفسها. فمثلاً النبي ووصيه ـ في كل دور ـ يأتيان بالعبادات التي بشرا بها، لقوة إيمانهما، ثم ـ بطبيعة الدعوة ـ يتبعهما إخوانهما وأزواجهما، وأولادهما وسائر أفراد أسرتهما، فيكوّن مجموعهم عرفاً خاصاً، وكل من يدخل معهم في الأيمان الفكري، يشعر بأنّه يخرج من مجتمع ويدخل في مجتمع آخر، فينصهر في المجتمع الجديد، ويأخذ بعاداته تلبية لإرادة الجو الاجتماعي، ثم يتضاءل المجتمع القديم، بقدر ما يتوسع المجتمع الجديد، ثم يتوسع نطاقه ويتوسع، حتى يحتوي على أُمّة كبيرة، لها عادات موروثة، ومتأصلة في حياتها.
والصوم، يمتاز ـ ما بين العبادات ـ بأثره الفعّال، في جعل الأيمان عادة، لأنَّ الصوم ـ أبداً ـ يكون قربة إلى الله، ولا يتسلل إليه الرياء، ولا السمعة، ففي وسع أي فرد أنْ يفطر متى شاء ودون أنْ يعلم به أحدٌ من النّاس، فإنْ لم يفطر الفرد، واستمر في الصيام طول النهار، يدل على أنّه كان متذكراً الله ـ ولو بالارتكاز ـ وإلاّ فمن غير الممكن أنْ يرى الماء وهو عطشان، فلا يشربه، ويجد الطعام وهو جوعان، وثم لا يطعمه، إلاّ لوازع باطني، يهوّن عليه تحمّل العطش والجوع، في سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
فمن قاوم غرائزه، وكافح رغباته كلها، طول النّهار، طوال شهر كامل، راضت نفسه على الانقياد لله، ورضخت لاتباع أوامره وزواجره حرفياً، سواءٌ أعرف فلسفتها أم لم يعرفها؟.. فلا تكاد تمضي عليه شهور من رمضان، إلاّ وتتركز أعماله وأقواله، على (مراقبة الله) حتى تصبح (ملكة) مطبوعة راسخة، في أعمق أعماق وجدانه، بحيث تقوى على التحكم في حياته، وتنمو وتتوسع على ممر الأيام، ولا تتهافت ولا تبور.
فبالصوم يتمكن الأيمان من نفس الفرد، ويملأ كيانه، ويتأصل في عواطفه وأفكاره.
اختبار سنوي
وبعدما يحاول الصوم، تأصيل القيم الاجتماعية السابقة، لا يتركها تحت رحمة الحوادث، التي تسفى كلما تأتي عليه، وإنّما يغذيها ويرعاها ـ ما دامت الحياة ـ باختبار سنوي دقيق. حتى يكملها إنْ نقصت، وينميها إنْ لم ينقص منها شيء.
فلصوم اختبار للمنتمين إلى الدين الإسلامي، وامتحان لضمائرهم وأعصابهم وإيمانهم، إنه عملية تفتيش.
تفتيش ديني.
وتفتيش صحي.
وتفتيش إرادي.
وتفتيش ثقافي.
وتفتيش اجتماعي.
وتفتيش خلقي.
أما إنّه تفتيش ديني، فإنّ شهر الصيام، يعتبر محطة في طريق الزمن، أو في طريق العمر، يقف فيها المسلم، بعد أحدَ عشرَ شهراً ـ ليسائل نفسه: أين أنت من دينك؟ وهل انصرمت هذه الشهور من عمرك على نحو مرض لضميرك الديني، أو أنّ هناك نواقص ـ فيك ـ تحتاج إلى الرتق والترميم؟؟.
فواجب المسلم، أنْ يحاسب نفسه مساء كل يوم، ليتأكد أين هو من علاقته بربه، وعلاقته مع النّاس؟؟. استجابة للحديث الشريف: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا). ولكن إذا لم تتسير هذه (الوقفة اليومية) فلا أقل من أنْ تكون (وقفة سنوية) في أفضل الشهور، وهو شهر رمضان، الذي يساعد جوه الروحي، وذكرياته الدينية، على هذه (الوقفة).
ولا بد أنْ يكون هذا التفتيش شاملاً، للظاهر والباطن، حتى يتأكد المسلم من عقيدته القلبية، وضميره الديني، ويعرف هل أنَّ علاقته بالله موطدة، أم اعتورها الخلل والفتور؟ وإذا كانت تشكو الضعف والعلل، فعليه أنْ يُسارع إلى إنقاذها بمدد روحي، يعيد إليها التوفر والنّشاط.
وإمّا إنّه تفتيش صحي، فإنّ الصوم يوفر على الأجهزة الباطنية، فترة راحة، لهضم الرواسب، التي تطفلت عليها بالجشع وتلون الأطعمة. ولكنْ لا يستفيد من هذه الناحية، سوى الصائم الذي عرف أنَّ الصوم هو الذي يكون له جوع وعطش يذكرانه بجوع وعطش يوم القيامة، وأما الصائم الذي يشحن بطنه من أول الليل إلى آخره بألوان الطعام، حتى يلهث من أول النهار إلى آخره، ويتجشأ على مائدة الفطور، فإنّ الصوم لا يزيده إلاّ تخمة وثقلاً.
وأما إنّه تفتيش إرادي، فإنَّ الصوم يعين على قوة الإرادة.
أولاً: لأنّه يقسر الإنسان على الإضراب عن شهوات الجسد، التي تحرم في أوقات الصوم، في مدد متقاربة رتيبة.
ثانياً: لأنّه ينسق وجبات الطعام، في الفطور أول المغرب، والسحور قبيل الفجر، فيتحقق له تدريب إرادته على العزم، ومرانها على الالتزام بالرأي الأسدّ.
وأما إنّه تفتيش ثقافي، فمرجعه إلى ما هو مستحب في شهر رمضان، من تلاوة القرآن، ودراسة معانيه، ومذاكرة الأحكام، والتطلع إلى السيرة الكريمة، ومن الطبيعي أنْ تستطرد هذه العلوم، إلى التاريخ واللغة والبلاغة، وبقية الثقافات الروحية والعربية.
وأما إنَّه تفتيش اجتماعي وخلقي ـ وهما متلازمان، فمتى صلح الخلق صلح المجتمع، ومتى فسد الخلق فسد المجتمع ـ فإنّ الصوم حيث يهدأ الأعصاب، ويخفّف سرعة الدم، يساعد على خفض الجناح، والجنوح إلى الخير والمعروف، بالإضافة إلى أنّ التعاليم الواردة في أدب الصائم وكون الشياطين مغلولة في شهر رمضان، والتحذيرات العنيفة المأثورة، عن ارتكاب المنكر في حالة الصيام، تطيب النفوس، وتنعش القلوب، فتنشر روح التسامح والوئام بين أفراد المجتمع.